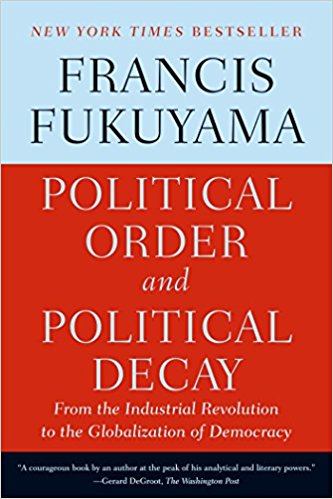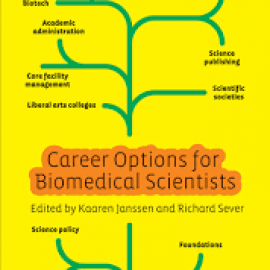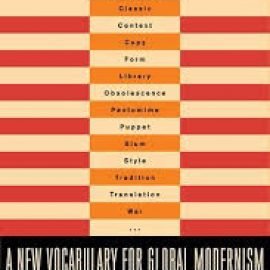الوصف
This post is also available in:
 English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
فرانسيس فوكوياما: النظام السياسي والسقوط السياسي
كيف قامت الدول في مختلف بقاع العالم؟ كيف تطورت المؤسسات السياسية عبر قرنين من الزمان في ظل ظروف تنموية شديدة التباين والاختلاف؟ كيف انتهي الأمر بعجز الدول وسقوط المؤسسات الديمقراطية الحديثة مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين؟ كيف حدث العجز والسقوط السياسي في أقوى وأعتى القلاع الديمقراطية والليبرالية الحديثة؟
تساؤلات عديدة وشائكة تم مناقشتها وبحثها باستفاضة من قِبَل المُنظر والباحث السياسي “فرانسيس فوكوياما Francis Fukuyama” في كتابه الأخير المُسمى بـ “النظام السياسي والسقوط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية”، أو Political Order And Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy
الكتاب – الصادر في لندن عام 2014 عن دار نشر “بروفايل بوكس ليميتيد Profile Books LTD” – سبقته كتب عدة للمؤلف الذي يعتبر من أهم رواد التنظير السياسي في القرن الواحد والعشرين، والذي تُعتبر كتاباته من أوسع الأدبيات انتشاراً وتأثيراً حول العالم. فمن كتاب”نهاية التاريخ The End of History” إلى كتاب “الرجل الأخير The Last Man” إلى كتاب “مستقبلنا ما بعد الإنساني Our Posthuman Future” إلى كتاب “أصول النظام السياسي The Origins of Political Order”، وأخيراً إلى الكتاب المعني في هذا المقام، سجل المؤلف بتلك الكتب أفضل الكتب مبيعاً في العالم؛ حيث تم ترجمتها ونشرها بلغاتٍ شتى في أنحاء المعمورة.
“فوكوياما” – الباحث والحاصل على زمالة أولى لـ”أوليفييه نوميللينيOlivier Nomellinie” بمؤسسة “فريمان سبوجلي للدراسات الدولية، ستانفورد Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford” – قام بتأليف كتابه الأخير في 658 صفحة؛ مُدرجاً المراجع والملاحظات والإهداءات والفهرس في حوالي 100 صفحة. والمؤلف – الذي تعتبر كتبه الأكثر مبيعاً عالمياً، ومحاضراته الأكثر طلباً دولياً، وظهوره الإعلامي الأوسع انتشاراً – قسم الكتاب المعني إلى أربعة فصول رئيسية، أعطاها العناوين التالية: الدولة؛ المؤسسات الخارجية؛ الديمقراطية؛ السقوط السياسي.
فبعد مقدمةٍ أفرد لها حوالي عشرين صفحة، بدأ “فوكوياما” بالفصل الأول “الدولة” الذي أدرج تحته العناوين الفرعية الآتية: ما هي التنمية السياسية؟؛ أبعاد التنمية؛ البيروقراطية؛ بروسيا تقيم دولة؛ الفساد؛ مكان ميلاد الديمقراطية؛ إيطاليا ومعادلة الثقة المتدنية؛ المحسوبية والإصلاح؛ الولايات المتحدة تخترع الزبائنية؛ نهاية أنظمة المحسوبية والغنائم؛ الطرق السريعة والغابات وبناء الدولة الأمريكية؛ بناء الأمم؛ حكومة رشيدة وحكومة غير رشيدة.
ينتقل بعدها “فوكوياما” إلى الفصل الثاني المُسمى بـ”المؤسسات الخارجية”، مُدرجاً تحته العناوين الفرعية الآتية: نيجيريا؛ جغرافيا؛ فضة ذهب سكر؛ كلاب لم تنبح؛ الدولة النظيفة؛ أعاصير في إفريقيا؛ حكم غير مباشر؛ مؤسسات..محلية أم مستوردة؛ لغة فرانكا؛ الدولة الآسيوية القوية؛ الصراع من أجل القانون في الصين؛ إعادة اختراع الدولة الصينية؛ مناطق ثلاثة.
ثم ينتقل المؤلف إلى الفصل قبل الأخير، وهو فصل “الديمقراطية” الذي ناقش فيه الموضوعات التالية: لماذا انتشرت الديمقراطية؟؛ الطريق الطويل نحو الديمقراطية؛ من 1848 إلى الربيع العربي؛ الطبقة الوسطى ومستقبل الديمقراطية. وأخيراً ينهي المؤلف كتابه بالفصل الأخير الذي أعطاه عنوان “السقوط السياسي”، حيث أدرج تحته العناوين الفرعية التالية: سقوط سياسي؛ دولة المحاكم والأحزاب؛ الكونجرس وإعادة موروث السياسة الأمريكية؛ أمريكا والفيتوقراطية؛ الاستقلال والتبعية؛ النظام السياسي والسقوط السياسي.
نظرة ناقدة للكتاب
لا يُنكر ثقل الكتاب من الناحية العلمية. فقد طاف المؤلف بتجارب تنموية عديدة، من الغرب الأوروبي إلى الغرب الأمريكي إلى الغرب اللاتيني إلى الشرق الآسيوي إلى الجنوب الإفريقي، مُستخلصاً العبر والدروس من تلك التجارب والخبرات المختلفة في بناء المؤسسات السياسية، مُبيناً الفوارق الجوهرية بين تلك الخبرات، مُسلطاً الضوء على مدى أهمية وضرورة التنمية السياسية في حياة البشر جميعاً. وفي أثناء “رحلته” التنموية يمكننا ملاحظة أمور عدة:
أولاً: أن هوية المؤلف الغربية، وانتماءه للمنظومة الغربية، لم يمنعاه من نقد تلك المنظومة بصدقٍ ونزاهة، واضعاً إياها في مرمى الهجوم. فحديثه عن التاريخ الأوروبي الدموي لتدشين الدول الحديثة، وفرض الهوية القومية؛ وحديثه المُطول عن انهيار وسقوط الأنظمة الغربية الديمقراطية الليبرالية بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين، وإفراده لذلك فصلاً كاملاً من كتابه….كل ذلك يعكس سعي المؤلف وراء تقديم نقدٍ بناء للمنظومة الليبرالية الغربية، بل وتوقعه أن عالم القرن الواحد والعشرين في انتظار البديل المتمثل في المجتمع العالمي الجديد العابر للقارات والجنسيات والأعراق.
ثانياً: تعظيم المؤلف من دور مؤسسة الدولة، معتبراً أن الولاء للدولة من سمات الحكم الرشيد. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي: هل هو ولاء أم استعباد؟ هل توظيف المواطنين وتعبئتهم – ليصيروا أدوات لبقاء الدولة التي أضحت مرادفاً للنظام السياسي – هل يُعتبر ذلك ولاءً أم استعباداً؟ هل تسخير الشعوب ودفعها دفعاً نحو التضحية من أجل بقاء الدولة أو النظام السياسي – أياً كان هذا النظام – هل يعتبر ذلك التسخير أو تلك السُخرة ولاءً أم استعباداً؟ وهل يكون الولاء الحقيقي للمؤسسة (النظام) أم للقيمة المنزهة عن أي مصلحة؟
ثالثاً: ربط المؤلف عملية بناء الدولة بعملية فرض هوية قومية بالإجبار والعنف والدم. بمعنى آخر، إن عملية بناء الدولة – على حسب قناعة المؤلف – لا تتم إلا بإرغام المواطنين على اعتناق هوية قومية معينة، تجعلهم يقدمون حياتهم رخيصةً فداءً للدولة القومية. وهنا يبرز التساؤل الآتي: كيف كان وضع الدولة الإسلامية؟ هل ارتكزت عند قيامها على فرض هوية قومية أو دينية معينة؟ وهل كان العنف شرطاً لبناء تلك الدولة؟ الشاهد تاريخياً أن الدولة الإسلامية – التي أول من أقامها هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة – لم تكن مرتكزةً على إجبار الناس على اعتناق قومية معينة أو عقيدة معينة؛ وإنما كانت دولةً تضم المسلمين والمسيحيين واليهود سواء، في تجانس وتناغم وتعايش سلمي؛ وفي ظل أول دستور مدني عرفته البشرية؛ ولم يخترق هذا الدستور إلا خيانة اليهود بعد ذلك. ما أريد قوله باختصار، أن الدولة الإسلامية الأولى التي قامت منذ خمسة عشر قرناً – أي قبل نشوء الدولة الأوروبية الحديثة بحوالي إثنى عشر قرناً – قدمت نموذجاً لدولةٍ قامت دون إجبار مواطنيها على اعتناق هويةٍ معينة أو دينٍ معين. وذلك انطلاقاً من قيم إسلامية واضحة تمنع الإكراه على الدين وترفض العنصرية أو التحيز لأي جنس أو عرق أو لون.
رابعاً: تجاهل المؤلف للتجربة الحضارية والتنموية التي قدمها العالم الإسلامي على مدى خمسة عشر قرناً؛ حيث سرد المؤلف تجارب من الغرب والشرق والجنوب، مُسقطاً التجربة الإسلامية من الحُسبان…اللهم إلا تطرقه لثورات الربيع العربي المندلعة في القرن الواحد والعشرين. حتى عند تناوله لتلك الثورات، أظهر المؤلف نظرةً دونيةً تجاه تلك المنطقة، مفترضاً أنها لم تشهد طوال تاريخها أي تنمية سياسية قط، معتبراً أن ثورات الربيع العربي الأخيرة بمثابة الانطلاقة الأولى للتنمية السياسية العربية والإسلامية، مُشبهاً تلك الانطلاقة بانطلاقة أوروبا نحو الديمقراطية في عام 1848. وهو تشبيه لا نستطيع وصفه إلا بالإجحاف والغبن تجاه العالم الإسلامي الذي قدم الكثير – حضارياً وعلمياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً – للعالمين، طيلة قرونٍ طويلة، دون تحيز لدينٍ أو عرق أو جنس. إن تجاهل وإغفال “فوكوياما” لتاريخ ذلك العالم – الذي دشن دولته الإسلامية منذ قرابة خمسة عشر قرناً واضعاً بصمته على المعمورة طيلة تلك القرون – وإن اختزال “فوكوياما” لذلك التاريخ الطويل الثري في ثورات الربيع العربي الأخيرة، يعتبر بحق سقطة علمية مُخزية له كباحث أول معروف دولياً. وهو الأمر الذي يجعلني توجيه سؤالين له؛ أولاً: هل يجوز منطقياً وعقلياً عقد أوجه تشابه بين منطقتين مختلفتين اختلافاً جذرياً، حضارياً وقيمياً وبيئياً ومجتمعياً؟ هل من المنطق عقد تشابه بين منطقتين، أحاطتهما ظروف مختلفة، وأزمنة مختلفة، وقيم ومباديء مختلفة؟ ثانياً: هل انتفاء آليات الديمقراطية الغربية المعروفة في العالم الإسلامي معناه انتفاء وجود آليات أخرى – مثل آليات الشورى وأهل الحل والعقد – كانت تقوم بنفس معاني وأهداف الديمقراطية الغربية، ولكن من منطلقات أخرى، وفي ظل أنساق أخرى؟
وتظل دراسة العالم الإسلامي المنطقة التي لا ينصفها الباحثون الغربيون إلا النذر القليل منهم. وتظل الغالبية العظمى من هؤلاء الباحثين ينظرون إلى تلك المنطقة من علٍ؛ فإما يصنفونها ككمٍ مهمل لا يستحق الدراسة – كما حدث في الكتاب المعني – وإما يتطرقون إليها بتحليل متحيز واضح، يتضمنه العديد من الأفكار المُسبقة غير العلمية وغير المنطقية، والتي لا يدعمها أية حقائق أو قرائن علمية مثبتة. فمصطلح “رجل أوروبا المريض” – الذي كُنيت به دولة الخلافة العثمانية – شاهد على ذلك؛ وهو المصطلح الذي أصر الكثير من الباحثين والمؤرخين الغربيين على استخدامه بالرغم من ضعف بل انعدام الحجج الدالة عليه. وما يؤسف عليه حقاً، أن يقوم بعض الباحثين العرب والمسلمين باستخدام نفس المصطلح في بحوثهم، لينقلوه بالحرف دون فهم أو وعي.
ولكن هذا لا ينفي أن العالم الإسلامي قد تأخر كثيراً عما كان عليه في أزهى عصوره. وبغض النظر عن ماهية أسباب هذا التأخر – والتي يطول شرحها – فإنه لا غبار ولا شك من مواجهة عالمنا الإسلامي لأزمةٍ حقيقةٍ متمثلةٍ في غياب عنصر التنمية لديه، سواء سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية أو ثقافية أو نفسية. فالمؤسسات في عالمنا الإسلامي لا يمكن وصفها إلا بالركود والعفن والتصلب والتحجر… مؤسسات آسنة تفتقد إلى الدماء الجديدة التي تُصلح وتُغير وتُطور؛ تلك الدماء الجديدة التي تمنعها أيادي النخب السياسية القديمة العتيقة الرافضة لأي تغيير حقيقي يعود على الشعوب بالنماء الحقيقي ليس النماء الإعلامي المصطنع الُمستورد؛ تلك النخب المتعنتة التي تصر على البقاء حتى ولو كان الثمن هو دفن شعوبها. فهل لتلك الشعوب أن تقوم لتقاوم ثانيةً – في “جولةٍ ربيعيةٍ” أخرى – مطالبةً بحقها في التنمية والإصلاح والعيش بكرامة؟ هل للفاعلين المجتمعيين الجدد أن ينهضوا ثانيةً متعلمين الدرس بل الدروس من ثوراتهم الربيعية الأولى؟؟ هل سيكون القرن الواحد والعشرين هو قرن نهضة العالم الإسلامي من جديد؟
عرض
د. شيرين حامد فهمي
This post is also available in:
 English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
 العربية
العربية