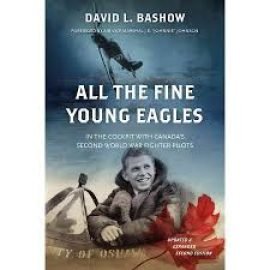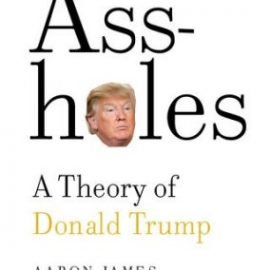الوصف
المنطق والنحو الصوري
يهتم الفيلسوف المغربي د. طه عبد الرحمن اهتماما بالغا باللغة، انطلاقًا من أن طبيعة اللغة الحية، ووظيفتها، تتخطى دور الإيصال والتبليغ، لتصبح جزءا من الفكر البشري للناطقين بها على مستوى المجتمعات البشرية، وأداة لفهم الذات… فاللغة هي أقوى الأدوات التي يستعملها المتكلم لتبليغ مقاصده إلى المُخَاطب، والتأثير فيه.
وللغة العربية، عند عبد الرحمن، إضافة لما سبق، مكانة خاصة بوصفها حاملة للخطاب القيمي الإسلامي.
وهي عنصر مهم في مكونات مشروعه الفكري، الرامي إلى تأسيس فلسفة إسلامية عربية، لذلك أراد الفيلسوف أن تشترك بنية اللغة العربية في بناء مضامين هذه الفلسفة، بالإضافة إلى المضامين الفكرية، والعملية، العامة.. من حيث أنه لا مدلول للبنية اللغوية إلا من حيث إمكاناتها في إغناء المعنى الفلسفي بوجوه خاصة مناسبة لأساليب التعبير في هذه اللغة، ومن حيث إمكاناتها في الإيفاء بغرض التأثير والإقناع، ومن حيث قدرتها على استنهاض الهمم للعمل بما تم الاقتناع به، إذ لا نفوذ في تقديره لأي مضامين فكرية مقطوعة الصلة بهذه البني اللغوية.
وعلى ذلك، انشغل فيلسوفنا بسؤال اللغة والمنطق، وموقع النحو العربي في اللسانيات الحديثة، واستدعى في كتابه الذي نحن بصدده “المنطق والنحو الصوري” النظريات الغربية التي ظهرت في العقود الأخيرة، لاسيما نظرية الفيلسوف الأمريكي “نعوم تشومسكي” التي طرحها في كتابه “البنى النحوية” الصادر في خمسينيات القرن المنصرم، والتي أعقبها جدل فلسفي حول تطبيق الوسائل الصورية، والرياضية، في معالجة الظواهر النحوية. وقد مثلت هذه النظرية المساهمة الرئيسية لدى “تشومسكي” في علم اللغة وعكست فلسفته الخاصة ذات النزعة العقلانية في البحث عن أساس معرفي وكانت بمثابة استمرار للفلسفة التحليلية التي تضع اللغة في مركز التحليل الفلسفي.
وفي هذا الكتاب يسعى عبد الرحمن إلى تأسيس بنية دلالية، عميقة، في صياغة العبارات اللسانية، وتحويلها إلى منطق أو “لغة محمولة”، مبينًا أوجه القصور في نظرية “تشومسكي”، ومستعرضًا ما تلاها من محاولات، عوّضت بعض النقص فيها ليقدم هو طرحه الخاص.
اللغة “تمرين ذهني”
لم يشأ عبد الرحمن عرض تفاصيل نظرية “القواعد التحويلية التوليدية” لتشومسكي، مكتفيًا ببيان أوجه القصور فيها، فجاء طرحه مركزًا ومباشرًا، ربما لأن الغرض منه ليس نقد مساهمة الفيلسوف الأمريكي في هذا المجال، بقدر ما هو تأسيس لمساهمة جديدة تأخذ في حسبانها إخفاقات ما سبق.
ولكن ما هي نظرية تشومسكي؟.. في نظريته المسماة “القواعد التحويلية التوليدية”، عارض الفيلسوف الأمريكي علم النفس السلوكي في شرحه لكيفية استخدام اللغة مفضلاً المذهب الفطري، ومعتقدًا أن الطفل من الممكن أن يتعلم اللغة لأن لديه قدرة عقلية لغوية منذ ولادته. أما استخدام اللغة لدى البالغين فهو عبارة عن “تمرين ذهني” بما يعني أن اكتساب اللغة صفة فطرية.
هذه النظرية غيرت علم اللسانيات وفلسفة اللغة بشكل جذري، وهي عبارة عن نظريتين متكاملتين، فالنظرية التوليدية عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل من خلال عدد من المفردات، على توليد عدد غير محدود من الجمل. أما النظرية التحويلية فتُعنى بتطبيق مجموعة من قواعد الحذف، والاستبدال، والاضافة وتغيير مواقع الجُمل.
ورأى تشومسكي في طرحه أن الدماغ البشري “مبرمج بيولوجيًا” لتعلم اللغة، ولذلك فإن القدرة العقلية لتعلم اللغة تعد فطرية، وليست سلوكية، متبنيًا مفهوم القدرة اللغوية الفطرية للإنسان، وهو عبارة عن آليات وقدرات لغوية، غريزية، تنمو من خلال التفاعل مع البيئة اللغوية، المحيطة خلال مرحلة الطفولة، وتساعده هذه الغرائز على اكتساب المعلومات اللغوية وتخزينها وتكوين قواعد اللغة الأم على مراحل تصاعدية حتى تصل إلى مرحلة الاكتمال والثبات، وعندها يستطيع الطفل صياغة وفهم جمل لا متناهية لم يتكلم أو يسمع بها من قبل.
أفكار تشومسكي التي استوحاها من الفلاسفة الغربيين أفلاطون وديكارت، وسبينوزا وكانط، تقع في خط “الفلسفة التحليلية” حيث يلعب المنطق واللغة دورًا أساسيًا في التنظير، وقد وظف المنطق والرياضيات في التحليل اللغوي. وفي نظريته “التحويلية التوليدية” يٌنشئ الرجل مجموعة صغيرة من القواعد التي يمكن أن تولد بشكل صحيح جميع التركيبات الممكنة من الكلمات لتشكيل الجمل النحوية في اللغة، وذلك باستخدام “خوارزمية” للتنبؤ بالجمل الصحيحة نحويًا.
اللغة “المحمولية”
نعود إلى كتابنا “المنطق والنحو الصوري” لطه عبد الرحمن، الذي جاء متضمنًا ثلاثة أبحاث يمثل كل منهما فصلاً، وكل فصل يتضمن بدوره العديد من الأمثلة الشارحة والأشكال التوضيحية بهدف تبسيط الفكرة للقارئ، معتمدا منطق “المحمولات”.. موضحًا السبب في هذا الاختيار بأنه باب من أبواب المنطق التي أثبتت قدرتها على الصياغة الصورية للنظريات العلمية، مبينًا في الفصل الأول من الكتاب أن هذه الصياغة تطورت أساليبها لدى اقترانها بالرياضيات، وأن “المناطقة” أي أهل المنطق امتحنوا خصائصها امتحانًا نهائيًا.
في الفصل الأول يتطرق عبد الرحمن إلى تركيب اللغة “المحمولية”، شارحًا كيفية صياغتها صياغة توليدية، أي تحويل قواعدها النحوية إلى قواعد تركيبية على طريقة التوليديين، ويضرب المؤلف أمثلة لهذه الصياغة، ثم يمتحن قدرتها على النقل الصوري للعبارات المتداولة من خلال أمثلة يكثر استخدمها في اللغة العربية. ويلاحظ هنا أن عبد الرحمن يطبق بنيته على اللغة العربية، وهي اللغة التي أهملتها النظريات الغربية بما فيها نظرية “تشومسكي” التي لم تستوعب كل اللغات، وهي إحدى أوجه القصور التي سيتحدث عنها لاحقًا في معرض تحليله لأفكار الفيلسوف الأمريكي الخاصة باللغة.
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة أخرى، وهي الصياغة الصورية للعبارات اللغوية فيوضح أقسام الكلمة، والجملة، مؤكدًا أن “اللغة المحمولية” بعباراتها السليمة لا تزيد عن كونها تراكيب خالية من المضمون ولا فائدة من ورائها بالنسبة للتعابير اللسانية التي تنقلها إلا إذا اكتسبت دلالة ما، ولا تكتسب هذه الدلالة إلا إذا وضعت لها قواعد وهذه المرة قواعد تأويلية.
هذه الملاحظة المهمة تقود فيلسوفنا إلى نقطة الدلالات، فيبدأ بالدلالة “الماصدقية” التي يعرفها بأنها “دلالة تقوم على ما صدق أسماء العلم وما صدق الصفات وما صدق العلاقات”، فالدلالة بالنسبة للنسق المحمولي هي إسناد وتقويم العبارات بناء على هذه الإسنادات الماصدقية لها، وبالتالي يتأتى تأويل عبارات اللسان الطبيعية المنقولة إلى اللغة المحمولية تأويلاً ماصدقيًا.
عند هذا الحد يتساءل عبد الرحمن: إلى أي مدى يمكن إرجاع الدلالة اللسانية إلى الدلالة الماصدقية؟.. وهل تقوم دلالة الجمل الطبيعية فقط في المدلولات الخارجية التي تحملها وصفاتها والعلاقات القائمة بينها؟..
من خلال عرض بعض الأمثلة يتضح لفيلسوفنا عدم كفاية المعيار الماصدقي في التقويم الدلالي للعبارات المنطوقة، ويكتشف المؤلف أن ماصدقها لا يتعلق فقط بماصدق أجزائها ومن ثم ينتقل إلى الدلالة المفهومية، وقواعد التقويم المفهومي موضحًا أن كثير من المناطقة حاولوا منذ مطلع الستينات من القرن الماضي أن يضعوا أسس تأويل يختلف عن التأويل الماصدقي. ويعني ذلك – كما يقول عبد الرحمن- البحث عن تأويل لا يتقيد بالعالم الخارجي الذي يحتوي الأفراد، والوقائع، وإنما يتعداه إلى عالم آخر هو عالم الإمكان، ومن هنا سوف تصبح العبارة الدالة دالة ليس فقط للعالم الواقعي، بل دالة أيضًا بالنسبة لكل العوالم الممكنة.
ومن أجل المزيد من التوضيح، يقدم عبدالرحمن نموذجًا للصياغة الصورية وتأويلها المفهومي، ويرجع هنا إلى عالم اللغة الأمريكي “مونتيغيو” الذي قام بتأسيس نظرية لغوية جديدة وتخريجها تخريجًا رياضيًا عاليا لا سبيل لغير الاحصائيين إلى إدراكه، وذلك إحساسًا منه بضرورة التأويل المفهومي للغة الطبيعية. حيث يرفض “مونتغيو” الرأي الشائع القائل بتمايز اللغة الصورية، واللغة الطبيعية، ويرى أن الوسائل العلمية لمعالجتها واحدة، وأن اللسان المنطوق في نحوه وتأويله قابل كل القابلية لمعالجة رياضية لا تختلف في دقتها وصوريتها عما هو عليه الأمر بالنسبة للغة المحمولية، وينتهي إلى أن ما تقوم به المدرسة التوليدية، “مشكوك في مصداقيته العلمية”. ومن جانبه، يرى عبد الرحمن أن الصياغة الصورية المنسقة للعبارات اللسانية وتأويلها المفهومي بدأت مع “مونتيغيو”، لذلك جاء بأمثلته عليها، لكنه راعى المقتضيات النحوية للغة العربية، ثم عرض بعد ذلك المراحل التي مرت بها نظريته. ورغم إثباته الصياغة المحمولية كوسيلة لوصف العبارات المنطوقة، لم يقر عبد الرحمن بأنها النموذج الأمثل للوصف اللساني في شكلها الحالي، فهناك صعوبات تعترض سبيل الصياغة المنطقية، أولها أن التحليل المنطقي للعبارات اللغوية غير محدد، وثانيها أن الاختلاف عميق بين النسق المحمولي، والنسق اللساني.
وفي ختام هذا الفصل يعود عبد الرحمن إلى “تشومسكي” من جديد، مبينًا أنه لم يستفد من المنطق على مستوى الواقعة اللسانية نفسها قدر استفادته الصريحة منه على مستوى بناء النظرية العامة للبنية اللغوية، فتأثير المنطق على نظريته العامة لا يقف عن حد البنية النحوية بل يتعداها الى البنية التأويلية. ويستعمل “تشومسكي”، نفس الطريقة المتبعة في المنطق لتقويم العبارات المركبة، انطلاقًا من القيم المسندة إلى عناصرها، وهو تطبيق لما يعرف بـ”مبدأ الارتباط الصدقي”، ويعتبر أن الانفصال الذي حققه الفيلسوف الأمريكي عن البنيوية اللسانية الأمريكية يرجع الفضل فيه إلى المنطق الرياضي، وأن الوسائل التقنية هي التي مكنته منها حتى يصوغ نموذجه التحويلي صياغة دقيقة.
وتابع عبد الرحمن ملاحظاته النقدية على أفكار “تشومسكي”، مشيرا إلى أنه قصّر على مستوى الظاهرة اللسانية ذاتها، وأبخس المنطق حقه فيها، بل إنه تعمد طيّ المنطق وتلبيسه، لأن كثيرًا من البنى العميقة النحوية التي وضعها لبعض الجمل لا تختلف عن البنى العميقة المنطقية، وخلص فيلسوفنا إلى أن هذا التقصير من جانب “تشومسكي” تجاه المنطق على مستوى الظاهرة اللسانية، المنطوقة، نفسها هو الذي يفسر الانتقادات التي وجهت إلى نظريته في صلبها. وأوضح أن “تشومسكي” لو كان قد التزم بالمنطق في الصياغة النحوية للظاهرة اللسانية، لكان أهدى وأوفق في بناء نحو ينطبق على لغات مختلفة ومن جملتها اللغة العربية. ولم ينس المؤلف أفكار مدرسة الدلاليات التوليدية التي انشقت عن” تشومسكي” فقد أدخلت هذه المدرسة ما أخرجه هو، مثل مقومات البنية المنطقية العميقة فأدخلوا “الأسوار” و”المتغيرات”.
النحو الصوري واللسان الطبيعي
على الرغم من تأكيد عبد الرحمن في كتابه على ضرورة اعتماد اللساني على المنطق، إلا أنه لا يدعو إلى التطبيق المباشر والأعمى لمقولات المنطق على اللغة، والانغلاق داخل نسق صوري، فهو في الحقيقة يدعو إلى التطبيق المحكم والتوسيع لمجال المنطق نفسه وتطوير أدواته حتى تكون أنسب للوقائع الدلالية في نطق الناس للغات الحية على مستوى العالم.
من هذا المنطلق، ينتقل عبد الرحمن إلى الفصل الثاني الذي أفرده لمناقشة النحو الصوري واللسان الطبيعي، وهذا الأخير يتجدد السؤال عنه في إطار الوسائل الصورية والرياضية التي توفرت للباحثين في ميادين اللغات الاصطناعية ولغات البرمجة والترجمة الآلية. وقد بدأ هذا الطرح الرياضي للسؤال اللغوي مع “تشومسكي” في كتابه “البنى النحوية” الذي تطرقنا إليه سلفًا، وتوالت بعد ذلك الدراسات في هذا الاتجاه لباحثين من مختلف الاختصاصات.
ويعرّف عبد الرحمن موضوع هذا العلم بأنه “دراسة الخصائص الصورية للغة والنحو”، ثم يتعرض لجوانب من علم اللسان الرياضي التي تساعدنا على إدراك طبيعة اللغة والنحو الذي تقوم عليه.
وتسهيلاً للقارئ يبتعد المؤلف في شرحه قدر الإمكان عن تعقيدات المنهج الصوري التي لا مناص منها لأي مجال يريد أن تكون له نتائجه العلمية وفوائده العملية. ويعرّف فيلسوفنا كذلك بعض المفاهيم الرياضية الأساسية حتى يسهل على القارئ استيعاب النتائج المثبتة لبيان النحو الصوري وخصائص اللغة التي ينشئها، وأصنافها ثم يعالج تطبيق هذه النتائج على الألسن الطبيعية. موردا بعض الملاحظات بصدد اللغة العربية وخاصة الجملة الفعلية فيها، معتبرًا أن هذه الملاحظات قد تشكل منطلقًا لبحث لغوي يعتمد الأسلوب اللساني الحديث في معالجة اللغة.
بدأ عبد الرحمن الفصل الثالث الذي جاء بعنوان “النحو المقولي”، وهو تتمة للفصل السابق له، ببيان أن فكرة الأنحاء المقولية قد ظهرت مع المنطقي البولوني كازيميرتس ايدوكيفيتش، في مقالته “الاقتران التركيبي” الصادرة في العام 1935، والتي تأثر فيها بمقال ستانيسلاف ليسنيفسكي المعنونة “أصول نسق لأسس الرياضيات والصادرة في العام 1929. ثم عالج بعده المنطقي “بارهيلال” هذا النحو وأبرز حدوده ومداه في مقالات مختلفة، من أهمها “الترقيم شبه الحسابي للوصف التركيبي” الصادرة عام 1953، و”في الأنحاء المقولية والتركيبية” الصادرة 1960، كما تناوله بالبحث دارسون آخرون منهم بوشنسكي في بحثه تحت عنوان “في المقولات التركيبية” الصادر عام 1949، ولامبيك في “رياضيات بنية الجملة” الصادرة عام 1958، و “في حساب الأصناف التركيبية” الصادرة 1961. وقد عرف هذا النحو تطورات مهمة في العقد الأخير من هذا القرن، منها الاتجاه الذي يمثله صاحب مدرسة لوس أنجلوس عالم الرياضيات “مونتيغيو” بمقالاته التي تميزت بتعقيد رياضي كبير.
ويوضح عبد الرحمن كيف أن هؤلاء المناطقة استرعت انتباههم الكيفية التي ترتبط بها التراكيب بعضها مع البعض لتكون تراكيب أخرى، ولدراسة هذا الارتباط بين التراكيب في الجملة اهتدوا إلى فكرة المقولة النحوية ووضعوا معيارًا أساسيًا لتحديد هذه المقولة أسموه معيار تبادل المواقع، ويقضي هذا المعيار بأن نعتبر التركيبين اللذين يتبادلان موقعهما في الجملة منتمين إلى مقولة نحوية واحدة.
ويعرض عبد الرحمن في الفصل الأخير من كتابه أصناف المقولات التي تنقسم إلى مقولات أصلية، ومقولات فرعية، ليخلص إلى أن النحو المقولي يقتضي لإسناد المقولات النحوية تحليلاً دقيقًا للخصائص التركيبية لكل كلمة نحوية، وأن هذا التحليل لا يبرز العناصر التي تتركب منها الجملة فقط، بل يحدد علاقات الترابط القائمة بينها أي صفتها الاقترانية مما يفيد في التحليل الآلي وفي ترجمة النصوص.
ويخلص فيلسوفنا العلامة طه عبد الرحمن في نهاية طرحه أن “النحو المقولي” تعترضه صعوبات جمة، خاصة بالنسبة للألسن التي تتوفر على نسق صرفي
متطور ومعقد مثل اللغة العربية، وهو ما يدعو الى إدخال عدد كبير من المقولات وتعقيدها غاية التعقيد في هذا المجال بالغ الأهمية.
المنطق والنحو الصوري
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العاليمة

 العربية
العربية  English
English