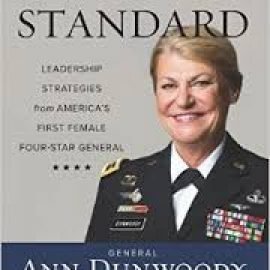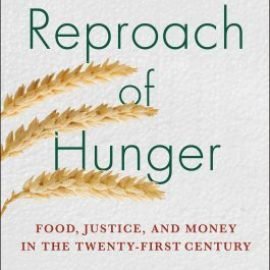الوصف
كتاب المنقذ من الضلال
هذا الكتاب من الكتب المشهورة في تراثنا الديني، ألَّفه أبو حامد الغزالي (1058م – 1111م) ليحكي فيه تجربته التي مر بها مع مصادر العلم والمعرفة التي لم تمنحه -كما يقول- اليقين حتى اهتدى إلى التصوف فوجد فيه ما يمكن تسميته بجامع العلوم والحكم.
بعد مقدمة طويلة مدح فيها نفسه بطريقة ملفتة للنظر حتى ليهيأ للقارئ أنه أمام رجل اطلع على علوم أهل الأرض جميعا لا سيما لدى الحضارات القديمة: المصرية والهندية والصينية واليونانية .. فلم يعجبه من ذلك شيء، ثم اطلع على المكتبة العربية والإسلامية فاستوعب ما كتبه العلماء الذين وصفهم بالمقلدين فوجدهم مقصرين، وما كتبه المتكلمون “من أهل السنة” فوجدهم قد قطعوا نصف الطريق وقدموا نصف الدواء، وطالع كتابات الفلاسفة من أفلاطون وسقراط وأرسطوطاليس ومن نهج نهجهم من المسلمين كالفارابي وابن سينا فما وجد لدى هؤلاء جميعا إلا “الكفر والزيغ والضلال”.
ثم حاول الاعتماد على ذاته فبدأ بالحواس كالعين التي ترى والأذن التي تسمع فعلم أنها جميعا تخطئ، إذ القمر الذي تراه العين في حجم الدينار ليس بهذا الصغر، فكيف يوثق بها؟!
ثم انتقل إلى العلوم العقلية كالرياضيات فشكك فيها أيضا رغم ما يظن الظان أن من البدهي الذي لا يحتاج إلى برهان قولنا مثلا إن العشرة أكبر من الثلاثة، فقال إن العقل نفسه لا يوثق به وأنه لا شيء اسمه بدهي، ذلك لأننا – والكلام للغزالي بالطبع – نرى في المنام أحلاما نظنها حقيقة ولا ندري أنها ليست حقيقة إلا بعد استيقاظنا وعودة الوعي إلى عقولنا، لذلك فحتى العقل لا يُعتمد عليه كمصدر للمعرفة وأداة موصلة لليقين.
وبعد أن “استخف” الغزالي في كتابه المشار إليه بكل العلوم والمعارف السابقة، وبعد أن نقد كل مصادر المعرفة؛ الحسية منها والعقلية، وصل “حجة الإسلام” إلى نتيجة مفادها أن المعرفة واليقين لا يأتيان إلا عن طريق التصوف، ففيه تصفو النفس وتتصل الروح بخالقها وتنفتح “خلف حُجب العقل” عينٌ يرى منها الرائي ما لا يراه غيره، ويقذف الله في قلبه نورا “يعرف” به ما جهله الجاهلون، وبذلك يخرج من الحيرة ويُنقذ من الضلال (عنوان الكتاب المنقذ من الضلال).
هذا تقريبا وبحسب فهمي هو خلاصة هذا الكتاب الذي ذاع صيته وعظم أثره في تشكيل العقل المسلم منذ ألف عام حتى الآن.
وبعيدا عن لغة “الاستعلاء” التي كتب بها الغزالي كتابه بدعوى أنه على الحق وغيره على الضلال، وأنه ممسك بزمام اليقين وغيره يترنَّح في دروب الشك. وبعيدا عن “استخفافه” بعقائد المخالفين له في الرأي ورميهم بالكفر والزندقة رمي من لا يخشى عواقب هذا الحكم وتداعياته وكأنه يهش عن وجهه ذبابة، وناهيك عن إخراجه للفلاسفة ومن اقتنع بكلامهم من بوابة الدين التي يظن الغزالي نفسه حارسها يفتحها لمن يشاء ويغلقها في وجه من يريد، بعيدا عن هذا كله، فإن المنهج الذي انطوي عليه الكتاب هو الأخطر، ذلك لأن المحصلة النهائية أن المسلم لا يعد بحاجة إلى العلم لاستكشاف قوانين الكون وتسخير الطبيعة، فالعلم وأدواته من ملاحظة بالحواس واستنباط بالعقل وتجربة لإثبات صحة الشيء من خطئه مشكوك فيه، ولا قيمة له، طالما أن بالإمكان تحصيل العلم والمعرفة اليقينية بالزهد والطاعة والخلوة وصفاء النفس وسمو الروح اوارتقاء الإنسان في مقامات الحضرة الإلهية وصولا إلى مرتبة تهيئه لأن يقذف الله في قلبه نورا يرى به كل شيء ويفهم في ضوئه كل شيء.
والحق أن الغزالي في كتابه هذا قد أضاف للتصوف – الذي نحبه ونشجعه لأنه الوجه الإنساني للدين – دورا وأوجد له وظيفة ما كان ينبغي له أن يتورط فيها مدفوعا بحماسة زائدة، فأغلب ما قاله يمكن قبوله إذا اقتصر على المعرفة اليقينية بالله الذي لا تدركه العقول، أما أن يسحب ذلك -كما يُستدل من كتابه- إلى المعرفة على إطلاقها والعلوم بإجمالها فإنه بذلك قد منح العقل المسلم إجازة طويلة امتدت لعشرة قرون.
كتاب المنقذ من الضلال
المزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English