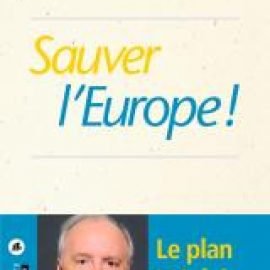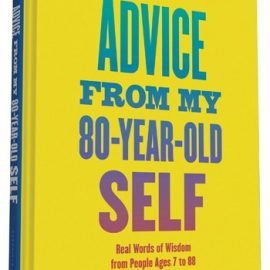الوصف
صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف كُتب وكيف يُكتب؟ الإجابات الممكنة” (1056 صفحة، موثقًا ومفهرسًا)، يضمّ اثنين وثلاثين بحثًا محَكّمًا قدّمها مشاركون في المؤتمر الثالث للدراسات التاريخية الذي أقامه المركز في بيروت في الفترة 22-24 نيسان/ أبريل 2016، إذ اجتمعوا ليعرفوا إنْ كان ثمة تاريخ للعرب وحدهم، أو تاريخ واحد للعرب، وليبحثوا في مسألة التحقيب التاريخي العربي.
يقدّم خالد زيادة مدخلًا للكتاب، بعنوان “استخدام الوثائق في كتابة التاريخ العربي”، يؤكد فيه أنّ الوثائق تُبطل استناد التاريخ إلى أخبار الإخباريين أو أصحاب التراجم، بل تُسنده “إلى تراكم المعطيات التي تنقل التاريخ من سرد للوقائع والأخبار إلى مواجهة مع صفحات متحركة ومتطورة تتضافر فيها مجموعة من المعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلًا عن دور الدين وحركاته في تفسير علاقات السلطة بالفئات المجتمعية، إلى تطور الأسعار والغلاء وحركات العامة والثورات، ثمّ الانتقال من المؤسسات التقليدية إلى المؤسسات الحديثة”. وبحسب زيادة، تضع الوثائق الشرعية والحكومية والقنصلية والتجارية المؤرخ على تماسّ مع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإحصائية، ولا تحدث أيّ كتابة تاريخية معاصرة “من دون العودة إلى الوثائق والاستناد إليها واعتبارها مصدرًا رئيسًا لهذه الكتابة، اعتمادًا على منهجيات علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا وتقنياتها، من أجل تجاوز الكتابة التاريخية المؤسسة على فرضيات أيديولوجية”.
تحقيب تاريخي
في الكتاب ثلاثة أقسام. يتألف القسم الأول، “كتابة التاريخ العربي حقلًا وتحقيبًا ومنظورًا”، من عشرة فصول. في الفصل الأول، “نحو مقاربة منهجية لدراسة التاريخ العربي من منظور التاريخ العالمي: مسألة النظر إلى الثقافات الأخرى”، يرى أحمد الشبول أنّه لا بدّ للمؤرخ الجادّ من أن يكون منطلقًا من وعيه بأوضاع عصره، ومن موقعه الجغرافي. ويتساءل: أليست إحدى مهمات المؤرخ العربي الجادّ أن يكون ابن عصره كمفكّر فاعل بالمعنى الإيجابي، حتى لو كان يؤرّخ لعصور سابقة؟ أليس من مهمات المؤرّخ العربي أن يسعى لأنْ يكون إنسانيًا في توجهاته؟ ألا يحسن بالمؤرخ العربي المعاصر أن يتجاوز دائرة التخصص الضيّق، والتحقيب المصطنع أحيانًا، ويستفيد من مناهج المختصين بالعلوم الاجتماعية والنقد الأدبي والأدب المقارن؟
في الفصل الثاني، “مشكلة التحقيب: التاريخ العربي الإسلامي أنموذجًا”، يجد أحمد أبو شوك أنّ تقسيمات الزمن التاريخي استندت إلى الفضاء العالمي المفترض، أو البُعد الحضاري المرتبط بنشوء الحضارات وسقوطها، أو الحوادث المفصلية في المسار التاريخي، أو الانتماءات الأممية أو القومية للشعوب، إذ يقول: “أمّا عملية التحقيب نفسها، فهي من صِنْعَة المؤرخ الذي يتَّبع معايير متغيرة، تخضع لتصوره المنهجي لكيفية تشكّل الحادث التاريخي، والمدرسة التاريخية التي ينتمي إليها؛ لذلك نجد حدود التحقيبات لا تستقر على نسق واحد”.
الفصل الثالث، “الربيع العربي حلقة جديدة في التحقيب التاريخي: الإرهاصات التأسيسية لكتابة تاريخ غير مدون”، يسمي إبراهيم القادري بوتشيش الربيع العربي “حقبةً جديدةً”، فيرسم المتغيرات التي عرفتها بنية الذهنية العربية في تزامنها مع وقائع الربيع العربي، ومع الطفرة التكنولوجية والثورة الرقمية العالمية؛ من خلال دخول المجتمع العربي في الزمن السيبراني، وتحوّل التفكير في طرائق التغيير، والانتقال إلى التغيير الناعم، أي السلم والحوار، بدلًا من التغيير بالانقلابات والعنف.
ذاكرة وهوية
يؤكد محمد مرقطن في الفصل الرابع، “الحضارات القديمة في البلدان العربية ومسألة تكوين الهوية التاريخية لأمة العرب”، أنّه لا بدّ للباحث في تاريخ حضارات الجزيرة العربية من استخدام نقوش الجزيرة العربية وكتاباتها قبل الإسلام. فمن غير الممكن الاعتماد على مصادر التراث العربي الإسلامي منفردةً في كتابة التاريخ العربي الإسلامي، ولا بدّ للمؤرخ من استخدام المنهجيات والمعايير العلمية العالمية التي توصلت إليها العلوم الحديثة في مجال العلوم الإنسانية. ويلفت الانتباه إلى الدور الذي تؤديه الحضارات القديمة في بلاد العرب في تكوين الشخصية والهوية التاريخية العربية.
في الفصل الخامس، “البحث عن الزمن الضائع: صراعات الثورة والذاكرة والعدالة في مصر: البحث عن زمن جديد”، يقول محمد عز الدين إنّ الثورة المصرية وضعت الفكرة التقليدية عن الذاكرة بوصفها مستودعًا، أو مخزنًا، للذكريات أمام تحدٍّ مفاهيمي وسياسي عميق. ويكمن التحدي النظري في كيفية التعبير زمنيًا عن الحاضر المتفجر، والتعبير مفاهيميًا عن حادث متغير وفياض ومفتوح الأفق، خصوصًا أنّ محاولة حصر الحادث الحاضر في مسمًّى، أو “دال”، محدد ومحكم؛ مثل انتفاضة، أو عملية ثورية، أو حتى أزمة سياسية، محاولة قاصرة، تنطوي على درجة من التشييء والتطبيع.
في الفصل السادس، “في منهجية كمال الصليبي: ‘التوراة جاءت من جزيرة العرب'”، يسلط عبد الرحمن شمس الدين الضوء على ما يُعَدّ من أكثر النظريات إشكاليةً في التاريخ التوراتي، قائلًا: “كما هو معلوم، قام الصليبي برسم خريطة جديدة لأرض التوراة الأولى، بعيدًا عن فلسطين في جنوب غرب شبه جزيرة العرب”، معتمدًا في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة على أسماء الأماكن المذكورة في التوراة، ليحدد المجال الجغرافي الذي شهد الحوادث التوراتية الأولى.
مقاربات ومصادر
يتناول عمار السمر في الفصل السابع، “من المقاربات الرسمية لكتابة التاريخ العربي”، تجربتين لكتابة التاريخ: الأولى سورية، والثانية عربية، حاولت كلتاهما كتابة تاريخ العرب من منظور قومي، مع الفرق الشاسع بين معنى القومية ومفهومها عند حزب البعث ومعناها ومفهومها عند جامعة الدول العربية. ويذكُر أنّه كانت هناك نقاط التقاء وتشابه بين التجربتين من حيث المشروع الأولي ومخطط العمل فحسب، ويعود ذلك إلى مشاركة بعض واضعي المشروع الأول السوري، أي مشروع كتابة تاريخ العرب، في وضع أُسس المشروع الثاني العربي، أي الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية.
في الفصل الثامن، “البحث في التاريخ الاقتصادي العربي: مقاربة أستوغرافية لدراسة الإسلام الكلاسيكي”، يجد محمد الأزهر الغربي أنّ المعطى السياسي، وأحيانًا الأيديولوجي، طغى على المؤرخين فلم يبذلوا جهدًا لإدراك تاريخهم الاقتصادي العربي واعتماد مقاربة جديدة تستمد كنهها وطبيعتها من هذا الاختصاص. وبحسب رأيه، تتعلق المسألة بتحديد منهاج أو ثقافة جديدة ذات منحًى اقتصادي ينظر من خلالها إلى التاريخ الاقتصادي العربي بصفة مجرّدة، أي بمعزل عن السياسة والأيديولوجيا والذات لسبر أغوار المصادر العربية المتعددة والثرية؛ من أجل استنطاقها واستخراج معلومات واستنتاجات ربما تُعين على تحديد تحقيب جديد للتاريخ العربي.
بحسب أنور زناتي في الفصل التاسع، “كُتب النوازل مصدرًا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب والأندلس: نوازل ابن الحاج أنموذجًا”، في نوازل ابن الحاج حوادث تاريخية وفقهية واقتصادية واجتماعية ربما لا تتوافر في كتب التاريخ، لأنها تعالج الظواهر بحسب مقتضيات الزمان والمكان. وفيها أيضًا جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفقهية حافلة بالمعلومات والنصوص والوثائق التي تمسّ المجتمع في الغرب الإسلامي. وهنا تكمن أهميتها.
تلقي أمل غزال في الفصل العاشر، “تاريخ العرب الحديث بين التقسيم الإقليمي والتهميش المذهبي والإثني: الإباضية مثالًا”، الضوء على بعض النواحي الفكرية والسياسية لتاريخ الإباضية، ودمجها بالخطوط العريضة للتاريخ العربي الحديث، قائلةً “فإلقاء الضوء على الحكم البوسعيدي في شرق أفريقيا أبرز عمقه العربي وارتباطه بالحركات المؤثرة في العالم العربي ومؤازرته لها. والأمر نفسه يتعلق بإباضية الشمال الأفريقي وإنتاجهم الفكري وعملهم السياسي. أمّا تحليل أدوار الإباضية هذه، فأتى في سياق انتمائهم إلى شبكات الإصلاح الإسلامي والتقارب المذهبي بهدف الوحدة الإسلامية، وتكوين الهوية الوطنية التي كانت إحدى دعائمها الهوية العربية المرتبطة أيضًا بمشروع سياسي وحدوي”.
ميكروستوريًا وأستوغرافيًا
يتألف القسم الثاني، “مسائل واتجاهات في التواريخ الوطنية”، من ثمانية فصول. وفي الفصل الحادي عشر، “هل يمكن المساهمة في إعادة صوغ التاريخ الفلسطيني عبر ‘الميكروستوريا’؟ دراسة حالة: مذكرات الصحافي الفلسطيني عيسى العيسى”، تقيس نهى خلف قدرة الميكروستوريا الفعلية على المساهمة في ملء بعض الثغور في عملية التأريخ الفلسطيني، من خلال الكشف عن بعض المسكوت عنه في هذا التاريخ، ودراسة سيرة الصحافي الفلسطيني عيسى العيسى، كما وردت في مذكراته ومقالاته وآرائه، وكما نُشرت في جريدة فلسطين.
وجد عبد الرحيم بنحادة في الفصل الثاني عشر، “في إنتاج المعرفة التاريخية في المغرب”، أنّ الإنتاج المعرفي التاريخي غزير في المغرب، “لكن ينبغي ألا ينسينا هذا الإنتاج الوضعية المتأزمة للبحث التاريخي بما هي جزء لا يتجزأ من أزمة البحث العلمي في العلوم الإنسانية؛ فالتراكم الذي تحقق منذ حصول المغرب على الاستقلال تراكم هشٌّ لا يسمح بتجدد الأجيال بالصورة التي تحافظ على الجودة والصدقية”.
في الفصل الثالث عشر، “كتابة تاريخ المغرب وتحقيب الزمن الطويل”، لا يرى محمد حبيدة فائدة كبيرة في تحقيبٍ قائم على فترات مقننة. فالتعامل مع الزمن بهذه الطريقة يُفقد التاريخ إشكالياته الأساسية، ويُغرقه في مقاربة تهشّم المعرفة التاريخية. وليس التحقيب عمليةً كرونولوجيةً ميكانيكيةً، وإنما هو عملية منهجية، قائلًا: “يدفعنا هذا المنطق إلى موضَعة مرحلة ما قبل الاستعمار في سياق عصور وسطى ممتدة، تظهر بُناها ومظاهرها بشكل واضح في القرن التاسع عشر”.
في الفصل الرابع عشر، “مسألة الدولة في الأستوغرافيا التونسية الحديثة: سياقات ومقاربات”، تستند فاطمة بن سليمان إلى عيّنات ممّا أنتجته الأستوغرافيا التونسية منذ الاستقلال في عام 1956، ليتضح حصول تحولات واضحة بخصوص مسألة الدولة وتكونها في تونس، إذ تقول: “إنّ تغيير المقاربات وتجديد الإشكاليات وطرح التساؤلات التي توجه استعمال المادة الأرشيفية والمصدرية […] مكّن من الخروج من التوجه الدولتي وفتح آفاق متعددة أمام الدارسين لمسألة الدولة”.
أزمات واتجاهات وتحولات
يؤكد حماه الله ولد السالم في الفصل الخامس عشر، “أزمة كتابة التاريخ الوطني في موريتانيا”، أنّ كتابة التاريخ الوطني في موريتانيا تواجه عواقب إخفاق الدولة الوطنية في مشروع الاندماج، وضعف الإطار المؤسسي وسيطرة التواريخ القبلية والأسرية. ويرى أنّ التاريخ الموريتاني يبقى خطابًا يجب تجاوزه أيديولوجيًا وعملًا يجب إنجازه لتركيب تاريخ وطني علمي يسمح بالتوازن بين الخصوصية والكونية والقطرية والقومية.
في الفصل السادس عشر، “تحولات الكتابة التاريخية في مصر المعاصرة: الاتجاه والنظرية والمنهج والدور”، ترى نجلاء مكاوي أنّ المعركة مع الذاكرة لم تشمل ثورةَ عام 2011 كفعل تاريخي مهمّ اعترض مسار حركة التاريخ المصري فحسب، بل شملت ما مرّ به المصريون قبلها وشكّل أسباب انتفاضهم، إذ تقول: “هذه المعركة التي تخوضها سلطة تحاول تثبيت أركانها، مستخدمة الذاكرة أداة، ومستدعية خطابًا قوميًا طالما أثّر في كتابةٍ لتاريخ مصر سابقًا، ألقت بظلالها على وعي جيل ورث تراكمات التأثير السلبي فيها”.
يكشف مهند مبيضين في الفصل السابع عشر، “الأردن المعاصر: التاريخ الوطني واتجاهات التدوين”، عن المسارات التي كُتب فيها التاريخ الأردني الحديث والمعاصر، والتي عدَّته تاريخًا سياسيًا مرتبطًا بالحكم، وصورت كل معارضة على نحو سلبي، وأهملت تاريخ الناس والقوى المحلية التي كانت تستشعر هويتها واستقلالها في عقب انتهاء الحرب الكبرى. ويلفت الانتباه إلى ندرة الاشتباك مع التاريخ السياسي، أو البحث في شرعية الحكم في الكتابة التاريخية، قائلًا: “إنّ بعض الأزمنة والحوادث السياسية التي لا تتفق وسياسة الحكم بقيَ موضع اهتمامٍ أقلّ عند الباحثين”.
يكمن مسعى نصير الكعبي في الفصل الثامن عشر، “الكتابة التأريخية الحديثة في العراق: فحص في السياقات المتحولة والمقاربات المنهجية”، في إعادة تقويم الصور النمطية عن تاريخ الكتابة التاريخية في العراق وفق معيارين: داخلي ممثّل بالسياقات المتناوبة والمتغيرة بطريقة حادّة داخل الدولة وفلسفتها والتحولات الكبيرة في أيديولوجيتها النافذة والضاغطة على المسار الجمعي والرسمي، وخارجي ممثّل بالحواضن المنهجية والتكوينية للرعيل الأول من المتخصصين في حقل التاريخ.
عربي… غربي
في القسم الثالث، “التاريخ المقارن ومسائل من حقل الذاكرة والتاريخ”، أربعة عشر فصلًا. يتساءل سامر عكاش في الفصل التاسع عشر، “العلوم العربية والمركزية الأوروبية الجديد: إشكاليات التأريخ العربي للعلوم في الحضارة الإسلامية”، ماذا لو أعاد الغرب كتابة تاريخه العلمي معطيًا العرب والمسلمين دورهم في رواية تطور العلوم؟ كيف سيتفاعل المؤرخون العرب مع هذا التغيير؟ هل يقتضي هذا تغيير منهجهم في صوغ رواية العلوم العربية وسردها؟ هل يمكن أن يقود هذا التحول إلى إعادة النظر في مفهوم العلوم العربية؟ ويجيب عن هذه الأسئلة وغيرها متناولًا المركزية العربية الوسيطية وظهور العلوم الحديثة، والمركزية الأوروبية الجديدة، وصعود الغرب من منظور عربي.
في الفصل العشرين، “الغرب الإسلامي بين البحث التاريخي العربي والغربي”، يردّ عز الدين جسوس عزوف الدارسين الغربيين عن الاطلاع على البحوث العربية إلى الاختلاف اللغوي، متسائلًا: هل يعتمد الدارسون الغربيون المصادر والبحوث العربية المتميزة إذا ما تجاوزوا المشكلة اللغوية، لأنها أعمق وأكثر فائدةً، وفيها من الأصالة ما يجعلها في مرتبة الريادة؟
في الفصل الحادي والعشرين، “تاريخ الأندلس بين الكتابات العربية والأستوغرافيا الغربية: مراجعات نقدية ورؤى جديدة”، يقول طارق مداني إنّ إدراك أهمية تاريخ الأندلس في تعقده وقدرته على استفزاز العقول وإثارة الأسئلة يقتضي بداية مرحلة بحثية جديدة تقطع، بوضوح، مع فكرة الأندلس المنحوتة سلفًا، نحو إثارة الإشكالات الحقيقية، خصوصًا أنّ الكتابات العربية ما زالت مسكونةً بهاجس ردة الفعل، ومطبوعة بالمقاربة الوصفية من دون الاستناد إلى أنموذج تفسيري موضوعي ومغاير، يتجاوز القراءات المشوّهة للحقائق التاريخية.
يقدّم صالح علواني في الفصل الثاني والعشرين، “تاريخ أفريقيا الشمالية: بلاد المغاربة بين ‘كتاب العبر’ والمدارس الفرنسية المعاصرة”، صورةً أوليةً عن كتابة تاريخ المغرب العربي، فيقول إنّ هذا التاريخ كُتب بحسب مناهج لم تكن لتؤدي موضوعيًا إلى إنتاج تاريخ للمنطقة خالٍ من الشوائب. فـ “باستثناء ابن خلدون، الذي أسّس مدرسة في المنهج التاريخي وترك ‘كتاب العبر’ كأفضل ما كتب عن تاريخ البربر، قوبل بالجحود والنسيان إلى حدود القرن التاسع عشر، حينما بسط الاستعمار نفوذه على كامل شمال أفريقيا، وأصبحت كتابة تاريخه خاضعةً للفكر الكولونيالي وتحت رحمة المستشرقين”.
تاريخ؟ ذاكرة؟
في الفصل الثالث والعشرين، “صورة البيزنطيين في الحضارة العربية من خلال اللغة”، يقول محمد الطاهر المنصوري إنّ العرب في العصر الوسيط سعوا لمعرفة الآخر، أي الإمبراطورية البيزنطية بصفتها عدوًا مباشرًا أقرّ القرآن بوجوده. هذا الآخر في الدين هو المسيحي، وفي الجنس هو الرومي، وفي اللون هو من بني الأصفر. وما كان التعرّف إلى هذا الآخر جزئيًا، بل كان نظرةً كليةً شملت الدين والسياسة والعادات والسلوك والحياة اليومية، واللغةَ أيضًا.
يعثر عبد العزيز الطاهري في الفصل الرابع والعشرين، “الأستوغرافيا العربية المعاصرة بين التاريخ والذاكرة: المغرب أنموذجًا”، على جدلية بين التاريخ والذاكرة في استعادتهما الماضي. فالذاكرة تمثّلات انفعالية وانطباعية وأسطورية وانتقائية للماضي، محكومة برهانات وسياقات سياسية وأيديولوجية، في حين أنّ التاريخ إعادة بناء عقلانية وعلمية ونقدية للماضي، يمكنه أن يستعين بالذاكرة مادةً أولية. ويلاحظ عودةً إلى الذاكرة وتضخمها، ما يطرح على المؤرخين المغربيين والعرب مسؤولية تحويل الذاكرة إلى موضوع قائم بذاته في البحث التاريخي.
في الفصل الخامس والعشرين، “التاريخ في الجزائر بين إحياء الذاكرة والبحث الأكاديمي”، يُمرحل مسعود ديلمي كتابة تاريخ الجزائر، هي: مرحلة كولونيالية حتى الاستقلال، ومرحلة بين الاستقلال وحوادث خريف عام 1988، ومرحلة بدأت مع الانفتاح الديمقراطي وإعلان التعددية في دستور عام 1989، ورُفعت فيها الرقابة عن النشر عمومًا؛ “فاستفادت الكتابة التاريخية بنشر عشرات الكتب بشأن التاريخ الوطني في شكل مذكرات، لكنها وسيلة اهتمام بالحادث أكثر ممّا هي نظرة قارئة للماضي من الفاعلين بعيون الحاضر”. وبحسب رأيه، فإنّ الكتابة التاريخية لم تتطور بسبب طغيان السياسة بتوظيف التاريخ وتغليب العمل الإحيائي للذاكرة على حساب التأريخ الأكاديمي.
ميثولوجيا وسير
في الفصل السادس والعشرين، “الميثولوجيا (الأسطورة) والتاريخ: نماذج للتحليل والاختبار”، يقرأ يحيى بولحية الميثولوجيا بعين أنثروبولوجية، ليكشف عن أهميتها على المستويين المعرفي والتنموي، قائلًا: “إنّ الطابع المفتوح للتاريخ يتمّ ضمانه من خلال الطرق العديدة التي يجري من خلالها تنظيم الخلايا الميثولوجية وإعادة تنظيمها. ومعركتنا الوجودية كعرب ومسلمين تبتدئ بالوعي التاريخي، وبشكل الكتابة التاريخية ومضمونها وغاياتها. إننا في حاجة إلى تفعيل رموزنا الميثولوجية وإخراجها من دائرة الوجود بالقوة إلى حيّز الوجود بالفعل”.
يقدّم عمرو عبد العزيز منير في الفصل السابع والعشرين، “السّير الشعبية العربية مصدرًا لقراءة تاريخ الفتح الإسلامي لمصر”، قراءةً في كتاب “فتوح مصر المحروسة على يد سيدي عمرو بن العاص”، فيرى أنّ السير الشعبية، “إذ تعيد إنتاج تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، لم تهتمّ كثيرًا بحقائق الحوادث والأماكن والشخصيات التاريخية والتتابع الزمني في سياقها التاريخي الفعلي، إنما وظّفت ذلك كلّه في خدمة هدفها الفني بمضامينه الاجتماعية/ الثقافية، بحيث تُبرز دور العامة في إعادة تشكيل تاريخهم، وهو الدور الذي أهمله المؤرخون التقليديون لحساب الحكام”.
في الفصل الثامن والعشرين، “تاريخ المهمّشين في الإسلام المبكّر: قراءة نقدية جديدة لسير بعض الصحابة”، ينظر محمد حمزة في علاقة كتابة التاريخ بتمثّل الماضي وبصناعة الذاكرة الجمعيّة. ويقول إنّ السيرورة التاريخية التي رفعت مكانة صحابةٍ وهمشت آخرين، شكّلت سياجًا دوغمائيًا يمنع مساءلة التاريخ، ما أدّى في وعي المؤمنين إلى مطابقة بين ما حدث في الواقع التاريخي وما حفظته ذاكرة الجماعة وما نقلته كتب التراث، وهذا يُنتج تحصين الصحابة وتاريخهم وبناء صورة متعالية لهم، وتشكيل صورة بعديّة للعصر الإسلامي الأول، صاغها الفاعلون الاجتماعيون عبر التاريخ الإسلامي من منظور سياسي ومذهبي.
مطموس ومهمّش.. ومألوف
تُميِّز محاسن عبد الجليل في الفصل التاسع والعشرين، “نحو مداخل منهجية وأدوات جديدة لكتابة تاريخ المطموس: تأريخ النَّبذ والإقصاء أنموذجًا”، بين تاريخ المطموس والمسكوت عنه وتاريخ الهامشيين. وبحسب رأيها، يداخل الطمس المعرفة التاريخية فيضحي متماهيًا عضويًا بها من مدخلين: ذاتي واجتماعي، قائلةً: “ما دام الوعي واللاوعي، الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية: المدونة والشفوية، مسرحًا ومؤولًا للطمس، فإنّ مقاربته تظل اشتباكًا مع بنًى كثيفة التعقيد، ولسبره سيجد المؤرخ نفسه ملزمًا باجتراح أدواته الخاصة وتوظيف مداخل منهجية تتقاطع وتتداخل، لتذليل تحديات بناء المعرفة التاريخية”.
في الفصل الثلاثين، “ابن خلدون في خطاب الهوية السودانية”، يعود عبد الله علي إبراهيم إلى تأريخ ابن خلدون للعرب المسلمين والنوبة السودانية في القرن الرابع عشر الذي تغذى منه خطاب الهوية السودانية في ما كان محطَّ صراع بين العروبة والأفريقانية عقودًا خلت. وينتقد نص ابن خلدون الذي كان الأساس لمؤرخي الشرق والغرب في تاريخ النوبة والعرب وانهيار دولة الأولين، في ضوء المعارف التاريخية والأنثروبولوجية والنفسانية المتراكمة.
في الفصل الحادي والثلاثين، “عود على بدء “دخول العرب المغربَ”: بين كوارثية الكتابة التاريخية وإنسيّة السرد المخيالي”، يرى عبد العزيز لبيب في السرديات الهلالية نزعةً خفيةً إلى تطهير الأخلاق الجمعية من المقاصد السياسية، قائلًا: “ليس معنى ذلك أنّها تنزع إلى إلغاء السلطة، بل إنها لا تركّز على الحكم السياسي على الصعيد البراغماتي. إنها تحيله إلى مرتبة أدنى في سُلّم قيمها الخلقية؛ فلا يؤدي سوى وظيفة ثانوية، مقارنةً بوظيفة الأعراف القبَلية وبفاعليتها المباشرة: ليست السياسة في التغريبة سوى عرض من أعراض الصراع من أجل البقاء”.
أخيرًا، في الفصل الثاني والثلاثين، “منعطف الأنثروبولوجيا التاريخية في المغارب: ‘المؤرخ ومساءلة المألوف'”، يتفحص عبد الواحد المكني أمثلةً تطبيقيةً خاصةً بتونس والجزائر والمغرب، قائلًا: “إننا بصدد تقاطعات عدة عرفتها أنماط كتابة تاريخ العرب بأقلام العرب؛ فعلى الرغم من التركيز على فضاء المغارب، يمكن سحب استنتاجات كثيرة على أنماط الكتابة التاريخية في المشرق. ومن خلال مبحث المنعطف الأنثروبولوجي، تحضر إشكالية التحقيب والمقارنة، وعلاقة المحلي بالمركزي والقطري بالقومي، وتحضر أيضًا الهواجس الإبيستمية وتجديد براديغمات وأمثولات البحث في الإنسانيات من خلال مساءلة المؤرخ للمألوف والثابت”.
(المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات)
للمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English