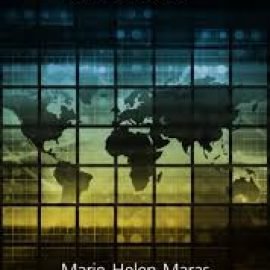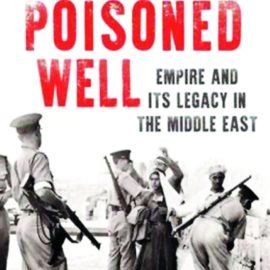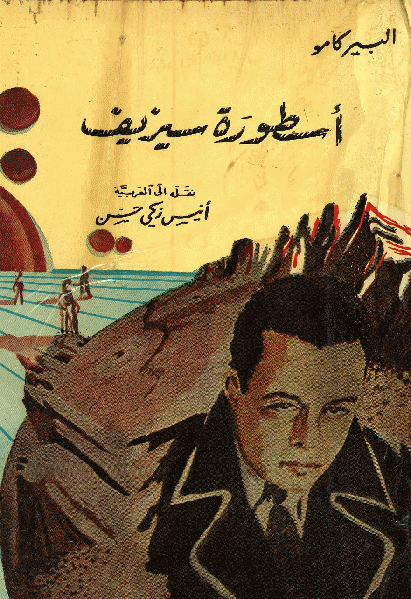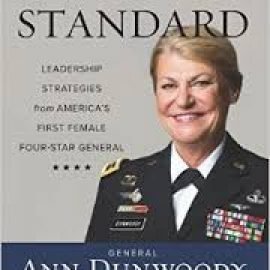الوصف
في كتاب “سؤال الأخلاق” للفيلسوف طه عبد الرحمن
وضع أركان “النظرية الأخلاقية الإسلامية”.. لحفظ الدين والدنيا معا
يقول أمير شعراء العربية أحمد شوقي: “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”. وذلك من افتراض أن الأخلاق هي التي تقي المجتمعات من مظان الشرور، وهي وحدها التي تجعل أفق الإنسان مستقلاً عن أفق البهيمية.
لكن الحداثة الغربية التي تتغلل مفاهيمها وتتوسع باضطراد في عقول البشر على طول العالم وعرضه، لم تأخذ تلك الفرضية الأخلاقية في حسبانها، ولم تعرها التفاتا، حيث طغى عليها مناهج التفكير المادي، وتمثل ذلك جليا في الحروب المدمرة التي شنتها دول الغرب الكبرى، والتي أفقرت وقتلت وشرّدت الملايين في كل أنحاء العالم، ودفعت قيم العدالة والتعاون والمساواة وغيرها من القيم النبيلة إلى خلفية الصورة.
من هنا يحاول الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه الذي بين أيدينا والمعنون “سؤال الأخلاق – مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية”، تقديم رؤية جديدة أمام هذا الفكر الغربي اللا أخلاقي، ناقدًا، ومكملاً للنواقص، وباحثًا عن الحلول، ورافضًا لمسلمات بُنيت على منطق معكوس، ضمن مشروعه الفكري الكبير لإحياء التراث الإسلامي العربي وتأسيس “الحداثة الإسلامية”.
عبد الرحمن أوضح في مقدمة الكتاب أن دعاة العقلانية من المحدثين التبس عليهم الأمر عندما ظنوا أن “العقلانية واحدة لا ثانية لها”، وأن الإنسان يختص بها بوجه لا يشاركه فيه غيره، بينما يرى المؤلف أن العقلانية على قسمين كبيرين، فهناك العقلانية المجرّدة من الأخلاقية، وهذه يشترك فيها الإنسان مع البهيمة، وهناك العقلانية المسدّدة بالأخلاقية وهي التي يختص بها البشر دون سواهم، مشيرًا إلى أن الخطأ الذي وقع فيه المحدثين أنهم حملوا العقلانية على المعنى الأول وخصوا بها الإنسان. والأخلاقية – من وجهة نظر عبد الرحمن- ينبغي أن تتجلى في كل فعل من الأفعال التي يأتيها الإنسان مهما كان متغلغلاً في التجريد، بل يجب أن تكون هذه الأفعال متساوية في نسبتها إلى تلك الأخلاقية، حتى أنه لا فرق في ذلك بين فعل تأملي مجرّد، وفعل سلوكي مجسد.
أما السبب في اضطراب المفاهيم الأخلاقية في عصرنا الراهن، وفق المؤلف، فهو أن الفلاسفة غلب عليهم الاشتغال بهذه المفاهيم من دون ردها إلى المجال الحقيقي الذي تنتسب إليه، بحيث بقيت في تعاملهم معها متزلزلة لا تثبت في معانيها، ومتأرجحة لا يستقر بها قرار، ومتذبذبة لا تقيم على حال.
سبيكة الأخلاق والدين
يبني عبد الرحمن مساهمته في نقد الحداثة الغربية من خلال الجمع بين الأخلاق والدين في سبيكة واحدة، جاعلاً منهما “أصل الأصول”، وهذا النقد يثير مشاعر الاستنكار في نفوس المقلدين من المفكرين الحداثيين العرب، لأنه يكشف تأثرهم وتبعيتهم ويعري تماهيهم مع الفكر الغربي.
الكتاب مقسم على ثمانية فصول، بدأها المؤلف بالبحث في مكارم الأخلاق وصلتها بالدين. موضحا أن الأخلاقيين من فلاسفة الغرب اتخذوا من الصلة بين الأخلاق والدين ثلاثة مواقف متباينة، فريق يرى أن الأخلاق تابعة للدين، وفريق ثان يعتبر أن الدين تابع للأخلاق، أما ثالث فيرى أنه لا واحد من الطرفين تابع للآخر.
الفريق الأول استند في اختياره إلى تقدم المبدأين التاليين على غيرهما، وهما “الإيمان بالله”، و”إرادة الإله”، بينما أخذ الفريق الثاني بمبدأ الفيلسوف عمانويل كانط في “الإرادة الخيرة”، فيما أخذ الفريق الثالث في إثبات اختياره بمبدأ الفيلسوف دافيد هيوم في أنه “لا وجوب من الوجود”.
هنا ينتقد عبد الرحمن الرأي القائل بتفرع الدين على الأخلاق، فهو يستبدل مقولات أخلاقية علمانية مكان المقولات الأخلاقية الدينية ويقيس الأحكام الأخلاقية العلمانية على الأحكام الأخلاقية الدينية، ويرى أن هذا الرأي هو ترجمة علمانية للرأي الذي يقول بتفرع الأخلاق عن الدين.
كما يوجه المؤلف انتقادين للرأي الثالث الذي يقول بانفصال الأخلاق عن الدين، فأحدهما أنه يعامل الشريعة الدينية معاملة النظرية العلمية، في حين أنه ينبغي أن تُعامل بوصفها مؤسسة، لا نظرية، وكل مؤسسة تنطوي على أحكام وجوب، بقدر ما تنطوي على أحكام وجود.
وأما الفريق الثاني فيستبعد تأثير الدين في الأخلاق، في حين أن الوعي بأن القيمة للقيمة الاخلاقية مصدر خاص في ذات الإنسان، إنما يرجع إلى تصريح النص الديني بذلك، كما أن الخبر في الدين لا يمكن أن يكون خبرًا صرفًا، بل إنه لا ينفك عن واحدة أو أكثر من القيم الأخلاقية.
وينهي المؤلف الفصل الأول من كتابه بإبطال بعض الأحكام السارية التي تضيق من الآفاق الواسعة للدين والأخلاق، فالدين في تقديره لا ينحصر في “شعائر ظاهرة لا معاني خفية تحتها بل إنه لا فائدة من وراء الإتيان بالشعيرة من دون تحصيل السلوك وفق المعنى الخفي الذي يكمن فيها”، كما أن الأخلاق من وجهة نظره لا تنحصر في أفعال كمالية، لا حرج في تركها بل هي أفعال ضرورية تختل حياة الإنسان بفقدها، ولا هي تنحصر في أفعال معدودة لا توسع معها، بل هي أفعال لا نهاية لها، وفيها يدرك اللا متناهي قبل أن يدرك في سواها.
دوام “الاشتغال بالله”
في الفصل الثاني المخصص لبحث روابط العقلانية بالأخلاق، يشير عبد الرحمن إلى أن العقلانية، بوجه عام، عبارة عن خاصية الفعل الإنساني الذي يقوم في طلب مقاصد معينة بوسائل معينة، وأن “العقلانية المجردة”، بوجه خاص، هي خاصية الفعل الإنساني الذي يقوم في السعي إلى تحقيق مقاصد لا يقين في نفعها بوسائل لا يقين في نجاعتها، ويرى أنها تخل بشرط النفع في المقاصد لوقوعها في النسبية والفوضى والاسترقاق، كما أنها تخل بشرط النجوع في الوسائل لإقصائها المعاني الروحية، واكتفائها بالظواهر الخارجية، واعتمادها للوسائط المادية وحدها.
أما “العقلانية المسددة”، فهي تقع في آفتين آفة التظاهر بأقسامه الثلاثة التكلف، والتزلف، والتصرف، وآفة التقليد بأقسامه الثلاثة التقليد الاتفاقي، والتقليد النظري، والتقليد العادي.
ويصل عبد الرحمن إلى “العقلانية المؤيدة” فيرى أنها عبارة عن خاصية الفعل الإنساني الذي يقوم في طلب تحقيق مقاصد نافعة بوسائل ناجعة، ولا يتم هذا الجمع بين نفع المقاصد في ثباتها وشموليتها وبين نجوع الوسائل في تغيرها وخصوصيتها إلا “بدوام الاشتغال بالله والتغلغل فيه”.
من ذلك يتضح لفيلسوفنا أن المتخلق بأخلاق الدين وحده هو الذي يحصل على رتبة العقلانية المسددة، ثم يرتقي منها إلى رتبة العقلانية المؤيدة، متى اتقى الآفات التي قد تدخل على عمله.
التجربة الخلقية المؤيدة
ينتقل الفيلسوف المغربي إلى الفصل الثالث حيث يؤكد أن “حضارة القول ظلمت الإنسان بترجيحها جانب القول على جانب الفعل”، موضحا أن “هذا الظلم اتخذ مظاهر تجلت في مضرات ثلاث أصابت الفعل الخلقي وهي التضييق من مجاله، وتجميد حاله، والتنقيص من شأنه”.
والمخرج من هذه المضرات الثلاث – حسب الكاتب- يتم بواسطة التجربة الخلقية التي هي من رتبة التأييد، مثبتًا هذه الدعوى من خلال بيان أن خصائص هذه التجربة الخلقية المؤيدة تفيد في دفع ضرر التضييق، لأنها تقوم على مبادئ توجب إيجاد الفعل الخلقي حيث يجوز وجوده، أو حيث لم يوجد من قبل كما توجب ترسيخ بنيته الداخلية، وتجعل الصبغة الخلقية ملابسة لكل فعل أياً كان.
ثم يبين لنا المؤلف كيف أن طرق هذه التجربة المؤيدة تنفع في دفع ضرر التجميد، لأنها تبني على مبادئ تلزم بالتعاطي الفعلي للتخلق مع التبصر بحكمته وماله، كما تلزم بالتخلق بأكمل الصفات حياة مع الاقتداء بأكمل نموذج حي متخلق بها.
ويوضح الكاتب أن نتائج هذه التجربة الخلقية العميقة تفيد في دفع ضرر التنقيص لأنها تكمن في تحصيل أسمى ما يسعى إليه المرء، وهو السعادة وفي تزويده بأوسع نظرة لإنسان وبأرق ذوق للجمال.
يغوص عبد الرحمن بعد ذلك في عمق الحضارة الغربية ويضع يديه على أزماتها ونقاط ضعفها، فيؤكد في الفصل الرابع أن هناك أزمتين شديدتين أصابتا نمط المعرفة في الحضارة الغربية الحديثة، وهما أزمة الصدق الناتجة عن فصل العلم عن الأخلاق، وأزمة القصد الناتجة عن فصل العقل عن الغيب، ويرى أن هاتين الأزمتين تجعلان من هذه الحضارة رغم أخذها بمبادئ منهجية تبدو في الظاهر ناجعة.
ولكن، ما نتيجة ذلك؟…
يجيب عبد الرحمن في الفصل الخامس من الكتاب على هذا السؤال موضحًا أن تلك المعطيات جعلت من هذه الحضارة الحديثة لا تسعى إلى التسلط على الطبيعة الخارجية فقط، جالبة لها من الضرر ما ليس في الحسبان، بل إنها أيضًا تتسلط على الطبيعية الإنسانية نفسها مغيرة خلقها وخُلقها.
النظرية الأخلاقية الإسلامية
يصل عبد الرحمن بتحليله المتدرج ومنطقه المتصاعد إلى حقيقة أن الأخلاق الإسلامية كفيلة بإعادة التوازن إلى العالم المعاصر، والتخلص من آفاته التي ساهمت في ظهورها الأفكار الحداثية المجردة عن الأخلاق، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم إلى وضع فلسفة أخلاقية إسلامية جديدة تجيب عن أسئلة السائل في العالم المنتظر.
ويجتهد المؤلف في استخراج بعض الأصول العامة التي يمكن أن تُبنى عليها هذه الفلسفة، منطلقًا من مسلمتين أساسيتين هما “لا إنسان بغير أخلاق، ولا أخلاق بغير دين” ليصل إلى نتيجة حاسمة وهي أنه “لا إنسان بغير دين”.
بعد ذلك يقوم فيلسوفنا باستخراج أركان ثلاثة للنظرية الأخلاقية الإسلامية، أولها: ركن الميثاق الأول الذي يتعلق بالجمع بين العقل والشرع، باعتبار أن الأخلاق الإسلامية أخلاق كونية لأنها أخلاق مؤسسة لا مجتثة، ومتعدية لا قاصرة، وشاملة لا محدودة، فتكون بذلك أوفق أخلاق للأفق العالمي للإنسان المنتظر.
والركن الثاني هو “شق الصدر”، وهو يتعلق بالجمع بين العقل والقلب، وقد تفرع عليه أن الأخلاق الإسلامية، أخلاق عميقة، لأنها أخلاق تطهير، لا تجميل، وتأهيل لا تثبيط، وتجديد لا تقليد وبهذا تكون “أوفى أخلاق”.
وثالث الأركان هو “تحويل القبلة”، الذي يتعلق بالجمع بين العقل والحس، وقد تفرع عنه أن الأخلاق الإسلامية أخلاق حركية، لأنها أخلاق شارة لا عبارة، وانفتاح لا انغلاق، واجتماع لا انقطاع، فتكون أقدر أخلاق على هداية الإنسان المنتظر.
وهنا يؤكد عبد الرحمن أن النظرية الأخلاقية الإسلامية ينبغي لها أن تأخذ بمبدأ مقتضاه أن الأخلاق الإسلامية أخلاق كونية، لا محلية وعميقة لا سطحية، وحركية لا سكونية، وكل أخلاق للإنسان تكون هذه هي سماته لا يمكن إلا أن تكون هي الأخلاق الحسنى.
والوصول إلى هذه الأخلاق لن يتم برأي عبد الرحمن إلا بفك الحصار عن الدعوة إلى عودة الإسلام، التي يصفها بأنها “عمل تنويري تحريري عام”، لكنه كما يؤكد في الفصل السابع عمل محاصر من الداخل ومن الذات، كما هو محاصر من الخارج أيضا، ولا طريق إلى رفع هذه المحاصرة المثلثة إلا بالتوسل بالأسباب التنويرية والتحريرية التي تُبنى عليها هذه الدعوة نفسها.
العطاء المغربي
ينهي عبد الرحمن كتابه بالفصل الثامن الذي خصصه لبيان الإسهام المغربي في التراث الإسلامي، مؤكدًا أن تنقل “أرباب السلوك” المغاربة إلى مصر في القرنين السادس والسابع كان تنقلاً مطلوبًا، كما كان تنقلاً مأذونا له، باعتبار شعور المغاربة بواجبهم نحو المسلمين عموما، والمصريون منهم خاصة.
والعطاء المغربي – من وجهة نظر عبد الرحمن- كان عطاءً تكامليًا تداوليًا تأنيسيًا، كما أن الخاصية التكاملية لهذا العطاء أفادت في محو التنافر بين التفقه والتخلق وإغناء مفهوم “الجهاد” في المجتمع المصري، وكيف أن الخاصية التداولية لهذا العطاء أفادت في محو آثار الحكمة العرفانية، وأثارت التخلق الفرداني في هذا المجتمع، وكيف أن الخصوصية التأنيسية للعطاء المغربي أفادت في إيقاف الحملات التبشيرية وإيقاف تأثير “المذهب الفاطمي” الشيعي في مصر.
ويدلل المؤلف على الدعوى التي قال بها، وهي أن العطاء المغربي الذي غلب على المصريين الاستمداد منه تعلق أساسًا بالعمل الخلقي الذي تميز به المغاربة. وإذا ثبتت هذه الدعوى ترتبت عليها مجموعة من النتائج، أولها أن أهل المغرب أمدوا المصريين بأفضل ما يميز الثقافة الإسلامية، مادام الإسلام هو عبارة عن مكارم الأخلاق.
والنتيجة الثانية أن المغاربة أمدوا المصريين بأخص ما يميز الثقافة الإنسانية، مادامت الأخلاقية هي المقوم الذاتي للإنسان وليست كما يظن “أرسطو” العقلانية المجردة، موضحا أن أصالة هذا العطاء المغربي يجب أن تُطلب في المنجزات الأخلاقية أكثر مما تُطلب في سواها من المجالات الثقافية الأخرى، مادام عطاء المغرب هو أبرز في جانب الأخلاق منه في أيّ جانب آخر.
والنتيجة الرابعة هي أن العطاء المغربي يحصل إحياؤه ويسهل استئنافه متى وقع تجديد الصلة بهذا الأصل الأخلاقي من أصول الثقافة المغربية، ومادامت أسباب الإبداع متوفرة في المجال الأخلاقي أكثر مما هي متوفرة في غيره من مجالات الثقافة المغربية
وفي الخاتمة يشير الفيلسوف المغربي إلى أن العمل الفكري في هذا الكتاب يتصف بخاصيتين اثنتين أساسيتين: إحداهما أنه عمل حداثي بموجب منطق الحداثيين، ذلك أن هؤلاء لا يسلمون بمفهوم “الحداثة” إلا باعتبار أن له أصلا في الحركة الأنوارية، وبالتالي الفلسفة الدينية على ما تقدم لم تبرز إلى حيز الوجود إلا في سياق هذه الحركة المجددة.
ويوضح الفيلسوف أن هذا يندرج في هذه الفلسفة الجديدة فيكون حداثيا مثلها، إلا أن الفرق بين طرحه وبين أطروحات هؤلاء الحداثيين هو أنه لم يقلد غيره كما يفعلون، مؤكدا أنه “صادف حداثته بموجب شعوره بحاجة المسلم المعاصر إلى فكر ديني متميز يناسب عصره”، وهو بذلك يكون قد أبدع حداثته الخاصة من منطلق إسلامي.
وإذا صح أن هذا العمل الفلسفي حداثي صريح، صح معه أيضا أن النقد الأخلاقي الذي جاء به لمفهوم “الحداثة” في مظاهر مختلفة منها يستوفي شرط المناسبة، ومقتضى هذا الشرط أن تكون الوسيلة من جنس الموضوع الذي يُتوسل بها إليه. أما الوسيلة الفلسفية التي استعملها في نقده هذا فهي تجانس الموضوع، فكلاهما معا ينتسب إلى الحداثة.
والخاصية الثانية لهذه المساهمة النقدية هي أنها عمل تجديدي بموجب منطق التقليديين، ذلك أن هؤلاء لا يقبلون وجود اجتهاد نظري في الدين يخرج عما ألفوه في باب الفقهيات أو الحديثيات. وإذا كان الكتاب يحمل صبغة فلسفية محورها الدين، فإن ذلك من شأنه أن يثير استنكار هؤلاء، خاصة أن الكتاب كما يقول مؤلفه “جاء بشيئين اثنين لا يتسع صدرهم لقبولهما”.
الأول هو تحديد مفهوم الدين تحديدًا لا يتفق مع مذهبهم فهم يجعلونه جملة شعائر جامدة. أما الثاني فهو اتباع منهج مخصوص لا يأخذون به فهم يعرضون أقوالهم في صورة تقريرات مفككة، يزينونها بشواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ويحشونها بأقوال بعض المفسرين أو المحدثين.
على عكس هؤلاء عرض عبد الرحمن أقواله في صورة استشكالات واستدلالات على طريقة الفلاسفة، مستوفيًا شرط ومقتضى العقلانية الحديثة من أجل تزويد الحقائق الدينية بفضاء فكري، يضاهي قوة وسعة الفضاء الفكري الذي وضع لحقائق غير دينية كالحقائق العلمية بما يسهم في حفظ الدين، لحفظ الدنيا.
في كتاب “سؤال الأخلاق” للفيلسوف طه عبد الرحمن
وضع أركان “النظرية الأخلاقية الإسلامية”.. لحفظ الدين والدنيا معا
للمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية
 العربية
العربية  English
English