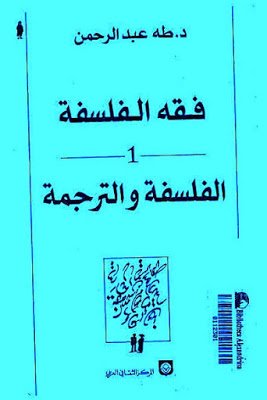الوصف
فقه الفلسفة 1 الفلسفة والترجمة
لمّا كانت قضية “غياب الإبداع” عن الفلسفة العربية إحدى أهم القضايا التي شغلت بال الأكاديمي المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، كان طبيعيًا أن يتولى الرجل البحث عن تلك الأسباب التي أعاقت ظهور الإبداع في التفلسف العربي، بشكل علمي يطرح الإشكالية وحلولها، خصوصًا أن الفلسفة العربية اعتمدت على النص المنقول، لاسيما من التراث اليوناني، فيما غاب الإبداع كليًا عنها، بشكل أصبح يدفع للتساؤل عن الأسباب التي غيّبت هذا الإبداع، وأعاقت ظهوره، وجعلت من الفلسفة العربية مجرد “نصوص مترجمة” عن لغات غربية بالأساس.
وفي كتابه “فقه الفلسفة 1 – الفلسفة والترجمة”، يجتهد عبد الرحمن في تحديد الأسباب التي أعاقت “المتفلسف العربي” عن إبداع فلسفته الخاصة، وكذلك الأخطاء التي وقع فيها، خاصًة فيما يتعلق بترجمة النصوص الفلسفية الغربية، مبينًا الطريق السليم نحو ترجمة محفزة للإبداع وقادرة على التغيير، واضعًا محفزات إبداع لعملية التفلسف العربي المعاصر.
“فقه الفلسفة”
يضع عبد الرحمن لكتابه مدخلًا عامًا لتوضيح “ما الفلسفة؟”، معتبرًا أن التناقضات التي وقعت فيها الفلسفة المحددة بالتساؤل ليست في الواقع إلاّ حصيلة إدماج ما هو غير فلسفي فيما هو فلسفي، ومداومة التقلب بين هذين الطرفين من غير مراعاة لمقتضيات تفاوتهما”.
ويؤكد الفيلسوف في مدخل الكتاب أن “ما الفلسفة” هو سؤال علمي وليس فلسفيًا، فهو يحيط بموضوع الفلسفة إحاطة لا تبقي شيئًا منه خارج هذا السؤال، مشيرا – في نفس الوقت- إلى أنه “لا يمكن أن يحيط بتمام الشيء إلا ما ليس منه، وإلا كان هو أيضًا مُحاطا به”، ليصل بذلك إلى نتيجة مؤداها أن “الفلسفة لا يحيط بها إلا غيرها”.
وإزاء ذلك، يتوّجب وضع أصول هذا العلم المحيط بالفلسفة بحيث يتولى دراستها بوصفها جملة من الظواهر التي لها خصائصها وقوانينها الذاتية، مثلها في ذلك مثل الظواهر الإنسانية الأخرى التي ينظر فيها الفيلسوف طلبًا لاستخراج أوصافها وأحكامها، عبر إجراءات منهجية محددة ونظريات علمية مقررة.
وهذا العلم الجديد الذي يختص بالنظر في الظواهر الفلسفية أطلق عليه المؤلف اسم “فقه الفلسفة”، قياسًا على مصطلح “فقه اللغة” المتداول. وهو يوضح في مقدمة كتابه أن “هذا العلم يزودنا بالمعرفة من خلال دقيق آليات الممارسة الفلسفية، والإحاطة بجليل تقنيات الانتاج والإبداع فيها بما يمكن من الارتقاء من رتبة استعمال الفلسفة إلى رتبة صنعها”.
ويقسّم عبد الرحمن كتابه إلى أربعة أبواب موزعة على عدد من الفصول، خصص الباب الأول منها للحديث عن إشكالية الصلة بين الفسفة والترجمة، مبينًا في الفصل الأول من هذا الباب أن “الآثار الدينية المسيحية هيمنت على ممارسة الترجمة، وكانت وراء سلوكها طرقًا مخصوصة”، وأن هذه الآثار انتقلت إلى المتلقي العربي مع قدماء المترجمين من السريان المسيحيين.
ويوضح العلاّمة المغربي في هذا الفصل أن الفلسفة أغفلت جانب الخطاب في تشكيل الممارسة الفكرية، فنزعت عن معانيها صورها اللفظية، وعن حقائقها صيغتها التركيبية، كما يوضح أن “طلب الترجمة للغة كلية سواء في صورة لغة خالصة أو لغة جامعة لا يفيدها في الخروج من الخصوصية الملازمة لها”.. ولكن لماذا؟
يجيب الكاتب على ذلك بأن “السبب هو أن هذا الطلب جاء نتيجة تأمل فلسفي، وليس حصيلة لعمل الترجمة، فضلًا عن أنه لا يثمر بدوره إلا مزيدًا من التدين كما في القول باللغة الخالصة، أو مزيدًا من الابتزال كما في القول باللغة الجامعة، مما لا مفر معه للترجمة من أن تخالف المقتضى الشمولي الذي تقوم عليه الفلسفة”.
ويؤكد فيلسوفنا أن الترجمة في المجال التداولي الاسلامي العربي أصل، والفلسفة تابع لها، وأن الترجمة لم تستطع عبر أطوارها الثلاثة “الابتداء والاستصلاح والاستئناف” أن تمد الفلسفة العربية بالأسباب التي تجعلها تستقل بنفسها، وتأتي بالجديد الذي لم يسبقها إليها أحد، ولا استطاعت أن تجعل هذا الاستقلال وهذا التجديد ممكنين ولا محفوظين في ظل مواصلة العمل الترجمي.
الشموليات الفلسفية الأربع
في الفصل الثاني من الباب الأول يؤكد عبد الرحمن بطلان ما ذهب إليه بعض المؤرخين، من كون الفلسفة الترجمية تشكل تحولاً في المسار الفلسفي تحولاً بلغ درجة إحداث انقطاع بين طورها الخاص والأطوار السابقة من هذا المسار.
ويتبيّن لفيلسوفنا أن هذا الانقطاع على تقدير إمكان حدوثه في مجال الخطاب الفلسفي لم يكن حقًا من نصيبها، وإنما كل صنيعها ينحصر في “انعطاف محدود” لم يستطع أن يضاهي الانعطاف التحليلي لظهور تفرعه منه.
وتجاه ذلك، يلزم التسليم بأن اتجاه الفلسفة الترجمية اتجاه ينخرط في الفلسفة التقليدية، كما ينخرط فيها اتجاه الفلسفة التحليلية، فتكون المفاهيم الفلسفية التي توسل بها في المراجعة الفلسفية للترجمة من جنس المفاهيم التي تداولها الفكر الفلسفي التقليدي، في هذا الطور أو ذاك من سالف أطواره.
ويصل المؤلف إلى الباب الثاني، والذي خصصه لرفع التعارض بين الفلسفة والترجمة، فيتناول في الفصل الأول من هذه الباب أنواع الشموليات الفلسفية الأربع، وهي “الشمولية العامة، والشمولية العالمية، والشمولية الجامعة، والشمولية النموذجية”.
ويشير الفيلسوف إلى أن “الشمولية النموذجية” تُبنى على مطلق الانطباق على الأشياء من غير وجوب الاستغراق لها، كما تُبنى على مطلق الاستعمال من لدّن الناطقين من غير وجوب الاحاطة بهم، وذلك لاستنادها إلى “الشواهد المُثلى” التي هي بمثابة عناصر دلالية أو استعمالية أكثر تلبسًا من غيرها بالقيم المعرفية المقررة، بحيث يفضي نهوضها بالانطباق الدلالي وبالاستعمال الخطابي إلى سقوط واجب طلبهما في غيرها من العناصر.
كما يوضح عبد الرحمن في هذا الفصل أنواع النسبية، وأهمها – في تقديره- النسبية اللغوية التي تنقسم إلى نسبية منغلقة ونسبية منفتحة، وأن النسبية اللغوية المنفتحة تُبنى على مبدأ الائتلاف الحافظ للفروق. فإذا قام بالفلسفة وصف” الشمولية النموذجية” التي تقدم التشخيص الأمثل على التعميم المجرد وقام باللغة وصف النسبية المنفتحة التي تقدم التماثل الموسع على الخصوصية المضيقة، صار بالإمكان عندئذ التوفيق بين الفلسفة والترجمة.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فيخصصه المؤلف للحديث عن “المعنوية الفلسفية”، مبيّنًا أنها “ليست معنوية تجريدية، إلا أن يكون المراد من التجريد هنا هو المعنى الذي يلزم عن الحقيقة القصدية، وهي حقيقة لا وجود ظاهرًا لأفرادها، وفي حالة راعت هذه المعنوية المقصد يجوز القول بأن المعنوية الفلسفية هي معنوية مقصدية”.
ويلفت عبد الرحمن، في هذا الفصل، إلى أنه “ما دامت هذه المعنوية ذات طبيعة قصدية، فإنها توجب وجود اللفظ، كما توجب وجود المتكلم. وحيث أن معنوية الفلسفة هي معنوية قصدية، فهي أيضا معنوية لفظية، وبذلك تقوم بالمقتضى الذي يجعلها توافق الترجمة، فكلاهما لفظي، بحيث لا تعارض بين الترجمة والفلسفة التي تأخذ بأسباب المعنوية القصدية”.
وفي الفصل الثالث، ينبّه العلامة المغربي إلى ضرورة مراجعة الخاصية العقلانية للفلسفة، قدر مراجعة الخاصية الشمولية والخاصية المعنوية. فكما أن الفلسفة الحية توجب علينا الخروج من الشمولية الجامعة إلى الشمولية النموذجية، ومن المعنوية التجريدية إلى المعنوية القصدية، فإنها توجب علينا أيضًا الخروج من العقلانية الضيّقة التي تبنى على النقد المجرّد والبرهان المضيّق، إلى عقلانية متسعة تأخذ بالنقد المستند والبرهان الموسع”.
ولا يعترف الكاتب بمبدأ “إلزامية الفلسفة المنقولة” الذي يقضي بسلامة ونفع الفلسفة المنقولة دون غيرها، مبيّنًا في الفصل الرابع أنه “منقوض” من وجهين أساسيين، أولهما جواز وجود معرفة على غير مقتضى الفلسفة المنقولة، فقد اتضح أن هذه الفلسفة لا تستقل بمجموع مجالات المعرفة، ولا تتفرد بتحصيل أسمى درجات الوعي.
والوجه الثاني هو جواز وجود فلسفة على غير مقتضى الفلسفة المنقولة، فقد تبيّن أن هذه الفلسفة لا تشتمل على مجموع المعاني الفلسفية، ولا تتضمن كل الطرق الممكنة للتعامل مع المعاني الفلسفية، ولا حتى تضبط المواضع التي يجب أن تُستعمل فيها الطرق التي تضمنتها.
ويُبطل عبد الرحمن في هذا الفصل المبدأين الذين ترجع إليهما أسباب تبعية الفلسفة العربية للترجمة، وهما مبدأ “الإطلاقية” الذي يوجب التسليم باستقلال الفلسفة المنقولة بكل مجالات المعرفة الانسانية، ومبدأ “الإلزامية” الذي يوجب القول بالاضطرار إلى الفلسفة المنقولة في العلم بأي مجال من مجالات المعرفة.
كما يثبت المؤلف في هذا الفصل صحة مبدأين مقابلين، وهما مبدأ النسبية المحدودة للأصول الفلسفية الذي يقضي باختلاف واستغناء بعض الأصول الفلسفية، ومبدأ الاشتراك المحدود للفروع الفلسفية الذي يقضي باتفاق وافتقار بعض الفروع الفلسفية. وقد استثمر الكاتب المبدأ الأول في بيان وجوب الاستقلال عن الترجمة في الأصول الفلسفية، والمبدأ الثاني في بيان جواز التبعية للترجمة في الفروع الفلسفية.
الترجمة المحفزة للإبداع
ينتقل عبد الرحمن إلى الباب الثالث الذي خصصه للحديث عن النموذج النظري للترجمة العربية للنص الفلسفي، فتناول في الفصل الأول الترجمة التحصيلية، فبيّن أنها “اهتمت بنقل النص الأصلي متجاهلة كل الصفات التي من شأنها أن تجعل الفلسفة فكرًا حيًا متوافقا مع مقتضيات الترجمة، ما يؤدي إلى وقوعها في آفة التطويل، بسبب ما يتطرق إلي عباراتها من سوء في التركيب وحشو في المضمون”.
أما “الترجمة التوصيلية”، فيخصص لها المؤلف الفصل الثاني، مبيّنًا أنها “وإن اجتهدت في تجنب المخالفة العقدية واللغوية الصريحة لأصول المجال التداولي للمتلقي، فإنها تبقى متمسكة بنقل كل المضامين المعرفية التي يحملها الخطاب الفلسفي ولو خالفت المقتضيات المعرفية لهذا المجال، أو كان يجوز استغناؤه عنها كلًا أو بعضًا، كما أنها تهمل العمل ببعض الصفات التي تسهم في إحياء التفلسف بما يجعله موافقا لمقتضى الترجمة مما يؤدي إلى وقوعها في آفة التهويل”.
ويشدد عبد الرحمن في الفصل الثالث على أنه “لا سبيل للخروج في الترجمة العربية للفلسفة من آفتي تبديد الجهد وتبذير الوقت، إلا بسلوك طريق الاختصار فيها، فقد ظهر أنه هو وحده الطريق النقلي الذي يناسب أخص خصائص اللسان العربي، وهي الجمع بين الخاصية التلخيصية، والخاصية التقابلية، والخاصية العملية”.
إن الترجمة التأصيلية – من وجهة عبد الرحمن- فضلا عن الزيادة في حفظ قواعد اللغة وأركان العقيدة، تتوليان استيفاء المقتضيات المعرفية للمجال التداولي المنقول إليه هذه المقتضيات التي تركت الترجمة التوصيلية العمل بها، بحجة أنه لا اختلاف في المعارف بين الثقافات القومية والمجالات التداولية، ولم تتأت للترجمة التأصيلية هذه المراعاة الشاملة للأصول اللغوية والعقدية والمعرفية للمتلقي إلا بالدخول في تحويل المنقول بالقدر الذي يحقق القيام بالموجبات التداولية لهذه الأصول، ولو بلغ هذا التحويل حد إخراج هذا المنقول عن صفاته الأصلية، وجعله يتصف بما قد يعارضها حتى كأنه مأصول غير منقول.
ويؤكد فيلسوفنا أن “الترجمة التأصيلية أقدر من سواها على النهوض بعبء التفلسف الحي، الذي منه وحده يأتي الانتاج الفكري القادر حقًا على الإثمار، كما يأتي منه الإبداع الفلسفي القادر حقًا على التغيير”.
وفي الباب الرابع والأخير من الكتاب، يتحدث الأكاديمي المغربي المرموق عن النموذج التطبيقي للترجمة العربية للنص الفلسفي، فيتناول في الفصل الأول منه أحد الأمثلة للترجمة التحصيلية، وهي ترجمة “الكوجيطو” الديكارتي، مبيّنًا مكامن الخلل في هذه الترجمة ووقوعها في آفة التطويل.
وأخيرًا، ينتقل فيلسوفنا إلى الترجمة التوصيلية لـ”الكوجيطو” الديكارتي، والتي وقعت في آفة التهويل، ثم يعرض بعد ذلك الترجمة التأصيلية في الفصل الثالث من هذا الباب لنفس النص، ليبيّن كيف أنها تستلزم القينفين من المقتضيات المنهجية، أحدهما مقتضيات متعلقة بالاختيار، والثاني مقتضيات متعلقة بالاختبار، وهكذا تكون الترجمة التأصيلية مُحفزة للإبداع وقادرة على إحداث التغيير المطلوب.
فقه الفلسفة 1 الفلسفة والترجمة
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English