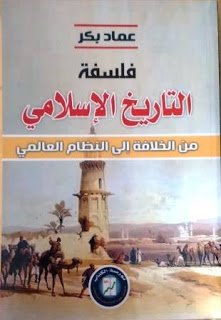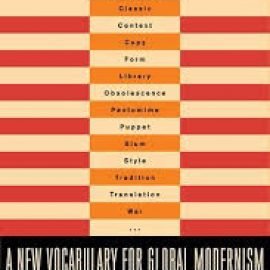الوصف
كتاب جديد يجيب عن السؤال المصيري في التاريخ الإسلامي
كيف أوقفت عقدة “الجزر المنعزلة” تقدم المسلمين؟!
في كتابه “فلسفة التاريخ الإسلامي.. من الخلافة إلى النظام العالمي”، يكشف الباحث عماد بكر عن “العقدة التاريخية” للمسلمين، أو ما يسميه عقدة “الجزر المنعزلة” التي أوقفت نمو وتقدم العالم الإسلامي وجعلت منه، حسب تعبير المؤلف، “جثة هامدة” ليس لها فعل في التاريخ، بل مجرد موضوع للفعل التاريخي، بعد أن تحولت العقيدة إلى “علم كلام”، وأصبح “علم الفعل” في يد السياسة وحدها، ومن ثم جرى فقدان الشرعية السياسية تماما، وسادت فكرة “السلطان المتغلب” الذي يستطيع باستخدام قوة السلاح إخماد أي معارضة له، ثم جرى تصدير هذا الفكر للمجتمع على شكل عنف واستبعاد للآخر وتكفير له على مدى قرون من الزمان استمرت حتى عصرنا الراهن.
وفلسفة التاريخ، بالمعنى العام، من حيث هي نظرة شمولية إلى التاريخ في حاضره وماضيه ومستقبله، تحتاج إلى إعطاء معنى للتأريخ والنظر إليه نظرة كلية نسبياً.
ولا جدال أن الوعي بالتاريخ من أبواب صناعة التاريخ، الذي اختلط أحيانا بالإضافات والأساطير والتحريف، وقلّ استخراج العبر منه ومن القوانين التي تحكمه، مما أدى إلى تكرار نفس الأخطاء والممارسات، وغلب على صناعته الأشخاص من أولي العزم الشديد الذين اهتموا بالتجييش والحشد لعواطف الجماهير دون الاهتمام بالجانب الأخلاقي والإنساني في بناء وعي العامة.
بهذا المعنى الشمولي، يناقش هذا الكتاب، صغير الحجم كبير القيمة، حالة الفكر الإسلامي وتطوره منذ نشأة الإسلام حتى يومنا هذا، ويقدم طرحا جديدا أساسه أن العالم الإسلامي مازال يعيش ويتخبط في “عصور الظلام”، وأنه – وفق المؤلف- بحاجة ملحة للانتقال إلى العصر الحديث، من خلال خطاب ديني جديد تماما يرجع إلى الأصول ويتجنب الأخطاء التاريخية.
ويتضمن “الخطاب الديني الجديد” الذي يدعو إليه المؤلف، ربط الدين بالسلوك، وتوحيد الشريعة والقانون في سياق دستور وقانون ملزم لجميع المواطنين، وتوحيد الزكاة والضريبة في إطار دولة تحترم المواطنة ولا تحاسب المواطنين على الكفر ولا تكافئهم على الإيمان، ثم ربط الدين بالدولة في نسق متكامل يحل إشكالية التناقض بين الدين والسياسية.
بدأت بذور “العقدة التاريخية”، حسب الكاتب، في وقت مبكر من تاريخ الإسلام، وأطلق المؤرخون عليها اسم “الفتنة”، وكانت هذه الفتنة في الأساس هي صراع على السلطة، وانقسم الناس فيها إلى ثلاث مجموعات: مجموعة اعتزلت كل الصراعات، أي بقيت على الحياد، أما المجموعتان الباقيتان فكانت واحدة منهما نصيرا لأحد طرفي الفتنة “علي” و”معاوية”.
ويضيف الكاتب إلى ذلك فتنة “خلق القرآن” التي بدأها الخليفة العباسي “المأمون” عام 212 ه، وكانت برأيه الحدث الأكبر أثرا في التاريخ الإسلامي، معتبرا أن الناتج السياسي من هذه الفتنة كان “تكريس الديكتاتورية” وسيادة الرأي الواحد وعدم قبول الآخر، بل إنه يمكن افتراض وجود تصور سياسي عند العباسيين بتصفية المجتمع المدني، بالتعبير المستحدث، في ذلك العصر، الذي كان الخليفة يراه – أي ذلك المجتمع- تقويضا لسلطانه المطلق.
وبخلاف الرأي السائد أن فتنة خلق القرآن كانت من أخطاء المعتزلة، وأنهم دفعوا ثمن هذا الخطأ (…) يرى الباحث أن الأمر أكبر من ذلك بكثير، فبحساب النتيجة السياسية لهذه الفتنة التي استغرقت قرابة نصف قرن، نرى أن التأثير السلبي لها لم يشمل المعتزلة فقط، بل تعداهم وطال أهل الحديث بالقدر نفسه، فلم نر أو نسمع شيئا عن نقد المتن عندهم” بعد هذه الفتنة.
وعلى الرغم من القيود الشديدة على الحرية وعلى الفكر في عهد الخلفاء العباسيين، وتحول العقيدة إلى “مجرد كلام” لا يتبعه أي تطبيق عملي، ورغم توقف السنة النبوية عند حدود الرواية فحسب، وخضوع الفقهاء لسياسة “الترغيب والترهيب” من قبل السلطة الحاكمة، فإن هذه المرحلة تعد – في رأي الكاتب- هي الأفضل في التاريخ الإسلامي منذ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا، حيث ما زلنا نطلق عليها مسمى “العهد الذهبي”، فالأسوأ سيبدأ عند رأس السنة المائة الثالثة الهجرية، حين افتتح “المأمون” فتنة خلق القرآن التي تعد الفتنة الأكثر تأثيرا بعد فتنة الحروب الأهلية بين “علي ومعاوية”، سالفة الذكر.
ويعتبر المؤلف أن “عقدتنا التاريخية” هذه قد تبلورت خلال مدة زمنية تصل إلى نصف قرن من الزمان، ويفترض أن المحرك الأول لها كان سياسيا من أعلى قمة الهرم، لكن التنفيذ تم على يد المجتمع المدني بطرفيه في ذلك الوقت، وهما المعتزلة وأهل الحديث، وترتبت على ذلك تأثيرات سلبية تكونت داخل الأفراد ومازالت تعمل بكامل طاقتها حتى يومنا هذا.
بدأت “العقدة” كما يقول الكاتب، بفصل الدين عن الدولة من خلال منتج تم تسميته “علم الكلام”، يناقش موضوعات العقيدة، على أن تكون السياسة هي “علم الفعل”، وعلى الرغم من أن المجتمع المدني كان مكبلا إلا أنه حقق نهضة كبيرة على المستوى الحضاري.
ولكن، أدت عقدة “الجزر المنعزلة” تلك إلى ضعف التواصل والترابط والثقة بين أفراد المجتمع الإسلامي، لدرجة جعلت كل فرد مثل “جزيرة” في حد ذاته، منعزلا عن الآخرين، ومن ثم تشكلت داخل المجتمع أول عصابة بالمعطيات الجديدة، ثم زاد عدد العصابات ليشمل كل التخصصات ومجالات الحياة كافة، وفقدت العلوم والتخصصات قيمتها في خدمة المجتمع الإسلامي، وأصبح كل مجال مملوكا لعصابة ما، وكان يحدث أحيانا أن تتم الثورة على عصابة لتحل محلها أخرى، لا تقدم بدورها شيئا لهذا المجتمع، وإنما تقدم لنفسها كل ما كانت تطمح إليه من بسط سيطرتها، وظل الحال كذلك حتى الآن.
لتدعيم نظريته يرجع المؤلف قليلا إلى الوراء، وتحديدا إلى القرن الهجري الأول الذي تشكّلت فيه الفرق الإسلامية الكبرى، مثل الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة والجبرية وأهل السنة والجماعة، وكانت نشأة هذه الفرق نتيجة لصراع سياسي داخل المجتمع في المقام الأول.
ويمكن تحسّس هذا الصراع السياسي المكبوت والمستتر، خلف رداء الخطاب الديني من نشأة فرقة المعتزلة، وهي حادثة مشهورة، حينما سأل أحد الأشخاص الحسن البصري (ت 110 ه) عن حكم مرتكب الكبيرة، هل هو مؤمن أم كافر؟ وقبل أن يجيب البصري، قام تلميذه واصل بن عطاء بالإجابة، وقال بأن مرتكب الكبيرة “في منزلة بين المنزلتين” فلا هو مؤمن محض ولا هو كافر محض.
ويؤكد الباحث أن قضية “مرتكب الكبيرة” هذه، لم تكن قضية هامشية أو سطحية أو من قبيل الترف الفكري والعقلي كما يقول البعض، بل كانت بمنزلة “تأنيب الضمير” في المجتمع الإسلامي آنذاك، فمن الواضح من الواقع الاجتماعي في تلك الفترة أن السؤال لم يكن سؤالا عابرا، بل كان سؤالا مُلحا يُطرح كثيرا وقتها، إن لم يكن بشكل واضح في صورة حوار سياسي، فربما كان يُطرح في الأسرة أو بين الأصدقاء بصيغة أوضح، لأن الخوف كان يمنع من طرح السؤال في شكله السياسي، تم تغليفه بغلاف ديني.
ولم يكن طرح السؤال حول حكم مرتكب الكبيرة ممكنا على الصعيد السياسي، فقد كانت “الكبيرة” المقصودة هنا تنطبق أكثر ما تنطبق على الصراع الدموي الجاري والقتل بسبب الخلافات السياسية، حيث كانت عاقبة السؤال تؤدي إلى القتل أيضا، وبالتالي تم نقل دائرة الصراع من مجال السياسة إلى مجال التدين.
فلسفة التاريخ الإسلامي كما يطرحها المؤلف تعني البحث عن المشروع الحضاري الإسلامي، الذي ينادي به الكثيرون كل من واقع تحولاته الفكرية، وارتباطه بالمبنى الديني والفكري في واقعنا المعاصر، وهو ما يتطلب أن يضع الخطاب الإسلامي المعاصر قضية إصلاح مناهج الفكر وتجديد الخطاب الديني في موضعها الملائم، ومنحها الأولوية وإعطائها السبق، باعتبارها القضية الأهم، والمفتاح الأساسي، والأرضية التي لا بد أن ينطلق منها أي مشروع فكري حضاري، فبإصلاح مناهج التفكير، أي نفض الغبار التراكمي عن العقلية الإسلامية التي أصابها الوهن، يمكن إيجاد الحلول المنطقية لكثير من جوانب الأزمة الراهنة.
ولذلك، لابد من قراءة التاريخ بمعايير موضوعية والتأشير على نقاط قوته وضعفه، والتفكير في حلول جديدة لقضايا العصر بعيداً عن التقوقع والتعصب والحزازات والمصالح الضيقة. حتى يستطيع العالم الإسلامي الخروج من “عقدة الجزر”، والتخلص من حالة الركود التي يعيشها منذ أكثر من 1000 عام.
للمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English