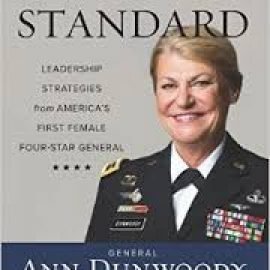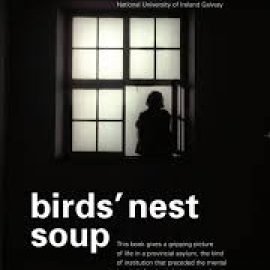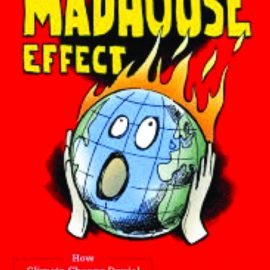الوصف
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
قليلة ونادرة هي الكتب العربية التي تناولت موضوعاتها الهويّات الطائفية في سورية، على الرغم مما تمثله سورية من واقعٍ ثري جعل من نفسه قبلة للباحثين والمهتمين بهذا الشأن من شتى أنحاء العالم. ولم تسلط تلك الكتب النادرة الضوء على الهويات الطائفية ببعدها الحيوي (ماهيتها- تأثرها وتأثيرها- خصوصيتها- علاقتها وعلائقيتها بالطوائف الأخرى، إلخ)، بل اقتصرت على تناول تاريخيتها ومرجعياتها الدينية. وفي أحسن الأحوال مرت على وضعها ضمن مرحلة سياسية ما مرورًا توصيفيًا فقط.
الكتاب “المترجم إلى العربية” الذي نحن بصدده الآن، يقدم محتوى معرفيًا غنيًا عن الطائفة العلوية، إن الغنى المُقدم لا يأتي فقط من كونه يغطي معلومات وحقائق ووقائع وآراء جديدة، بل من الخوض في “الممنوع” الذي ألفه السوريون، وفي الكشف عن جوانب مهمة من الخصوصية المجتمعية للطائفة العلوية، كالخصوصية التي تمتلك كل طائفة أو أقلية نصيبًا منها التي جرى التكتم عليها إما خوفًا من “الآخر” أو سبيلًا من سبل مقاومة الفناء أو بغية استثمارها سياسيًا. ويتجلى غنى الكتاب أيضًا في البحث في المآلات الممكنة والاحتمالات الواردة لهذه الهويّات الطائفية الأقلياتية في سورية وتأثيرها في سورية عمومًا. فالكتاب يبيّن خطر جهل كل طائفة بأخرى وانعكاسات ذلك في بنيتها أو هويتها بكونها معوقًا من معوقات تشكل الهوية الوطنية السورية.
لم يتطرق الكاتب “تورشتين وورن” إلى الطائفة العلوية بوصفها مذهبًا أو ملّة، أي إنه لم يناقشها ببعدها الديني فقط، بعكس الكتابات معظمها التي تناولت العلويين، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فتطرق إلى كيف يرى العلويون “الآخر” السني أو الدرزي أو المسيحي، وكيف بنوا هويتهم تبعًا لهذا “الآخر”، كيف تعامل حافظ الأسد مع الطوائف في سورية؟ وكيف عززت “علمانية” النظام تقوقع الطوائف على ذواتها، بل طرح سؤالًا في غاية الأهمية: هل نظام الأسد علويًا؟. هذا كله وغيره، يجعلنا نقرأ عن العلويين بوصفهم “نموذجًا” للهويات الطائفية الأقلياتية الأخرى، فالتعميم الحذر هنا وارد، حال صرف النظر عن الجانب الديني ومسمياته لهذه الأقليات الطائفية، وتناولها فقط ضمن سياقها التاريخي والمجتمعي والسياسي. ليظهر لنا أن ما ينطبق على العلويين -هنا- يندرج على الأقليات الدينية والأقوامية الأخرى.
تبقى مسألة الهوية الوطنية هي “أم المسائل” في سورية وغيرها من البلدان العربية، وقد عانت المنطقة العربية ما عانته عقودًا طويلة بسبب غيابها، وما واقع الأقليات الهوياتية -دينية أو أقوامية- إلا جزء من هذه المسألة/ الأزمة. ولكون الإنسان عدو ما يجهله؛ فإن ألف باء الخروج من تيه الانغلاق والخوف من “الآخر” هو معرفته، بدل تأليف الأساطير حوله، هو معرفته معرفة متبادلة؛ أن نعرفـ”ه” ويعرفـ”نا”. لنعي جميعًا في النهاية ذاتَنا الجمعية. فالاستعمار والاستبداد اللذان لم تعرف سورية غيرهما في تاريخها الحديث؛ جهدا واستثمرا في “لعبة الأقليات والأكثرية”، وحالا دون إذابتها في هوية وطنية، بل على العكس من ذلك، فبذريعة هذه “اللعبة” أُنشئت “دول”، ووضع لها كلاب حراسة حرصت على مدى عقود على توسيع الهوة ما بين “مكوناتها”، ورسخت الكره والخوف في ما بينهم، حتى تجاوزت تلك الممارسات بوصفها “أدوات ووسائل سلطة” واقعها، وأمست ثقافة مجتمعية، ليس من اليسير تجاوزها.
أظن أن تناول طائفة ما في سورية، “كما يتضح من خلال هذا الكتاب” هو تناول للطوائف كلها بطريقة أو بأخرى، فبعيدًا من السرد التاريخي لتشكل الهويات وخصوصية المعتقد، يتجلى الوضع العام للناس في سورية من خلال نظرة ورؤى وطرائق وأساليب تعامل هذه الطوائف في ما بينها، مع تداخلاتها سياسيًا واجتماعيًا. فحين يقول الكاتب على سبيل المثال: “السوريون يتظاهرون معظم الوقت بما لا يبطنون” فهذا لا يخص طائفة بعينها، بل هو أثر وانعكاس ثقافة رؤية السوريين لهذا الآخر. وحين يجري تناول “الحدود الصارمة بين الطوائف” فإننا هنا أمام مكر طغمة حاكمة راق لها هذا الواقع وكرّسته لترسيخ سلطتها “فسورية بلد رقابة مشددة يعد فيها طرح المسائل الطائفية طرحًا تقسيميًا مدمرًا للنسيج الاجتماعي”، وهذا لم يتأتَّ إلا من زاوية إبقاء الخوف كامنًا ما بين الطوائف، وعدم إتاحة الفرصة لانفتاحها على بعضها، وقد ألبس الأسد هذه الممارسات والمنهجيات لبوسات مختلفة “الحفاظ على الوحدة الوطنية، لا هوية في سورية سوى الهوية العربية السورية، الانتماء الوطني هو السائد، إلخ” وليبقى الهدف من ذلك هو التفرد بالحكم من الأسد خيارًا وحيدًا و”آمنًا”، فتهمة “إثارة النعرات الطائفية” هي التي تسببت بسجن عدد من معارضيه من الطوائف كلها ومنهم العلويين.
في مقدمة الطبعة العربية خوف دفين من الآخر حوّل الإنسان إلى حيوان، كانت زيارة الكاتب الأولى إلى سورية عام 2002 وشعر بأن أهلها أكثر انفتاحًا وتسامحًا، وبعد زيارات متتالية ومع تحسّن قدراته على التحدث باللغة العربية؛ أدرك الكاتب وجود نزعة مختلفة وراء هذا الانفتاح وذاك التسامح، أثار هذا التناقض اهتمامه، فقد بدا له محفوفًا بالخطر. فكأن الناس يتظاهرون معظم الوقت بما لا يُبطنون.
أكثر ما واجه الكاتب هو الحديث عن مزيات العلويين وهيمنتهم، أما العلويون الذين التقى بهم سواء في قرى الجبال الساحلية أم في ضواحي دمشق، لم يكونوا على الإطلاق في مثل هذه الحال، وتحدثوا عن كونهم محض ضحايا مثلهم مثل الجميع.
عندما فتّش الكاتب عن أدبيات تتناول العلويين لم يعثر إلا على ما يتعلق بالطقوس والمعتقدات وكانت كتابات لا موضوعية. ومن هنا نشأت فكرة البحث التي أثمرت هذا الكتاب “كيف يرى العلويون أنفسهم، وكيف هي علاقتهم ببقية الشعب السوري من خلال انقسام (نحن وهم).
استخدم الكاتب نظرية الخطاب لفهم الهوية الدينية في سورية، ولم يكن الدين هو ما يهمه، بل الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تنشأ عن رؤية العالم من منظور الدين أو العرق فقط، واختزال الناس بكونهم أعضاء في هذه المجموعات. الدافع هو الخوف، ومن الخوف تنشأ الكراهية.
في السنوات التاليات سئل الكاتب عما إذا قد رأى الصراع المقبل أو إذا ما استغرب ما حدث في 2011 فصاعدًا. وجوابه هو: فوجئت بأن ما حدث قد حدث عندما حدث. وفوجئت بأن استجابة النظام جاءت قاصرة وحمقى. ما لم يفاجئني هو التطورات الطائفية القاسية التي أعقبت ذلك، الكراهية الكامنة التي قد واجهتها في كثير من السوريين كانت بحاجة فقط إلى أوضاع ملائمة كي تزدهر، وهنا تضافرت من النواحي جميعها القوى التي جعلت جرعةً كافية من الخوف تحول الإنسان إلى حيوان.
التحامل والتحيز اللذان لمسهما الكاتب في سورية يتجليان خطابيًا في كلمة (لكن) الحتمية التي تعقب عبارات التسامح واللياقة السياسية. وتعلّم الكاتب حينها أن اللوم يجب أن يتوجه إلى الذات، لا إلى مكان آخر. وحين يسمع السوريين يقولون إن “الحرب الأهلية” هي من فعل الغرباء انتابته غصة فالتغيير لن يبدأ، والتعافي لن يحدث، ما لم ير السوريون معظمهم حصتهم من المسؤولية عمّا حدث. ويدركون بأننا لا نستطيع فهم الآخرين من خلال التحامل والحكم المسبق عليهم، وحين نصغي بما يتجاوز ميلنا إلى أن نعرف أكثر منهم. حينئذ يبدأ الغضب والخوف بالتلاشي.
(عرض/ فادي كحلوس)
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)

 العربية
العربية  English
English