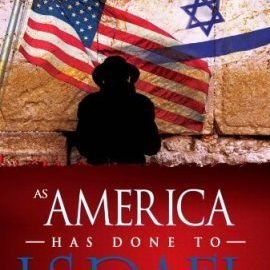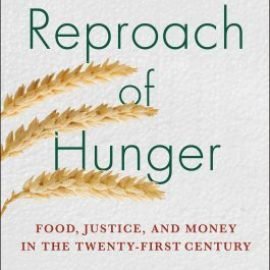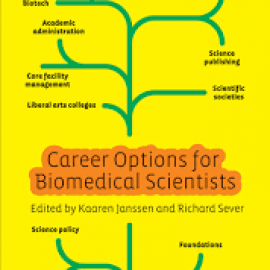الوصف
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جماعي بعنوان تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس 2010-2020 معضلات التوافق والاستقطاب، ضمن سلسلة “دراسات التحول الديمقراطي”.
يهدف الكتاب بفصوله الخمسة إلى تحليل عشرية من تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وهي عشرية كانت بلا شك مرتبكة طورًا ومتعثرة طورًا آخر، ولكنها رغم ذلك كله تمكّنت بالتدريج من فتح ورش متعددة لبناء هذا الانتقال عبر سنّ دستور رسّخ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ودعّم أركان الدولة المدنية وأتاح لمختلف النخب السياسية التداول السلمي على السلطة. كما استطاعت التجربة توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتنظيم التنافس الانتخابي حتى استوى المعمار السياسي للتجربة قائمًا. جرى ذلك كله بالتوازي مع ترتيب العلاقة مع ماضي الانتهاكات أملًا في المصالحة.
مع أهمية هذا المنجز السياسي، ظلت الخطوات المقطوعة متعثرة؛ إذ أخفقت جل النخب السياسية المتعاقبة على الحكم إخفاقًا ذريعًا أحيانًا، حين عجزت عن تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة: سكان دواخل البلاد وأريافها وشبان أحزمة المدن المهمّشة، في الشغل والتنمية والخدمات الاجتماعية، ما غذّى مشاعر الحرمان والإحباط التي ستظل خزّانًا قابلًا لمختلف أشكال الاستثمار على نحو يهدد التجربة برمّتها.
يذهب عبد الوهاب بن حفيظ، في الفصل الأول “على أبواب الوضع الدائم: رؤية مقارنة بشأن تثبيت المسار الديمقراطي في تونس”، إلى أن تونس بنجاحها في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في المدة 2014-2016، لم تثبت انتصار الأحزاب والقوائم المستقلة فيها، بقدر ما أثبتت انتصار ديناميات التغيير في تجربتها المتراكمة. ووفق المعايير كلها، فإن هذه التجربة، بصيغة الأحزاب غير الفائزة مطلقًا والأحزاب غير الخاسرة، ستكون مدعوّة إلى اختبار قدرة المجتمع السياسي التونسي، وقدرة النخب التي برهنت، إلى الآن، على نضجٍ منقطع النظير في المنطقة العربية، وإلى مواصلة تجربة التوافق من أجل تجنيب البلاد حالة عدم استقرار سياسي قد ينسف ما جرت مراكمته حتى الآن من منجز سياسي مهم.
يعالج هذا الفصل على نحوٍ أكثر دقة تحديات الانتقال السياسي في جانبه المؤسسي الذي يشمل جملةً من المؤشرات المهمة التي تتناول خصوصيات الوضع الاجتماعي-السياسي التونسي منذ عام 2011، والتجاوب مع الأزمات الطارئة للحوكمة والإصلاحات المؤسسية، والجاهزية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لإنجاح فرص التغيير، والهيئات التعديلية ودورها، والمدركات الذاتية وتطور الرأي العام، وأخيرًا “كودات” الجولان السياسي أو القانون الانتخابي.
وينتهي الفصل بخلاصات مهمة تثبت ترسّخ الانتقال السياسي الذي تمر به تونس من خلال ما أبدته النخب التونسية من كفاءات ومهارات في حسم الخلافات وبناء التوافقات، بعيدًا من العنف، على الرغم من وجود مساحات واسعة من الهشاشة والضعف على نحوٍ يجعل المرحلة المقبلة مرحلة التوافقات الاجتماعية التي سترسّخ هذا المسار وتمنحه أسس ارتكاز داخل النسيج الاجتماعي. ويرى بن حفيظ أن هناك مبررات عدة لاستقرار الديمقراطية تدرجًا في تونس.
أما حافظ عبد الرحيم، فاختار في الفصل الثاني “تجربة التوافق في تمثلات النخب التونسية: الخيارات والتحالفات والتنازلات”، أن يقارب، من زاوية سوسيولوجية مفتوحة، ما تشهده تجربة تونس في الانتقال نحو الديمقراطية من تحوّلات تراوح بين النجاح والفشل في إعادة هندسة المجال السياسي الانتقالي باعتماد آلية التوافق خيارًا سياسيًا، وربّما مجتمعيًا أيضًا. ولئن كان التوافق، في ما يفترضه هذا البحث، خيارًا سياسيًا، بادرت إليه النخب الفاعلة، فإن النجاح في اعتماده خلال مسار الانتقال الديمقراطي، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ما تحوّل الفعل إلى خيار مجتمعي يجري فيه الحديث قولًا وفعلًا عن توافق اقتصادي وثقافي؛ أي أن يتحوّل من شأن نخبوي سياسي صرف، إلى توافق مجتمعي يمسّ الناس في مختلف مجالات عيشهم اليومي حتى يصبح شأنًا مشتركًا. بناء عليه، اشتغل عبد الرحيم خاصة على ممارسات هؤلاء الفاعلين وإنتاجاتهم وتمثّلاتهم داخل الساحة السياسية التونسية، وهم الذين سعوا لمأسسة هذا الخيار إلى ما بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011. واتخذ هذا الاشتغال، منهجيًا، من إنتاجات هؤلاء الفاعلين (ملفوظة ومكتوبة) مادةً للتحليل والتفكيك والاستنتاج؛ بهدف رصد مسار تراكم التجربة التوافقية في تونس بما هي مكوّن جوهري ضمن المسار الانتقالي نحو الممارسة الديمقراطية الحديثة.
وحرص عبد الرحيم أيضًا على استجلاء مواطن التوفيق في دفع مسار التوافق ضمن التجربة التونسية عبر تتبّعها من خلال تحليل مضمون عيّنة من الكتابات التي أنتجَها أفراد من النخبة التونسية من ذوي الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية المختلفة التي راوحت بين وجهة نظر تواصلية (يورغن هبرماس Jürgen Habermas) تدافع عن هذا الخيار التوافقي باعتباره الحلّ لتجاوز حالات التصادم في مسار الانتقال الراجعة إلى التجاذبات السياسية والأيديولوجية وحالات الاستقطاب التي توسّع هوّة الاختلاف وتحدّ من حظوظ الالتقاء، ووجهة نظر صراعية (جان فرانسوا ليوتار Jean François Lyotard) تعارض خيار التوافق على خلفية ما يمكن أن تجرّ إليه هذه المسارات من تنازلات مغشوشة أو مفروضة من منطلقات أخلاقية لا ترتقي إلى مستوى القناعة، على اعتبار أن الديمقراطية في جوهرها صراعية، فيغدو من المستحيل، من حيث المبدأ أصلًا، التوصّلُ إلى توافق في السياسة.
بناء عليه، عمد عبد الرحيم إلى طرح السؤال بشأن خصائص التوافق الجيّد Le bon compromise كما طرحه الباحث البلجيكي فيليب فان باريجPhilippe Van Parijs ، وهي الخصائص المتمثلة في أن يكون توافقًا مشرّفًا، يسمح بـ “حفظ ماء الوجه” لكلا الطرفين، ومنصفًا، وحاملًا في ذاته صفتَي الجدوى والنجاعة عبر تعديل الأفضليات. وخلص الفصل أيضًا إلى جملة من الاستنتاجات، منها أن الأهم في التجربة التونسية هو نجاحها بدرجة تزيد أو تنقص، في تحويل الصراع من صراع محوره التقابل بين اليمين واليسار على أساس أيديولوجي، إلى صراع سياسي ممأسس يحتكم إلى هياكل ذات نظر (مؤسسات سياسية ومنظمات وهيئات دستورية تتعلق بالانتخابات والإعلام وحقوق الإنسان، وغيرها)، قادرة على إضفاء النجاعة على العملية السياسية، ومن ثم، إيجاد تعدّدية سياسية وفكرية وثقافية فعلية. لكن يبقى مؤكدًا أيضًا أنه مسار لا يزال عرضةً لاهتزازات وعوائق؛ منها ما هو إجرائي عملي (الصعوبات الاقتصادية والإدارية والأمنية، وغيرها)، ومنها ما هو فكري ثقافي يتعلق بالثقافة السياسية القائمة ومدى تجذّر ثقافة التوافق في التمثلات الفردية والجماعية للمجتمع التونسي بمختلف فاعليه. وانتهى الفصل إلى أن التوافق في التجربة التونسية، كما يتأكد للملاحظ، ليس توافقًا عارضًا، ولا هو وليد قرار فوري، لكنه لم يتحوّل بعدُ إلى منهج قائم يمسّ مباشرة الشأن العام والمعيش اليومي للمواطن، ويستند إلى ثقافة سياسية واجتماعية. ومن ثم، يحتاج دائمًا إلى جهة ضامنة لاستقراره، “حيث لا يمكن أن يتحوّل إلى حالة دائمة عبر ترسيخ لثقافة التوافق”، فلا معنى لتوافق سياسي بين أطراف متعدّدة إذا لم يكن متبوعًا بوفاق اجتماعي؛ بمعنى تجميع طاقات القوى المختلفة (الأحزاب والمنظمات والهيئات والجمعيات) وتوجيهها إلى تحقيق الأولويات الاجتماعية (العدالة، والتنمية، والتشغيل، وغير ذلك) على حساب الأولويات السياسية من تنافس بين أغلبية وأقلية وتعددية، أي في صيغة عقد اجتماعي يؤخّر الصراع السياسي لمصلحة السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والتنمية، لأن التوافق في الأحوال كلها وفي التجارب يبقى وعدًا، وعبر الوعد يشكل الناس توافقهم، لكن من دون ضمانات مسبقة للتحقق.
وانخرط عبد الرزاق المختار، في الفصل الثالث “دستور الانتقال: توتّرات التأسيس وتأسيس التوتّرات (في الانتقال غير المكتمل)”، في ما سمّاه “الظاهرة الانتقالية” في أبعادها العامة والتفصيلية في دراسات فقه الانتقال. وهي دراسة عادةً ما يُقبل عليها الباحثون في القانون الدستوري والعلوم السياسية؛ إذ تناولها من زاوية تركّز أساسًا على البحث في التمخّض الدستوري (دستور 27 جانفي2014 )، ضمن مقاربة لا ترصد الثابت ضمن المكتسب الدستوري، كما هو دارج في تناوله، بل تلتمس أثر الانتقال فيه، وحتى تجاوزه، وهي رؤية للدستور تولي التوتّرات النصّية التي تُبقي النص (الدستور) متحرّكًا والانتقال غير مستكمل، أهمية قصوى، في انتظار تأويلات تتمّه ويُرتَجى منها عادة أن تكون ديمقراطية، أو تعديلات مشوبة بالحيلة السياسية ورهينة الهاجس السلطوي.
يسعى هذا الفصل، اعتمادًا على مزاوجة منهجية بين المعطى القانوني (دستور 27 جانفي2014 ) والمعطى السياسي (الحدث والفعل والخطاب السياسي)، لتشغيل أدوات مفهومية كلاسيكية، وأخرى مستحدثة، أهمها الدستور المتعدد (الدستور القيمي، الدستور الرمزي، الدستور المؤسساتي، دستور الهوية، دستور السلطات)، والتوترات التأسيسية والتأويل الديمقراطي، وبحث المآل الدستوري للانتقال من جهة استيفائه أو استمراره. على هذا النحو كانت مهمة الباحث في هذا الفصل تحديد علاقة الانتقال بالدستور ضمن جدلية تأسيس التوترات وتجاوزها. أما النتائج التي طمح الباحث إلى إدراكها فهي بيان مدى قدرة دستور 27 جانفي 2014، باعتباره دستورًا للانتقال، في حسم الأسئلة الكبرى لهذا الانتقال ذاته في ما يتّصل بالمشروع المجتمعي العام ضمن ثنائية الحكام والمحكومين، وذلك من زاوية الأمل الديمقراطي دون سواه، حتى ينتهي الانتقال ديمقراطيًا ومن دون انتكاسة أو نكوص. وانطلاقًا من ذلك، عمد الباحث في ما يتعلق بالعلاقة الإشكالية بين الدستور والانتقال إلى التمييز في مبحثي الفصل الرئيسَين بين تأسيس التوترات (المبحث الأول) وتجاوزها (المبحث الثاني)، ومكّنته هذه المقاربة من الوصول إلى جملة من الخلاصات؛ لعل أهمها، أن قيمة الإنجاز الدستوري للتجربة الانتقالية في تونس لا يمكن أن تحجب رمالًا متحرّكة دستوريًا، تتّصل تحديدًا بالدستور القيمي والمؤسساتي، وتمثّل توتّرات تأسيسية كامنة تتطلّب لتثبيتها بلورة اتفاقات دستورية لاحقة، سواء عبر التأويل الدستوري أو عبر التعديل الدستوري. كما تعلَّق الانتظارات الملحّة والمهمة على كاهل القاضي الدستوري لاستكمال موجبات الانتقال ديمقراطيًا عبر التأويل الديمقراطي لأحكام الدستور، خصوصًا ضمن تخوّفات من تعديل دستوري أشبه بكلمة الحق التي يراد بها باطل دستوري.
أما الفصل الرابع، “الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ومنوال التنمية” لمعز سوسي، فهو دراسة دقيقة لمنوال التنمية ومسارات نسق النمو على الأمدين الطويل والمتوسط اللذين عايشتهما تونس منذ الاستقلال. وتبيّن للباحث أن النسق المرتفع نسبيًا للنموّ، خصوصًا في فترات ما قبل الثورة، لم يكن كافيًا لتحقيق التطور والاستقرار، بل كان الاقتصاد يعيش مشكلات عدة، أهمها بطالة مرتفعة وتفاوت جهوي وانخرام على مستويات المالية العمومية والميزان التجاري. ولم يَخلُ تاريخ البلاد من هزّات كثيرة، كانت كلما وقعت، قادت إلى أزمات مختلفة الشدة؛ مثل فترة التعاضد في أواخر ستينيات القرن العشرين، وأزمة “الخبز” في أواسط ثمانينياته، ومن دون أن ننسى طبعًا الحدث الأبرز، ثورة عام 2011. والمتأمل هذه الأحداث، يتجلّى له أنها تتشكل أساسًا من جراء أزمات اقتصادية تعود إلى مناويل تنموية غير ملائمة لأهم حاجات البلاد، وأهمها إيجاد مواطن شغل بالكمّ والكيف اللازمَين. وتراكمت هذه المشكلات عبر السنين، نظرًا إلى غياب إصلاحات جادّة، على نحوٍ أدّى إلى ارتفاع البطالة لدى الشباب وحاملي الشهادات الأكاديمية، وإلى تفاقم الهجرة، خصوصًا في جانبها السرّي. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو التذبذب الكبير في الخيارات الاقتصادية الهيكلية، حيث جُرّبت مناويل تنموية عدة، تقلّبت فيها أدوار الدولة من الراعية والداعمة إلى المراقبة والمسيّرة. وبعد ثورة عام 2011، تعالت الأصوات منادية بتجاوز أخطاء الماضي والإصلاح. لكن، بات الموروث ثقيلًا جدًا. وبدلًا من أن يتحسّن الوضعان الاقتصادي والاجتماعي، تراجعت أغلبية المؤشرات، واصطدمت أغلبية الفئات بواقع صعب جرّاء تدهور حاد في نوعية الخدمات العمومية وتراجع نوعية العيش وتفاقم البطالة وتدهور الطاقة الشرائية. لكن، على الرغم من ذلك، فإن ما اجتازته تونس من أشواط كبرى في طريق الانتقال الديمقراطي وإرساء نظام الحكم الرشيد وهياكله، لا يمكن تجاهله، ومن محطاته تنظيم الانتخابات البلدية وإرساء الحكم المحلي في أيار/ مايو 2018 .
وفي الفصل الخامس والأخير “العدالة الانتقالية في تونس: المسارات والمآلات”، يرى شاكر الحوكي أنه بعد مضي أربع سنوات على عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بات التساؤل عن أفق تحقق العدالة الانتقالية في تونس ونجاحها مُلحًّا أكثر من أي وقت مضى، بل إن التساؤل نفسه قد يأخذنا إلى المربع الأول بخصوص جدوى اعتماد خيار العدالة الانتقالية بوصفه أمثل الخيارات. يقود البحث بشأن العدالة الانتقالية في تونس إلى الوقوف على ثنائية المسارات التي عرفتها هذه التجربة، ذلك أن تغير المشهد الحزبي بُعَيد انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2014 كان لحظةً فارقةً ومنعطفًا حاسمًا على صعيد المسار السياسي، وربما كانت العدالة الانتقالية ستشقّ طريقها بوضوح أكثر وثبات لو لم يحدث ذلك التغيير، حيث كانت المواقف الرسمية الضمنية والمعلَنة للحاكمين الجدد واضحة وتفيد بعدم إيمانهم واقتناعهم بمسار العدالة الانتقالية كما صاغه القانون في الأقل.
باتت التأويلات المتباينة، على صعيد المسار القانوني، تحيط بكل فصل قانوني، وتُشرّح نيّات المشرع في كل اتجاه إلى حد التناقض. واندلع، تبعًا لذلك، خلافٌ حاد بشأن نقل الأرشيف الرئاسي، ومدى توافر النصاب داخل اجتماعات هيئة الحقيقة والكرامة، ودستورية قانون المصالحة الاقتصادية، ودسترة هيئة الحقيقة والكرامة، وصلاحياتها الموسّعة وحقها في التمديد، وغير ذلك. ولم يكن الأمر محاولةً لتحديد مدلولات النص وإمعانًا في البحث عن مقاصد المشرع، بل كانت بغيته التصدّي لأي تقدّمٍ يمكن أن تحرزه الهيئة لفائدة كشف الحقيقة وإصلاح مؤسسات الدولة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.
وانتهى الباحث إلى النظر في العدالة الانتقالية وفق ثنائية المنجز والتحدي؛ إذ كشف عن حدود هذه المقاربة، بعد أن أصبحنا إزاء خيارين لا ثالث لهما، بحسب اعتقاد الباحث: منجز لم يتحقق، وتحدٍّ يتهدده الانفجار، ذلك أن جلسات الاستماع العلنية، على أهميتها، لم يحضرها المتورّطون في ما نُسب إليهم من جرائم، وجرت من دون أن يحضرها ولو من باب البروتوكول أيّ رئيس من الرؤساء الثلاثة: رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان. وهذا أمر لم يخلُ في حد ذاته من دلالة. كما غاب أيضًا المتهمون في المحاكمات التي بدأت الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية تنظر فيها في أواخر ربيع 2018. ورفض مجمل الوزارات، أو أهمها، التعاون مع الهيئة أو مدّها بالوثائق المطلوبة، أو حتى تسلّم مستحقاتها المالية. وفي الوقت الذي كانت الحقيقة تُجلى بكل وضوح، لم نستمع إلى اعتذارات “الجلاد”، أو حتى مجرد اعترافاته، ولم نلحظ أيضًا تراجعًا لسرديات الدولة العميقة التقليدية المزيفة والمزوّرة، أو مراجعة لها. في المقابل، يقرّ الحوكي بصعوبة جبر الضرر في ظل تلكُّؤ السلط في تفعيل صندوق الكرامة، إضافة إلى غموض كيفية تطبيق ما ستتمخّض عنه أعمال الهيئة من توصيات واقتراحات في ظل رفض رسمي مستميت وذاكرة مبتورة ومصالحة بلا متصالحين وانتقال ديمقراطي متعثر وإحاطة دولية محدودة النتائج. فهل قدر الضحايا أن يبقى مصيرهم معلّقًا بين النصوص الحالمة والواقع المرّ؟ وتوصل الباحث إلى خلاصات فيها الكثير من التشاؤم، حيث عرفت العدالة الانتقالية انزياحًا خطرًا بعد عودة رموز النظام القديم مع انتخابات عام 2014؛ ذلك أن مسائل عدة، على غرار كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة وإصلاح المؤسسات، تعثّرت، بل غدت موضوعًا للشك والارتياب بعد أن كانت من استحقاقات الثورة. ولا شك في أن لهذا التشاؤم، في المقابل، ما ينسّبه؛ إذ إن هناك أيضًا نقاطًا مضيئة في التجربة التونسية، لكن تحتاج، بحسب رأي الباحث، إلى إرادة سياسية إذا ما توافقت النخب السياسية على الأولويات وتجنبت صراعاتها العبثية أحيانًا، وانتبهت إلى أصوات الاحتجاج الاقتصادي والاجتماعي المتصاعدة.
يسعى هذا الكتاب، من خلال فصوله الخمسة، ليقدّم مداخل متعددة ربما تعين القارئ العربي عمومًا في فهم طبيعة الانتقال الديمقراطي الذي تمر به تونس؛ فهو انتقال يترسخ على المستوى السياسي بفضل توطيد الحقوق الأساسية للمواطنين وتوسيع مساحات الحرية والمشاركة السياسية وتثبيت التداول السلمي على السلطة وبناء دولة المؤسسات والقانون. لكن تبقى الساق الثانية التي تؤمّن السير قدمًا في هذا الانتقال مربَكة، ومغلولة أحيانًا بسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي أخفقت تسع حكومات في تذليلها، بل قد تكون هذه السياسات المتّبعة في معالجتها سببًا في تفاقمها، بحسب بعض الآراء. وما كان لهذا الانتقال أن يسلم لولا قدرة النخب التونسية على بناء توافقات، وإن كانت هشّة. لكن سيكون هذا التوافق عرضةً للانتكاس كلما ضغطت تلك العراقيل الاقتصادية والاجتماعية على النخب ذاتها تحت ضغط العنف والاحتجاج بأشكاله كلها في سياق لم تسترجع فيه الدولة قوّتها الضرورية حتى تقاوم الاقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي وموجات العنف التي تراجعت، لكنها تبقى مهدِّدةً الانتقال الديمقراطي.

 العربية
العربية  English
English