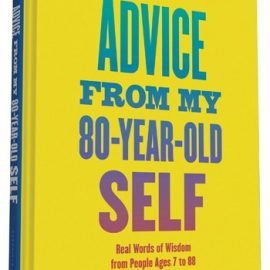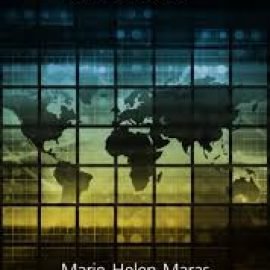الوصف
This post is also available in:
 English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
الكتاب عبارة عن دراسات مختلفة لباحثين مختلفين يجمعها موضوع واحد ألا وهو علماء السنة في الشرق الأوسط في العصور الحديثة،
يتألف الكتاب من أربعة أبواب رئيسية تندرج تحتها ثلاثة عشر فصلا بالإضافة إلى مقدمة المحرر،
***الباب الأول عن ورثة الأنبياء في التاريخ الإسلامي وهو بشكل ما يستعرض مكانة العلماء ودورهم في العصور ما قبل الحديثة ويحتوي :
الفصل الأول بعنوان “العلماء بين الدولة والمجتمع في الإسلام السني في العصور ما قبل الحديثة” :
في هذا الفصل يحاول الباحث تعريف العلماء وعلاقتهم بالمذاهب والمدارس الدينية ثم علاقة العلماء بالحكام وكيف كانت مكانة العلماء وصورتهم في نظر أنفسهم أولا وفي نظر الحكام وفي نظر العوام كذلك، يستعرض الكاتب هذه المكانة في عصري المماليك والعثمانيين وهو يرى أن مكانة العلماء انحدرت عبر هذه العصور حتى وصلت لأدنى شيء قبل عصر التحديث، خاصة أن العلماء اكتفوا في عصر العثمانيين بتحريض الناس على مواجهة الظلم لكن دون تورط في الفوضى أو العنف.
الفصل الثاني بعنوان “موقف الجبرتي من علماء عصره” وهو يركز على رؤية الجبرتي للعلماء المسلمين في عصر المماليك والعثمانيين عبر كتابه “عجائب الآثار في التراجم والأخبار”، الجبرتي في هذا الكتاب يعتبر العلماء ورثة الأنبياء ويقدمهم في التراتبية المجتمعية على الحكام والأمراء لكنه في الوقت نفسه يسجل انحرافات علماء عصره عن جادة الدين والأخلاق معتبرا أنها السبب الرئيس في وقوع الأمة الإسلامية فريسة للقوى الأوربية، بعد ذلك تنقلب المكانة التقليدية للعلماء رأسا على عقب على يد “محمد علي” الذي استبدل بهم موظفين تلقوا تعليمهم في أوربا.
***الباب الثاني كان عن التحديث والإصلاح والخطاب الوطني وكيف واجه العلماء ذلك ويحتوي خمسة فصول:
_الفصل الثالث بعنوان “العلماء والنشاط السياسي في أواخر عهد الامبراطورية العثمانية” وفيه يركز الباحث على المسيرة السياسية لشيخ الإسلام مصطفى صبري وكيف حاول تدعيم دور الدين في إدارة شئون الدولة والتدخل في الإصلاحات السياسية والتشريعية وكيف قاوم كثيرا الحركة الكمالية حتى انتهى به الحال منفيا إلى اليونان ثم إلى مصر حتى وفاته 1954
_الفصل الرابع بعنوان “علاقة الاستعمار الإيطالي بالنخبة الإسلامية في ليبيا بين العداء والعمالة” وفيه نجد أنه بالرغم أن الإسلام كان عنصرا مهما في السياسة الاستعمارية في ليبيا وبالرغم من أن سلطات الاحتلال أولت أهمية خاصة للنخب الإسلامية إلا أنها لم تستطع تحديث النخب التقليدية ولا تشكيل نخب ناشئة حديثة وبالتالي لم تؤثر الإدارة الإيطالية المحتلة في بنية النخب الإسلامية الليبية بأي شكل من الأشكال.
_الفصل الخامس بعنوان “التعليم والسياسة والصراع من أجل الزعامة الفكرية”، يركز هذا الفصل على علاقة الأزهر وشيوخه بالنظم الحاكمة في مصر ابتداء من الملكية وانتهاء بالجمهورية التي غيرت وجه الأزهر إلى الأبد 1961 وقزمت دوره في المجتمع وسيطرت عليه تماما، يستعرض الفصل سيرتي شيخين للأزهر هما “مصطفى المراغي” و”محمد الأحمدي الظواهري” ويتوصل إلى أن كلا منهما لم يسع إلى إصلاحات حقيقية بقدر ما سعى إلى المحافظة على مكانة الأزهر ودوره في الدولة المصرية .
_الفصل السادس بعنوان “تلاميذ الأفغاني ومحمد عبده في العراق” يركز هذا الفصل على علاقة العلماء السنة والعلماء الشيعة بالعلم والحداثة أثناء العقود الأولى من القرن العشرين وذلك من خلال سيرة العالم الشيعي “هبة الدين الشهرستاني” والعالم السني “محمد الهاشمي” ونقاط الاتفاق في مواقفهما ونقاط الاختلاف .
_الفصل السابع بعنوان “الباحثون الغربيون ودور العلماء في تطويع الشريعة لخدمة الحداثة” وهو من أمتع فصول الكتاب بالنسبة لي وفيه يعرض الباحث للنماذج التشريعية المعاصرة في الدول الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط ويركز على نماذج مصر والسودان والسعودية ويتساءل أي هذه النماذج الأقرب إلى تطبيق الشريعة فعلا أم أنها كلها نماذج حداثية ضلت عن روح الشريعة بالفعل؟، في الحقيقة اصطدمت هنا من جديد بآراء وائل حلاق التي فصلها في كتب متنوعة خاصة كتاب “الدولة المستحيلة” كما أنني شعرت برغبة كبيرة في إعادة الكتاب الأيقونة في نظري “منهج عمر ابن الخطاب في التشريع” كونه يحمل ردا ما على ما طرحه الباحث من احتمالات وتساؤلات، كان فصلا ممتعا ومثيرا للأفكار ومستدعيا للتأمل .
*** الباب الثالث وموضوعه كان غريبا علي قليلا وهو عن حراس العقيدة في المجتمعات شبه القبلية ويحتوي فصلين :
_الفصل الثامن بعنوان “العلماء والقبلية والنضال الوطني في المغرب بين عامي 1944و1956″، وقد استفدت منه معلومات جديدة تماما علي خاصة وأني أجهل التاريخ الحديث للمغرب العربي بالذات، تفاجأت بالعلاقة الوثيقة بين العلماء وبين الحركة الوطنية في المغرب وكيف تمسكت الحركة الوطنية المغربية بتقاليد المجتمع وثقافته في مواجهة الاحتلال عكس معظم الحركات الوطنية العربية وكيف اعتمدت على الهوية الإسلامية بل والغريب كيف أصرت على وجود الملك في النظام السياسي المقترح، تفاجأت كذلك بعلاقة الريف بالحضر في المغرب وعلاقة القبائل بالحركة الوطنية وأعتقد أني محتاجة للتثبت مما قرأت والاستزادة من قراءات أخرى حول نفس الموضوع.
_الفصل التاسع بعنوان “المواءمة بين القبلية والدين في كتابات العلماء السعوديين المعاصرين” وأعتبره فصلا مهما للغاية لفهم أدق لما يحدث فعلا في المملكة العربية السعودية، في هذا الفصل يعرض الباحث لكتابات العلماء السعوديين ويبين لنا كيف حاولوا إجراء عملية أسلمة للقبلية في المجتمع السعودي بحيث يستبدلون مفاهيم العصبية القبلية والتحكيم بما يناظرها من مفاهيم دينية كالولاء والبراء والمحاكم الشرعية، كما يبين كذلك كيف حاولوا أيضا كسب هذه القبائل لصالحهم وإعطاء شيوخ القبائل بعض الصلاحيات، أعجبتني جملة الختام حين أنهى الفصل بقوله “بمعنى أنه عند التقاء الدين والقبلية تكون الغلبة للدين، لكن الأسرة الحاكمة تطوعهما معا لمصلحتها، وتشكل بهما أيدولوجية تدعم بها أركان حكمها”.
***وأخيرا الباب الرابع وهو من أكثر أبواب الكتاب إثارة للاهتمام كونه يتحدث عن إشكاليات معاصرة وهو ما يظهر من عنوانه “أيديولوجيات متنافسة” ويحتوي أربع فصول :
_الفصل العاشر بعنوان “الوهابيون والصوفيون والسلفيون في دمشق مطلع القرن العشرين” وفيه يعرض العداء الذي واجهه المذهب الوهابي في دمشق خاصة من العلماء المدافعين عن الصوفية والمرتبطين بالسلطة وكيف ارتبط علماء سلفيون في دمشق بالمذهب الوهابي ودافعوا عنه معتبرين أن ثمة جذور مشتركة تجمعهم (مدرسة ابن تيمية) وإن ظلوا يختلفون مع الوهابيين حول دواعي التكفير ومآلاته.
الفصل الحادي عشر بعنوان “خيانة رجال الدين: الإسلاميون والعلماء والسياسة” وفيه يرصد الباحث صعود الإسلاميين في مواجهة علماء السلطة كما يطلق عليهم وكيف حاول العلماء المحافظة على الروح الإسلامية في المجال العام مواجهين للسلطة وطغيانها حينا ومكافخين للحفاظ على مكتسباتهم ومؤسساتهم حينا ومعتمدين على إمدادات السلطة ودعمها خاصة في مواجهة الإسلاميين أحيانا أخرى .
_الفصل الثاني عشر بعنوان “الجدل بين الكتاب الليبراليين والعلماء حول الإسلام في العالم العربي المعاصر” ويتناول هذا الفصل موقف علماء السلطة في التعامل مع الكتاب الليبراليين وقراءاتهم المشوهة(الوصف من عندي) للنصوص الدينية والتاريخ الإسلامي والأساليب التي فضلوا استخدامها في المواجهة خاصة عبر المناظرات ومواجهة الفكر بالفكر والأساليب التي ترددوا في استخدامها كحظر الكتب والملاحقة القضائية والأساليب التي أنكروها كفتاوى التكفير واللجوء إلى العنف، وقد ضرب أمثلة متنوعة وضحت هذه الأساليب .
_الفصل الثالث عشر بعنوان “دفاعا عن محمد(صلى الله عليه وسلم): العلماء والدعاة والتدويل الجديد للإسلام” وهو يركز على العلاقة بين العلماء والدعاة الجدد الموجودين على ساحة الإعلام الإسلامي من حيث سعي كلا الفريقين لإحداث تدويل جديد للإسلام ويستعرض نماذجا للدعاة الجدد الذين حققوا نجاحا إعلاميا لافتا وعلاقتهم الحقيقية بالدين كعلم ومرجعية وموقفهم من قضايا أمتهم واعتمادهم على أفكار التسويق والترويج الإعلامي لبرامجهم فيما عرفه باتريك هايني باسم “إسلام السوق”، كان فصلا ممتعا ومثيرا للاهتمام خاصة أنه يناقش إشكالية لا تزال مستمرة في حياتنا وأحب أن أنقل الفقرة الأخيرة التي ختم بها لدلالتها
“وهكذا نرى نرى أنه حتى لو عاد العلماء إلى المسرح عودة قوية على خلفية الصحوة الإسلامية الكبرى فإن العلم لم يعد هو السبيل الوحيد لكي يصبح الواحد منهم مرجعا دينيا يرجع إليه المسلمون حتى بين العلماء أنفسهم، ويبدو أن بعض المؤهلات مثل المواءمات السياسية والجاذبية التليفزيونية هي التي تضمن للواحد منهم اعتراف الجماهير به أكثر من تميزه في العلم عن أقرانه”.
وبعد،
فالكتاب على جدية موضوعاته وأهميتها وجدة معلوماته وغزارتها إلا أنه سلس الأسلوب للغاية وممتع في بعض فصوله (لم أتوقع أن يكون ممتعا أصلا :D) وأعتقد أنني رغم الإحباط الذي لازمني جراء الصورة القاتمة نسبيا التي رسمها لعلماء الإسلام في العصر الحديث ومواقفهم المترددة ومكانتهم المتراجعة ودورهم الضعيف في مواجهة السلطات المستبدة الحالية داخليا والثقافات المادية الاستهلاكية خارجيا إلا أنني استفدت من هذه الصورة ذلك الشمول الذي جمع عقودا زمنية ودولا مختلفة كما استفدت منها إدراك الزاوية التي ينظر الآخرون من خلالها إلينا، يعني أعتقد أن أعظم ما استفدته ليس ما طرحته الأبحاث المختلفة فقط بل دلالة هذا الطرح في المقام الأول من إجابة على سؤال شديد الأهمية: كيف يرانا الآخرون؟ ما الصورة التي يحملونها لنا في مخيلتهم؟ وكيف يحللون أزماتنا الراهنة شديدة الخصوصية؟ وما الذي يتوقعونه منا وما الذي يستبعدونه؟ وما علاقة كل ذلك بالحقيقة أو ما نتوقع نحن أنه الحقيقة؟!
**ملاحظة أخيرة: الترجمة رائعة وسلسة جدا فشكرا لمن نقله إلى العربية د.محمود عبد الحليم، إخراج الكتاب جميل ومتقن خاصة الخطوط العربية .
This post is also available in:
 English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)

 العربية
العربية