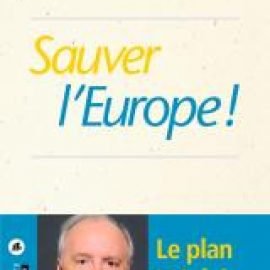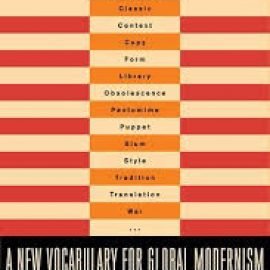الوصف
دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية
سوف تجد دائمًا سببًا للكتابة عن الحرب. إنها تقرر حيوات الناس. هكذا تقدّم دلال البزري لكتابها دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (216 صفحة بالقطع الصغير، مفهرسًا)، في سلسلة “مذكرات وشهادات“. تؤكد البزري أن هذه الدفاتر ليست سعيدة كما كانت عليه السنوات التي سبقت الحرب، “لكن مأساويتها محدودة، كما كانت الحرب الأهلية اللبنانية محدودة بجغرافيتها، لم تتجاوز الحدود اللبنانية؛ عكس الحرب السورية، ذات القعر اللانهائي، التي أشعلت شظاياها نيرانًا كانت هامدة، قريبًا منها وبعيدًا عنها”.
الطريق والمركز
في الفصل الأول، الرصاصات الأولى (1975)، تستعيد البزري أول أيام انقسام بيروت بين “شرقية” تحت السلطة اليمينية و”غربية” تحت السلطة الوطنية اليسارية المساندة للمقاومة الفلسطينية. كانت منطقة المتحف (تحولت محورًا مشتعلًا في ما بعد) نقطة القطيعة بين البيروتيين، وهي النقطة التي عليها أن تمر فيها على الطرق من حارة حريك، قلب الضاحية الجنوبية وخزان القوى الوطنية والتقدمية آنذاك، إلى الجعيتاوي في الأشرفية، قلب المنطقة المناهضة لكل ما آمنت به البزري. تكتب: “أتوقف عند المتحف، وأخشى أن أتابع؛ في غفلة واحدة تحوّلت هذه القطعة من بيروت إلى منطقة أخرى، كأنها سقطت سهوًا؛ هل يعقل؟ […] لا أحتاج إلى الشجاعة كي أواصل طريقي نحو أعماق الأشرفية، نحو طلعة الجعيتاوي، بل أحتاج إلى الأمل”. وفي الفصلين الثاني والثالث، كلية التربية: الجنة الضائعة (1973-1978)، تتحدث البزري عن أيامها “النضالية” في كلية التربية، في صفوفها، والأهم في الكافيتيريا. تكتب: “في الكافتيريا، تحصل أهمّ الأمور: الاجتماعات مع الذين نتصل بهم لإدخالهم إلى منظمتنا، والتشاور مع المسؤول الحزبي في شأن كتابة الشعارات السياسية أو المطلبية […] ملوك الكافتيريا هم هؤلاء المناضلون الكبار الذين ارتقوا في أحزابهم، يساريةً كانت أم يمينيةً، وقرروا، بأمرٍ حزبي، أن يرسبوا طوعًا في السنة الرابعة، ليبقوا في الكلية، ويسهلوا بذلك قيامهم بمهمات قيادية حزبية. هؤلاء هم أصحاب الجاذبية الأقوى بين الطالبات. هم أزيار نساء، وبعضهم مزواج. يكفي أن يبتسم أحدهم لطالبة، حتى تقع”. في الفصل الرابع، “الاستقرار” في مركز الشياح (1975)، تروي قصة احتلال منظمة العمل الشيوعي، ومعها الحزب الشيوعي اللبناني، مدرسة الشياح التكميلية وتحويلها مقرًا حزبيًا. تكتب: “يعني احتلال المدرسة الانتقال إلى العيش فيها؛ كما هو الشأن في البيت. العائلة كلها تشترك في هذا الاحتلال: أنا وابني وزوجي، نحمل ملاحفنا وفرشنا وأغراض يومياتنا الصغيرة، ونستقر في مدرسة الشياح، وكلّنا إيمان بأننا، إذا قمنا بالمهمات الحزبية الموكولة إلينا على الوجه المطلوب، فمن المؤكّد أنّنا سوف ننتصر على اليمين اللبناني، ونحوّل بلادنا إلى قاعدة صلبة للانطلاق منها إلى تحرير فلسطين”.
تحت سقف واحد
في الفصل الخامس، الحياة الحزبية داخل مركز الشياح (1975)، تورد البزري ومضات من حيات رفاق ورفيقات عاشت معهم حلو الأيام الأولى للحرب ومرها، متكلمة عن الرفيقة “زينب” التي أنشأ والدها معملًا للخياطة في إحدى غرف منزله، وزوجها الرفيق “مرتضى”، والرفيقة الشيوعية الجبلية “وردة” التي ما كانت تطيق الشياح أصلًا، وزواجها المدني بالرفيق “مراد” الذي استشهد أخوه “أحمد” بسبب نزيف بطيء جراء إصابة “طفيفة” في الفخذ. ربما يكون عنوان الفصل السادس، مع الحزب الشيوعي تحت سقف واحد (1975)، مثيرًا، لكن البزري تبدأ هذا الفصل تعبيريًا بالإيضاح: “قبل اندلاع الجولة الأولى من الحرب، كنّا أكثر فلسطينيةً. كانت المنظمات الفلسطينية المسلحة تؤنسنا، وتدغدغ أحلامنا السياسية. كانت قريبةً إلى قلوبنا، تصنع موقفنا وتؤكّد عقيدتنا، على عكس الحزب الشيوعي اللبناني الذي وافق، خلف الاتحاد السوفياتي، على تأسيس دولة إسرائيل، والذي غمْغم طوال الأعوام الأخيرة: أيدعم الفلسطينيين في كفاحهم المسلح، أو لا يدعمهم؟ وهذه نقطة نؤاخذه بها، ونرددها ببداهة، لا تغيّرها لَحْلحة الحزب عشية الحرب وتشكيله مجموعاته المسلحة، وتلقّي أعضاء منه دورات تدريبيةً عسكريةً في موسكو“. أما في السابع، مهمات خارجية خاصة (1975)، تبدو الحياة الحزبية غاية في التشويق بالنسبة إلى البزري. تتكلم على “مهمة جديدة تمامًا بالنسبة إليّ. لكنها من صميم نضالي الحزبي. مطلوب منّي، أنا والرفيقة نجاة، أن نهرِّب سلاحًا وذخيرة إلى بيروت الشرقية، وهذه أغرب المغامرات. الرفاق يحتاجون إلى رفيقات لتهريب السلاح ولا يحتاجون إلى رفاق؛ لأنهنّ ببساطة لا يُثرن الشُبهة على الحواجز المعادية. والرفيقات أيضًا، في هذا المجال، كنزٌ لا يفنى! وليس ذلك بسبب اشتغال الرفاق بالمعارك العسكرية. فمتى ارتدين الثياب المناسبة، واستعددن للنطق بالفرنسية عند أيّ حاجز، مع التكلّم بفرنسية متقنة، تبدّدت الشبهات حولهن”.
مهمات وخطف على الطرقات
في الثامن، مهمات فلكلورية خطرة (1975)، تروي قصصًا عن مهمات من نوع آخر، مثل “خطة منظمتنا وحلفائها في الحركة الوطنية، وهي خطّة تقضي منْع احتكار التجار السلع الأساسية. فُقِد الخبز من الأسواق وتعطّلت الأفران، والأهالي يشترون الطحين ويخبزونه في بيوتهم؛ فارتفع سعر الطحين، وصار يُباع في السوق السوداء. وبعد تدارسٍ مع الحلفاء، يكون القرار متمثّلًا في خوض الأمن الشعبي، معركة الكشف عن المحتكرين، وعن مخابئ بضائعهم ومصادرتها لمصلحة الشعب. وفي التاسع، مشاهد من الحياة اليومية في المركز الشيوعي (1975)، تقول البزري: “كان انقطاع الماء أمرًا جديدًا بالنسبة إلينا. كلّ يوم نقول إنّه آخر يوم، وإنّ الأمر لن يدوم طويلًا. نتخيل في سرّنا، ونتمنى، دولةً ما زالت قائمةً. لكن عبثًا”. لكن الأكثر إلحاحًا هو الضوء الذي نحتاج إليه الآن أكثر فأكثر؛ بعد أن بدأ يحلّ فصل الشتاء، وصارت الشمس تغيب في الرابعة من بعد الظهر تقريبًا. الشمع هو الوسيلة البديلة من الضوء الكهربائي، لكنه ليس عمليًا؛ إذ كاد يتسبب قبل يومين بحريق كبير، لولا فطنة أحد الرفاق. في العاشر، الرفيق علي يخطف الرفيق جورج (1975)، تروي البزري قصة الرفيق عليّ، أحد أبناء عشيرة الحلايب، الذي بلغه أنّ ابن عمه عباس اختُطف عند حاجز لميلشيات “القوات” اليمينية في الكرنتينا، “فتكون ردّة فعل الرفيق عليّ مباشرةً وبسيطةً. يترك بوابة المركز حاملًا رشاشه الكلاشنكوف، ويتوجه إلى منطقة خلدة، ليكوّن مع ابن خاله هناك حاجزًا عسكريًا. يوقف السيارات، ويدقق في هويات المارة. وعندما يحظى براكب مسيحي، يخطفه ويذهب به إلى قريته البقاعية، ويعرض المخطوف على أهله بافتخار، ويتداول معهم أمْر تبادله مع ابن عمه العالق بين أيادي خاطفيه”. ويظهر أن المخطوف ليس إلا “الرفيق” جورج، أحد رفاق دلال وعلي في المنظمة.
من أين؟
في الحادي عشر، “لا رفيقات في القيادة!” (1975)، قصة اللقاء مع الصحافية الفرنسية كارين من “ليبراسيون”، وادعاء الرفاق أن الرفيقتين “دلال” و”زينب” تقودان مجموعات نسوية، وهذا ما كان صحيحًا إلى حد ما. في الثاني عشر، رأس السنة (1975-1976)، وصف لتحضيرات الاحتفال بآخر أيام عام 1975، “وعلينا أن نحتفل به. الأيام التي سبقته كانت تضج بالقصف والقنص والمعارك الخاطفة في الثغرة، بين الشياح وعين الرمانة، على خط التماسّ بينهما، بوتيرة عالية؛ كأنّ عقول الجميع، يمينًا ويسارًا، تتابع الأيام الأخيرة للعام المنصرم، يومًا إثر يوم، وتضع في نهايته إشارةً إلى الروزنامة، أو سهمًا، تأكيدًا أنّ هذا اليوم لن يمرّ من دون تكبيد الأعداء خسائر فادحة”. في الفصل الثالث عشر، امتيازات الرفاق القادة (1976)، تورد البزري هذه الهواجس في حوارها مع الريقة زينب: “هل تذكرين عندما حضر الرفيق نديم إلى مركزنا، منذ شهرين، بأيّ سيارة أتى؟ هو أيضًا مثل الرفيق فريد، كانت معه مرسيدس سوداء، ومرافق وسائق […] من أين جاؤوا بالأموال لشراء هذه السيارات؟”. وفي الرابع عشر، الأيام الأخيرة في مركز الشياح (1976)، سقطت البزري من أعلى الساتر الترابي، وانزاح “غضروفها”: “كانت هذه المرة الأخيرة التي أرى فيها مركز الشياح بصفته مركزنا. فالديسك يشلّني، ومن مقتضيات علاجي أن ألازم الفراش من دون حراك – حتى لأبسط الحاجات – مدة شهر بأكلمه”. أما الفصل الخامس عشر، من “الهدوء الحذر” إلى الملجأ (1976)، ففيه تدخلُ القوات السورية العمقَ اللبناني، ويصل القصف العشوائي إلى الضاحية الجنوبية، وتقترب من نقطة دعمها للميليشيات اليمينية حول “تل الزعتر”، بينما تجتمع البزري مع عائلتها في “كوريدور” المنزل في منطقة الكولا، بانتظار توقف القصف السوري للمدينة الرياضية، في أول تجاربها الحربية خارج المركز الحزبي.
قصص الناس
في الفصل السادس عشر، قصص أهل الملجأ (1976)، ترسم البزري صورًا لرواد الملجأ: أبو سمير الذي لا يتحمل الملجأ ولا أهله، ويصمد أربعة أيام، ثمّ ينسحب حريصًا على أناقته بعد ما “تبهدل”؛ وأمّ أحمد شبه المقعدة، ذات الوجه السمح، الناصع البياض، لا يغيب عنه الرضا بنصيبها؛ وجورجيت وزوجها الياس الذي خسر محله التجاري؛ وأمّ غاريوس التي ترفض الالتحاق بزوجها في السويد. في الفصل السابع عشر، “المجنونان” أبو عمر وجانيت (1976)، سيرةٌ لـ “أبو عمر” الذي يشتم المسيحيين في الملجأ، بينما نصف الملتجئين إليه مسيحيون. تكتب البزري: “ينطلق لسان أبي عمر بأنواع من التحليلات السياسية المرفقة بالشتائم والأدعية القاتلة ضدّ القوات السورية التي دخلت عنوةً إلى لبنان لإنقاذ أحزاب المسيحيين، والتآمر على المسلمين والفلسطينيين أصحاب الحقّ. سكان الملجأ كلّهم لا يخالفونه الرأي، وإن كانوا محرجين من صفة ’المسيحي‘ التي يلصقها بأحزاب اليمين. وكلّما جاء بهذا النعت، كان أبو أحمد، أو أبي، يتلفّظان بكلمة من قبيل ’إخواننا المسيحيين‘، أو ’الطائفة الكريمة‘، وينظران إلى جيراننا المسيحيين بعين العطف؛ ذلك أنّهما لا يريدان إشعارهم بالحرج”. أما جانيت فمصرة على أن جواز سفرها والفيزا إلى البرازيل جاهزان، لكنها تنتظر انتهاء العام الدراسي. في الثامن عشر، سقوط مخيم تل الزعتر الفلسطيني (1976)، تروي البزري قصة حصار المخيم وسقوطه من خلال قصة الرفيق “تلاتْعَش” الذي علق في تل الزعتر، وخرج منه حيًا ميتًا مع الناجين من المجزرة إلى مخيم شاتيلا. أما في الفصلين التاسع عشر والعشرين، رواية الرفيق “تلاتْعَش” لحصار مخيم تل الزعتر (1976)، فيروي “تلاتْعَش” المآسي التي شهدها منذ اللحظة التي دخل فيها المخيم لإخراج خالته وعائلتها منه، وحتى خروجه، بفعل الحصار والقصف الهمجي من القوات اليمينية والقوات السورية.
الاغتيال والاحتلال
في الفصل العشرين، اغتيال كمال جنبلاط (1977)، تكتب البزري: “على الرغم من أنّني علمانية، وفي حزب لا يعتدّ بموازين الطوائف، فإنّني أقول في نفسي إنّ هذا النوع من الاغتيال يعني إلغاء كلّ من كان قويًّا في لبنان، كلّ من تجرأ وصاغ مواقف منسوجةً في حياكته الوطنية، وليس على مقاس هذه القوة أو تلك. جنبلاط بالنسبة إلينا هو الواجهة الوطنية التي تحمينا – نحن الأحزاب اليسارية – من حسابات البيادر الطائفية. هو رجل مركّب من تناقضات شتّى أشدّ تركيبًا؛ روحانية، علمانية، درزية، بكاوية، إقطاعية، اشتراكية، وزعامة على رأس أكبر تجمع تقدمي عرفته بلادنا. ننظر إليه بعين مزدوجة، لكننا نشعر بوجوده كأنه يظلّلنا، يحتضننا. وخسارته تدخل في الخانة العقلانية، أكثر من دخولها في الخانة العاطفية”. في الفصل الحادي والعشرين، أترك منظمة العمل الشيوعي (1981)، تعترف البزري: “أخرج من المنظمة كأنني أواجه الحياة بمفردي. زوجي يبقى فيها، فتمتد غربتي داخل البيت. أترك المنظمة وحدي، وليس مع مجموعة كما حصل في السبعينيات؛ فلا أحدث جلبةً. هكذا، أخرج ببساطة أكبر ممّا دخلت، إلا أنني أخرج بإحساس مختلف، فتحوّلت الآمال العارمة إلى فشل سياسي ذريع؛ فشل تجربة دامت ثلاث عشرة سنةً، عليّ اجتراع مرارتها”. في الفصلين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1982)، تشهد البزري وصول الإسرائيليين إلى بيروت واحتلالها. تكتب: “أستمع من خلال الراديو إلى نداء يوجهه محسن إبراهيم، الأمين العامّ لمنظمة العمل الشيوعي، يدعو فيه رجال لبنان إلى حمل السلاح دفاعًا عن لبنان كله؛ سلاح يكون تنظيمًا للمقاومة الوطنية اللبنانية ضدّ الاحتلال […] لا أنتظر باقي النداء. ولا أهتمّ بتوجيه النداء إلى الرجال فحسب، ولا بأنّني قد تركتُ المنظمة”. وحين تتقدم من رفاق الأمس طالبة تلبية النداء، يأتيها الجواب: “لكنه قال ’يا رجال لبنان‘، ولم يقُل ’يا رجال ونساء لبنان …‘ ها ها ها!”.
48 ساعة وإلا!
في الفصلين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، خطف إسماعيل (1982)، تروي البزري معاناتها حين تعرض زوجها للاعتقال في وزارة الدفاع اللبنانية بعد مجزرتي صبرا وشاتيلا، بتهمة أنه شيوعي تآمر على اغتيال بشير الجميل. تكتب: “أفهم، بعد خروجي من سجن اليرزة أنّ إسماعيل سوف يبقى فيه إلى أجل غير مسمّى، كما يجيب أحد الضباط عن سؤالي. عليّ أن أتّخذ قرارًا بالتخلي عن الاتصالات الشخصية، والقيام بعمل جماعي؛ خصوصًا أنّ كلّ يوم يأتي بخبر جديد عن مخطوف أو مفقود أو معتقل […] وجلّهم من الجهة الغربية، من بيروت الغربية، حيث أعلى نسبة من اليساريين المؤيدين للفلسطينيين. أقرّر أن أبعث بنداء إلى إذاعة ’المرابطون‘، أدعو فيه جميع النساء اللواتي لديهن مخطوف أو مفقود […] إلى التجمع على مدخل الإذاعة، قرب بناية جامع عبد الناصر الواقع على كورنيش المزرعة”. في اليوم التالي، تفاجأ بعدد كبير من النساء قد اجتمعن هناك، اتشحن بالسواد، يحملن صور أحبائهن […] وتتألف “لجنة أهالي المخطوفين والمعتقلين والمفقودين”. في الفصل السادس والعشرين، التهجير من حارة حريك (1984)، تروي البزري دخول مسلحين من حركة “أمل” بيتها بعد “انتفاضة 6 شباط” وإجبارهما إياها على الخروج من المنزل بقوة السلاح، في خلال 48 ساعة. تكتب: “أسأل أحد الوجهاء: كيف تُفسِّر استهدافنا نحن؛ استضعافنا نحن؟ فيكون جوابه مؤكّدًا لحدس أمي الطائفي: أنتم شيوعيون، وسنّة، وزوجك كان مخطوفًا، والمنظمة التي كنتِ أنت وزوجك منتسبَين إليها، أصبحت الآن هامشيةً، ضعيفةً، إذا ما قيست بـ “أمل” وبالتكوينات الطائفية الصاعدة”.
امتحان الأمومة في الحرب
في الفصل السابع والعشرين، ميشيل سورا (1985)، تتحدث عن علاقتها بأستاذها ميشيل سورا، الباحث الفرنسي في العلوم السياسية، الذي يتقن العربية باللهجة السورية، والمتزوج بسورية حلبية، والذي يعشق كلّ ما هو عربي … يعيش كل ما هو شرق أوسطي، وعن خطفه ومساعيها لإطلاقه، وأخيرًا وفاته بعدما قيل إن منظمة الجهاد الإسلامي خطفته. تختم البزري هذا الفصل بالآتي: “في خريف 2005، يعلن حزب الله أنّ جثة ميشيل سورا موجودة في ورشة عمار في برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية من بيروت. تُنتَشل الجثة، ويجري فحص الحمض النووي، ويتمّ التأّكد من هوية صاحبها، لتُنقل بعد ذلك إلى باريس حيث تتمّ مراسم دفن رسمية. هكذا، تبكل دائرة القدر مع ميشيل سورا، وتنتهي حياة أحد عشّاق الشرق، على يد مجموعة من أبنائه”. في الفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، خطف ابني همام (1987)، تقص البزري قصة خطف منظمة الرأي الانتحاري ابنها همام ومطالبتها بفدية قيمتها 88 ألف دولار لإطلاقه، والسبب أن بعضهم ظن أن البزري التي تعمل في مركز بحوث وزوجها الذي عمل في الكويت، موثران وقادران على دفع الفدية. لكن الاتصالات الحثيثة أسفرت عن خروج همام، بلا فدية. في الفصل الثلاثين، الأمومة في الحرب، تكتب البزري هواجس الأم التي تعايش الحرب: “في أثناء القلق على ابني، وبعد ذلك على أخته أيضًا، أنسى نفسي. تنقلب شخصيتي من القوة والتكيف وسرعة الحركة إلى تشنّج وألم في البطن يشبه التمزق الحادّ، مع قدرة ذهنية عالية على استحضار المصائب الممكنة كلّها. تتجمّد الحياة ومجرياتها كلّها، ولا أرى شيئًا، إلا ما يشغل بالي. يسيطر الوسواس عليّ، فأبحث في الإشارات القليلة، الحسّية والغيبيّة، عن دليل على أنّ ابني، ومن بعده ابنتي، بخير، وأنّ كلًا منهما لم يصبه مكروه، وأنهما عالقان فحسب، غير قادرين على الاتصال أو التنقّل، وسوف يكونان بعد دقائق في طريقهما إلى البيت”. وتختم البزري الفصل الأخير، الوقت الملائم للحرب، بالقول: “الحنين إلى الحرب، إلى ما كنتُ عليه من أملٍ وقت الحرب، هو حنينٌ إلى ذلك الشعور الرائع بأنني كنت شابةً، وأنّ الوقت أمامي […] حتى لو لم يكن الأمر كذلك في الواقع، في أثناء الحرب أو بعد انتهائها. أحلم الآن بالبلاد التي لا وقت فيها. ربّما كانت الجنة كذلك”.
للمزيد من الكتب.. زور منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English