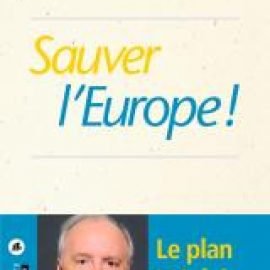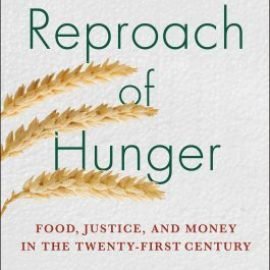الوصف
دين الحياء – من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني (2) التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال
ثمة تجليات عدة لثورة غير مسبوقة يشهدها الإنسان المعاصر حاليًا، لاسيما في وسائل الإعلام والاتصال، اختصرت الوقت والجهد، وقرّبت بين الشعوب والحضارات، ولكن وسط منافع هذه “الثورة” الكثيرة، تبرز سلبياتها التي ضربت أخلاق الإنسان في مقتل، وغيّرت شكل العلاقات بين الأفراد حتى داخل الأسرة الواحدة.
هذه الإشكالية وكيفية التصدي لها، شكلّت محور كتاب “التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال” للأكاديمي المغربي والفيلسوف المعاصر د. طه عبد الرحمن، وهو الكتاب الذي يمثل الجزء الثاني من مشروعه الجديد، المعنون “دين الحياء – من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني”.
يقدم طه عبد الرحمن في هذا الكتاب الذي قسمه إلى ثلاثة أبواب موزّعة على تسعة فصول، تشريحًا لهذه الثورة، وما أنتجته من تحديات أخلاقية، استلزمت فكرًا جديدًا يتصدى لها، خاصًة في العالم الإسلامي الذي تأثر تأثيرًا كبيرًا بمساوئ وسلبيات هذا التقدم.
ويؤكد الكاتب أن ذلك التطور الهائل الذي حدث في وسائط الإعلام، ووسائل التواصل كان له بالغ الأثر في نشوء ظاهرة “حب الصورة”، مشيرًا إلى أن الحضارة المعاصرة، نقلت الإنسان المعاصر من وضعية الناظر إلى وضعية المتفرج، و”التفرّج” هنا عبارة عن علاقة للنظر بالصورة أو الشاشة بشكل غير مسبوق.
وفي أول أبواب الكتاب، يتناول المؤلف ظاهرة “التفرّج” تلك، والتي ارتبطت بالتقنيات الهائلة في وسائل الإعلام، فيحدد في الفصل الأول الخصائص التي تميزت بها علاقة الإنسان المعاصر بالشاشة. ويعدّد عبد الرحمن خصائص ست لهذه العلاقة، أولها “التوسط بالصور”، حيث أصبحت الصور واسطة المتفرج في علاقته بذاته، وبالآخرين. والخاصية الثانية هي “تملّك المُصورات”، فالمتفرج بعد التقدم الهائل المُتحقق في هذا الصدد، أصبح نظره مزودًا باللمس، ما يجعل من عينيه وكأنها مثل اليد تمسك بالمنظور.
أما الخاصية الثالثة فهي الإضرار بالقدرات، ويعني ذلك التأثير السلبي لإدمان الصور على القدرات الجسمانية والنفسية والفكرية، فيما الخاصية الرابعة هي “استبدال الوهم مكان الحقيقة”، بمعنى أن المتفرج أصبح يقدم الصورة على المصور، بل إنه قد يستغني بها عنه.
وأما الخاصية الخامسة فهي الوقوع في التلصص، بمعنى أن المتفرج أصبح يتلذذ بالنظر إلى الصورة بنفس قدر تلذذ المتلصص بالنظر إلى المصور. وأخيرًا، فإن الخاصية السادسة هي التعرض للعنف، فتدفق الصور يورث المتفرج شهوة البطش فينقل هذه الشهوة إلى تعامله مع الآخرين.
من الخيانة إلى “الأمانة”
في الفصل الثاني من كتابه، يؤكد عبد الرحمن أن إخراج الإنسان المعاصر مما يصفه بـ”حال الخيانة” إلى حالة الأمانة، يستلزم التصدي لظاهرة التفرّج وما سببته من ضرر فاحش للإنسان المعاصر.
إن أسباب التفرّج وآفاته – طبقًا للمؤلف- باتت تغزو المجتمعات المسلمة بحكم وسائط الإعلام والاتصال، وسلطان “العولمة“، وأصبحت تهدد هذه المجتمعات كافة، لأنها تهدد وجود القيمة التي تتأسس عليها الأخلاق بكليتها وهي قيمة الحياء.
إزاء هذا الوضع، بات على الفقيه الائتماري أن يواجه ظاهرة التفرّج هذه، وأن يسهم في دفع سلبياتها عن الإنسان المعاصر.. ولكن هل ينجح هذا الفقيه في صرف المسلم عن التفرج ونقله إلى “صفة المشاهد”.
ويجيب عبد الرحمن على هذا التساؤل موضحًا أن الطريق الذي يتبعه الفقيه الائتماري لا يمكنه من دفع الآفات التي نفذت إلى نفس المتفرج، ويرى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الفقيه الائتماري يكتفي باستنباط الأحكام التي تقع على التفرج موقع الأوامر.
وهذه الأوامر تقهر إرادة المتفرج فضلاً عن أن إصدار الفتاوى قد تبقي أقوالًا مجرّدة لا تحمل هذا المتفرج على العمل، ولا تنجح في تغيير سلوكه، وينتهي المؤلف من هذا التحليل إلى أن الفقه الائتماري يعجز عن نقل الإنسان المعاصر، من الحالة الاختيانية إلى الحالة الائتمانية.
ويختتم عبد الرحمن الباب الأول من كتابه هذا بالفصل الثالث، الذي خصصه لبيان كيف أن الفقيه الائتماني يستطيع إنجاز المهمة التي فشل الفقيه الائتماري في تحقيقها، وهي دفع الآفات عن المتفرج وتحويله إلى الحالة الائتمانية التي يكون فيها على صفة المشاهد.
ويوضح فيلسوفنا أن الفقيه الائتماني، على عكس نظيره الائتماري، يقيم مع المتفرج علاقة ذات سمات ثلاث أساسية هي “الائتمان”، و”العمل”، و”الإبصار” ما يعني أنه يقيم فضاءً ائتمانيًا يضع المتفرج أمام مسؤوليته الأصلية، مذكرًا إيّاه بواجباته الحالية وآداب الحضور الذي يجمع بينهما.
وهذه السمات الثلاث التي تحدد علاقة الفقيه الائتماني بالمتفرج، تجعل الفقيه يأخذ بترتيبات المفاهيم التي تتطلبها تلك العلاقة الدينية الخاصة، وهي ترتيبات تتميز عن تلك المعهودة لها ومنها تقديم العمل على القول، وتقديم النظر على السمع، وتقديم الناظر على النظر، وتقديم الباطن على الظاهر، وتقديم الأسماء الحسنى على الأوامر، وتقديم الشاهدية على الآمرية.
وهكذا يتصدى الفقيه الائتماني لخصائص التفرج التي تمثل آفات يدفعها عن المتفرج، ناقلاً إيّاه إلى رتبة المشاهد الذي استولى على قلبه الحياء من الشاهد الأعلى جل جلاله، وعليه يكون الفقيه الائتماني أقدر من غيره على نقل الإنسان المعاصر من حال الاختيان إلى حال الائتمان.
“التجسس”.. ظاهرة عالمية
ينتقل طه عبد الرحمن إلى الباب الثاني من كتابه، والذي خصصه للحديث عن ظاهرة خطيرة أسهمت ثورة الإعلام والاتصال في تكريسها، وهي “ظاهرة التجسس”. فإذا كان التفرج آفة نفسية تصيب الناظر المعاصر الذي ينظر إلى الصور مستمتعًا بهذا النظر، فإن التجسس – كما يراه عبد الرحمن- آفة نفسية تصيب الناظر المعاصر الذي يستخبر عن الأشياء المصورة مستمتعًا بهذا الاستخبار، سواء كان نظره إليها نظرًا مباشرًا أو غير مباشر.
ويوضح الفيلسوف في الفصل الرابع أن التجسس يبنى في الأصل على مبدأ المراقبة، والمراد بـ”المراقبة” هو الملاحظة التي تتم بواسطة العين، سواء كانت مجردة أو مزودة بآلات، وسواء كانت مفردة أو مزدوجة بمدارك أخرى، والتي يكون فيها الملاحظ ناظرًا إلى غيره وغير منظور من هذا الغير، بحيث يراه دون أن يراه الآخر المُراقب.
وظاهرة التجسس، التي يصفها عبد الرحمن بأنها أحد التحديات الأخلاقية الفاحشة التي تواجه الإنسان المعاصر، تتميز بخصائص خمس هي “الغلو في المراقبة”، “النفوذ إلى الباطن”، “النفوذ إلى الحياة الخاصة”، “طلب الإحاطة بكل شيء”، “الرغبة في التحكم بكل شيء”.
وإذا كانت ظاهرة التجسس من أشنع التحديات التي تواجه الإنسان المعاصر كما يصفها المؤلف، فإن إخراج هذا الإنسان المعاصر منها يعني خروجه من حال الخيانة إلى حالة الأمانة، لكن الفقيه الائتماري وكما حدث مع ظاهرة التفرج يكتفي باستنباط الأحكام وإصدار الفتاوى، لذلك لا يستطيع إخراج المتجسس من حال الخيانة إلى حال الأمانة.
إن فتاوى الفقيه الائتماري – كما يقول عبد الرحمن- تقع على المتجسس موقع الأوامر التي تضر باستقلال إرادته، أو موقع الأقوال المجرّدة التي لا يرى أنها قادرة على أن تُثنيه عما يأتيه من أفعال قبيحة.
إن الحضارة المعاصرة رغم منافعها الكثيرة تظل حضارة أموات لا حضارة أحياء، كما يؤكد عبد الرحمن في الفصل السادس من كتابه، مبررًا تلك النتيجة التي توصل إليها بأن الحياة نور محله الروح وهي نفخة إلهية، ولا نور للروح مطلقًا بغير وجود الحياء.
ويشير الفيلسوف إلى أن هذه الحضارة خرجت من الحياء، وأن المتجسس هو ابن هذه الحضارة الخارجة من الحياء، لذلك فقدت روحه نورها، ولن يعود هذا النور إلا عندما يعود الإنسان المعاصر إلى خلق الحياء.
ويستعرض العلاّمة المغربي في هذا الفصل الطريق الذي يسلكه الفقيه الإئتماني في مواجهته لظاهرة التجسس، والتي حددها بخمس خصائص هي “الغلو في المراقبة”، “النفوذ إلى باطن الأشياء”، “النفوذ إلى الحياة الخاصة”، “طلب الإحاطة بكل شيء”، وأخيرا “الرغبة في التحكم بكل شيء”.
ويستخلص عبد الرحمن في هذا الجزء من كتابه أن الطريق الذي يسلكه الفقه الائتماني طريق اشتغالي، وجداني، يقيم علاقة مباشرة بالمتجسس، وهو ما يقتضي أن يجاوز الفقيه ملاحظة سلوك المتجسس الخارجي، إلى معالجته من الآفات النفسية التي تتسبب في انحراف هذا السلوك.
وهذه الآفات يعتبرها عبد الرحمن منازعات للخالق سبحانه وتعالى في صفاته التي تدل عليها أسماؤه الحسنى، وهي آفة منازعة الرقيب، وآفة منازعة الخبير، وآفة منازعة اللطيف، وآفة منازعة العليم، وآفة منازعة المهيمن.
ويقف فيلسوفنا هنا موضحًا الطرق العملية الخاصة التي يتعامل بها الفقيه الائتماني مع المتجسس في كل واحدة من هذه الآفات، حتى يدفعها عنه، لينقله هذا بالتدريج من رتبة المتجسس أو الناظر الذي نزع منه الحياء، إلى رتبة الشاهد أو الناظر الذي يستحي من ربه ناظرا إليه.
التكشّف العمومي
يخصص المؤلف الباب الثالث والأخير من كتاب “التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال” للحديث عن تحدٍ آخر من تحديات ثورة الإعلام والاتصال، والتي يسميها “التكشّف”، ويعرفها بأنها آفة نفسية تصيب المنظور إليه.
ويوضح العلامة المغربي أن الخاصية الأولى التي تميز التكشّف المعاصر هي أنه تكشف كلي، من جهتين، إحداهما أنه تكشّف إحاطي، بمعنى تعاطي المواطن إبداء كل شيء من خاص حياته جسميًا كان أو نفسيًا، بحجة ممارسة “حقه في الحرية” و”تلبية رغبته في الصدق”.
والجهة الثانية أنه تكشّف عمومي، بمعنى تعاطي المواطنين التكشف بعضهم لبعض بحيث يتكشف الجميع للجميع، وهنا يؤكد عبد الرحمن أن “التكشّف في المجتمع المعاصر ليس مجرد مسألة سلوكية، وإنما هو مسألة وجودية”.
“ورغم أن المتكشف يتعلق بالآخرين في وجوده، فإنه لا يتعلق بهم لذواتهم بقدر ما يتخذهم واسطة إلى التعلق بذاته هو، إن صورًة أو نظرًا أو جسما”. هكذا يؤكد العلامة المغربي موضحًا أن المتكشف علاوة على ما تقدم يسعى إلى استهواء الآخرين جلبا لأنظارهم أو أسماعهم، أو حملاً لهم على ممارسة التلصص معه.
ويسير الأكاديمي المغربي في الفصلين الثامن والتاسع من الكتاب على نفس منوال في الفصول السابقة، فيتناول أولًا كيفية مواجهة الفقيه الائتماري لآفة التكشف، مبينا خصائصها الخمس وهي “إبداء الكل، إبداء الباطن، حب الوجود، حب الذات، واستهواء الآخر”.
وينتهي عبد الرحمن إلى نفس النتيجة، حيث يعجز الفقيه الائتماري عن دفع شرور آفة التكشف مثلما عجز عن دفع شرور آفتي التفرج والتجسس. ويوضح هنا أن أحكام الفقيه الإئتماري، وإن بدت في بعض خصائص هذه الآفة جازمة كما في تحريم التبرج والمجاهرة وذم العُجب، فإنها في بعضها الآخر تتأرجح بين التحريم والتجويز والعفو لاعتبارات مختلفة كما في حب الدنيا وطلب الشهرة.
إن هذه الأحكام – كما يرى الكاتب- لا تؤثر في المتكشف إلا بالقدر التي تؤثر فيه الأوامر المجرّدة التي يُعتقد أن الوقائع قد تجاوزتها، فضلاً عن كونها لم تأخذ بعين الاعتبار معانٍ أساسية ارتبطت بالتكشف مثل نزع اللباس، وتحدي الأخلاق، والتخلق بأخلاق إبليس الرجيم.
ويصل عبد الرحمن إلى نهاية كتابه موضحًا في الفصل التاسع أن الفقيه الائتماني هو الأقدر على مواجهة ظاهرة التكشف، بما يقيمه من اتصال وجداني مباشر مع المتكشف مراعيًا خصوصية ظروفه وآخذًا بأسباب اللطف والرحمة، حتى يجعله يتبيّن بنفسه أنه ينازع الشاهد الأعلى في اسم عظيم من أسمائه الحسنى وهو “الشهيد”، في دلالته على المشهودية الإقرارية التي له وحده.
كما يدفع الفقيه الائتماني المتكّشف لأن يكون متطلعًا إلى الخروج من وصف المنظور لنفسه وللآخرين، إلى وصف المشهود له سبحانه وتعالى، متوسلاً في ذلك بما شمله به من واسع رحمته، أو ما هداه إليه من دائم ذكره، أو ما وهبه من خلق الحياء منه، أو ما أضفى عليه من سابل ستره.
إن الفقيه الائتماني يمتلك قدرة فائقة على معاملة الإنسان المعاصر، ومن ثم إخراجه بالتدريج من حالة الخيانة إلى حالة الأمانة، ليعود به إلى حيث الحياء قيمًة راسخًة في نفسه، والتكشف سلوكًا منبوذًا نظرًا لآفاته المدمرة.
دين الحياء – من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني (2) التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال
للمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English