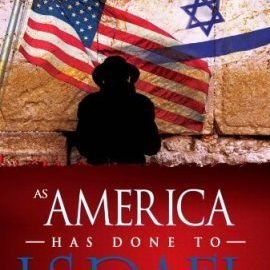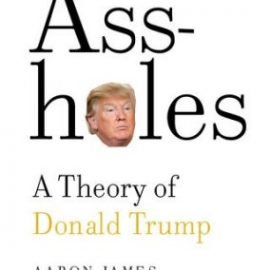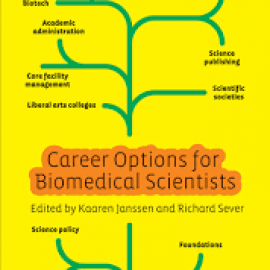الوصف
في كتابه “روح الحداثة”
طه عبد الرحمن يفضح تصدع “مفكري النهضة”.. ويدعو لحداثة مبدعة لا مقلّدة
بأفكارها المنقولة من مصادر غربية بالأساس، ضربت “الحداثة” الفضاء الفكري العربي ردحا من الزمن، فأحدثت فيه زلزالاً فكريًا أدى إلى تصدّع المفاهيم الفكرية لدى البعض ممن أُطلق عليهم “مفكري النهضة العربية”، سعيا إلى “إفراغ العقول” من أجل استقبال هذا الوافد بقيمه المتجردة من الأخلاق، المتعارضة مع الدين، فتمددت الحداثة واتسع نطاقها، ووجدت قُدسيتها في هذه العقول، وكأنها دين جديد، حتى بدت الحداثة – كما يقول المؤلف- وكأنها “كائن تاريخي عجيب يتصرف في الأحياء والأشياء كلها تصرف الإله القادر، بحيث لا رادّ لقدره”.
هذا التصور للحداثة برأي المؤلف تصور “غير حداثي” بالمرة، لأنه ينقل الحداثة من مرتبة المفهوم العقلي الإجرائي إلى مرتبة “الشيء الوهمي المقدس”، وهو أمر غير حداثي بالمرة!
فلم تكن هذه “الحداثة” في حقيقتها كما توهمها بعض مفكري العرب، حتى في الأرض التي انطلقت منها، فعلى هذه الأرض الغربية كان هناك دائما من يتحدث عن شرورها، ونقائصها، بينما يسبّح المفكر العربي بحمدها، ويعدد محاسنها وينقل قيمها، متناسيًا تراثه الإسلامي العربي، داعيًا إلى القطيعة معه معتبرًا أن الحداثة “أشمل وأنفع”.
هذا المفهوم الملتبس، انتج تحديًا كبيرًا اعتبره الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، واحدا من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المسلم الذي أصبح يعيش حالة وصفها بـ”التيه الفكري” المتمثل في فتنة مفهومية كبرى بسبب اتساع نطاق الحداثة، وتمددها في الفكر العربي.
وفي سياق مشروعه الفكري الرامي إلى تأسيس “حداثة إسلامية” وإعادة الصلة المقطوعة مع التراث، وبيان نقائص الأفكار الغربية الحداثية، التي نقلها بعض المفكرين العرب دون وعي أو إدراك، أو مراعاة للفوارق المكانية أو الزمانية، وضع عبد الرحمن، كتابه “روح الحداثة – المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية” لينضم إلى كتبه العديدة التي تمحورت حول أبعاد تلك القضية بالغة الأهمية.
في بداية كتابه أوضح عبد الرحمن أن “المجتمع المسلم لن يستطيع التخلص من تلك الحالة الفكرية، وهذا التخبط نتيجة التباس المفاهيم المنقولة، إلا إذا استطاع أن يبدع مفاهيمه، أو أن يعيد إبداع مفاهيم غيره بوعي وإدراك يساعدانه على الخروج من هذا التيه الفكري، وهذه المتاهات المفاهيمية”.
وأبدى الفيلسوف المغربي تعجبه من زمرة المفكرين الذين ظنوا أنهم “اهتدوا” في هذا التيه، وهم فئة من المقلدين، قسمهم إلى نوعين، أحدهما يضم من يقلدون المتقدمين من المسلمين، وسمّاهم “مقلدة المتقدمين”، وثانيهما يضم الذين يقلدون المتأخرين، من غير المسلمين، وسمّاهم “مقلدة المتأخرين”.
وأوضح المؤلف أن “مقلدة المتقدمين” هم من يتعاطون إسقاط المفاهيم الإسلامية التقليدية على المفاهيم الغربية الحديثة، ضاربا المثل بمن يُسقطون مفهوم “الشورى” على مفهوم “الديمقراطية”، أو من يُسقطون مفهوم “الأمة” على “الدولة”، أو من يُسقطون مفهوم “الربا” على “الفائدة”.
“مقلدة المتقدمين” هؤلاء، يتوسلون في هذه الاسقاطات المختلفة بخطاب يريدون أن تكون له صبغة عملية توجيهية، لكنهم يقعون من حيث لا يشعرون في شرك الوعظ المباشر، ويردّون المفاهيم المنقولة إلى المفاهيم المأصولة، فيصلون في النهاية إلى محو خصوصية المفاهيم المنقولة.
أما “مقلدة المتأخرين”، كما يقول عبد الرحمن، فيتعاطون إسقاط المفاهيم الغربية المنقولة، على المفاهيم الإسلامية المأصولة، ضاربًا المثل هنا بمن يسقطون مفهوم “العلمانية” على مفهوم “العلم بالدنيا”، أو من يسقطون مفهوم “الحرب الدينية” على مفهوم “الفتح”.
“مقلدة المتأخرين” أولئك، يتوسلون في هذه الإسقاطات بخطاب يريدون أن تكون له صبغة عقلية استدلالية، غير أنهم يتعثرون في القيام بشروطها، وينتهون برد المفاهيم المأصولة إلى المفاهيم المنقولة، والنتيجة هي محو خصوصية المفاهيم المأصولة.
“كلا النوعين لا إبداع عنده” برأي المؤلف، فمقلدة المتقدمين يتبعون ما أبدعه السلف، من غير تحصيل الأسباب، التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه، وأما مقلدة المتأخرين فيتبعون ما أبدعه الغرب، من غير تحصيل الأسباب، التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه.
الوقوع في الفخ
كعادته دائما في جميع مؤلفاته، يوضح الفيلسوف المغربي المنهج المستخدم في كتابه درءًا للشبهات أو لهجوم المتربصين، فهدفه ليس النقد من أجل النقد، أو النقد من أجل الهدم، فقط، وإنما هو نقد من أجل البناء، مستندًا إلى المنطق، والحُجة القوية، والتحليل العميق.
يستند عبد الرحمن في وضع مفاهيمه وصوغ أحكامه، إلى قاعدتين منهجيتين نقديتين خاصتين به، كل واحدة منهما – كما يقول- “تفيد في التمرس بالإبداع، بقدر ما تفيد في ممارسة النقد”.
القاعدة الأولى تقول: إن كل أمر منقول معترض عليه حتى تثبت صحته بالدليل. وتوجب هذه القاعدة أن يكون نقده للمنقول هو مطالبته بالأدلة التي تثبت صحته، ثم التعرّض لها بالطرق الاستدلالية المشروعة، من أجل اختبار فائدتها في إثبات هذا المنقول، وهذا النوع من النقد أسماه “النقد الإثباتي”، وهو يدفع عن العقل آفة الإسقاط التي يقع فيها مقلدة المتأخرين.
والقاعدة الثانية تقول: إن كل أمر مأصول مسلم به حتى يثبت بالدليل فساده. وتوجب هذه القاعدة أن يكون نقده للمأصول هو تعليق صحته بانتفاء الأدلة المُبطلة له، ويسمي هذا النوع “النقد الإبطالي” وهو يمنع آفة الإسقاط التي يقع فيها مقلدة المتقدمين. وهكذا يضمن فيلسوفنا عدم الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه من ينتقدهم.
يشرع المؤلف في ذلك مستخدما المدخل التنظيري للحداثة، مستعرضًا التعريفات المتعددة لهذا المفهوم، والتي تُظهر جميعها حقيقة واحدة، وهي أن تلك التعريفات أدت إلى التهويل من هذا المفهوم وكأنها “إله جديد”.
والحداثة، من وجهة نظر عبد الرحمن، هي عبارة عن إمكانات متعددة، وليست كما رسخ في الأذهان إمكانًا واحدًا, ويُستدل على ذلك بأن المشهد الحداثي الغربي فيه من التنوع ما يجعلنا نقول بأن هناك حداثات متعددة وليس حداثة واحدة، فمن اعتبار القُطرية، هناك “حداثة فرنسية”، و”حداثة ألمانية” و “حداثة أمريكية”, ومن حيث المجالات فهناك, “حداثة اجتماعية”، و”حداثة سياسية”، و”حداثة اقتصادية”, وهو ما يقود إلى أن يكون واقع النموذج الحداثي الغربي هو أحد تطبيقات روح الحداثة، ليس إلا.
من هذا المنطلق، يرى فيلسوفنا أنه إذا كان هناك حداثة غير إسلامية, فينبغي أن يكون هناك حداثة إسلامية. فليس من المعقول أن يتقرر في الأذهان أن الحداثة تأتي بالمنافع والخيرات التي تَصلُح بها البشرية, ثم لا يكون هذا الجزء النافع منها متضمّنا في الحقيقة الاسلامية.
وكل تطبيق لروح الحداثة، كما يقول المؤلف، تصحبه اعتقادات وافتراضات خاصة, بحيث تختلف تطبيقات هذه الروح باختلاف هذه الاعتقادات والافتراضات, وقد أطلق عليها اسم “مُسلّمات التطبيق”. وهذه المسلمات قد يكون بعضها فاسدًا, فتتسبب في دخول بعض الآفات على التطبيق, وهذا هو وضع التطبيق الغربي لروح الحداثة, لأنها بُنيت على مُسلّمات باطلة جلبت الضرر للحياة الإنسانية برمتها، كما هم معلوم للكافة.
حداثة مبدعة لا مقلّدة
كيف يمكن تطبيق “روح الحداثة” في المجتمع المسلم؟ بحيث تكون حداثة مبدعة لا مقلّدة؟.. يؤكد عبد الرحمن أنه “لا حداثة إلا بصدورها من الداخل لا بنقلها من الخارج, ولا حداثة إلا مع وجود إبداع لا مع الاتّباع. فلا تكون الحداثة إلا ممارسة داخلية مبدعة”.
هنا يصل الفيلسوف المغربي في هذا الجزء من الكتاب إلى الأصول التي تتأسس عليها نظريته في الحداثة، منطلقًا من التفريق بين “روح الحداثة”، و”واقع الحداثة”. وهذه الأصول العامة تتكون من ثلاثة مبادئ تتحدد بها روح الحداثة، وهي “مبدأ الرشد”، و”مبدأ النقد”، و”مبدأ الشمول”.
وبناء على هذه المبادئ، قام عبد الرحمن بنقد بعض المسلمات التي بُنى عليها التطبيق الغربي لروح الحداثة، مبينًا الكيفيات التي ينبغي أن يتم بها التطبيق الإسلامي لهذه الروح. وقد قسم كتابه إلى ثلاثة أبواب، يختص كل باب بتطبيق مبدأ واحد من المبادئ الثلاثة لروح الحداثة.
وفي الباب الأول من الكتاب، يطبق المؤلف “مبدأ النقد” على نموذجين خصص لكل منهما فصلاً مستقلاً، وهما “نظام العولمة” و”نظام الأسرة الغربية”. ومقتضى هذا المبدأ (النقد) أن الأصل في الحداثة هو الانتقال من حال الاعتقاد إلى حال الانتقاد, والمراد بالاعتقاد هو التسليم بالشيء من غير وجود دليل عملي عليه, ويقوم هذا المبدأ على ركنين رئيسين، الأول هو “التعقيل” ويعني إخضاع ظواهر العالم ومؤسسات المجتمع وسلوكيات الإنسان كلها لمبادئ العقلانية، والركن الثاني هو “التفصيل”، والمراد به نقل الشيء من صفة التجانس إلى صفة التغاير, بحيث تتحول عناصره المتشابهة إلى عناصر متباينة، من أجل ضبط آليات كل عنصر منها على حدة.
ويوضح الكاتب أن التطبيق الغربي لهذا الركن يتأسس على بنيات الأشياء وماهياتها فنجده يفصل بين الحداثة والدين, وبين العقل والدين تفصيلاً مطلقًا, إلا أن التطبيق الإسلامي يرى هذا الفصل قائما على وظائف الأشياء وغايتها, بحيث إذا تغيّرت هذه الوظائف والغايات جاز أن تعود الأشياء المفصولة إلى سابق اتصالها, وبذلك يكون تفصيلاً موجّها.
ويستخلص عبد الرحمن، من تطبيق هذا المبدأ على النموذجين اللذين اختارهما، أن “نظام العولمة دخلت عليه آفات بسبب توسله بالتعقيل المضيّق، ولا يمكن أن يدفعها إلا التعقيل الموسّع الذي يأخذ به التطبيق الإسلامي”.
أما في الباب الثاني من الكتاب فيعمد المؤلف إلى تطبيق “مبدأ الرشد” على نموذجين آخرين هما “الترجمة الحداثية” و”القراءة الحداثية للقرآن”. ومقتضى هذا المبدأ (الرشد) أن الأصل في الحداثة هو الانتقال من حال القصور إلى حال الرشد، والمقصود بالقصور هنا هو اختيار التبعية للغير، وهذا المبدأ – كسابقه- يقوم على ركنين رئيسين، الأول هو “الاستقلال” ويعني أن الإنسان الراشد، يستغني عن كل وصاية، فيما يحق له أن يُفكّر فيه, ويصرف كل سلطة، تقف دون ما يريد أن ينظر فيه. وهكذا، فالإنسان الراشد منطلق الحركة قويّ الذات.
والركن الثاني هو “الإبداع”، ويعني أن الإنسان الراشد يسعى إلى أن يُبدع أفكاره وأقواله وأفعاله, ويؤسسها على قيم جديدة يُبدعها من عنده أو على قيم سابقة يعيد إبداعها، ولكن بالنظر إلى المجتمع المسلم نجد أنه قد تعطّلت قدرة الإبداع لديه, وأصبح يرى أن تقليده للغرب ليس تقليدًا, وإنما هو تجديد يفتح باب الدخول في الحداثة.
هنا يؤكد عبد الرحمن أن التطبيق الغربي لركن الإبداع يقوم على الانفصال التام عن التراث, مهتما فقط بالإبداع في مجال الماديات والشهوات, وهو يكون بذلك إبداعًا مفصولاً, وبالتالي يجعل منه التطبيق الإسلامي إبداعًا موصولاً, لأن الأخير (التطبيق الإسلامي) لا يُقدِّر قيمة الإبداع بمدى انقطاعه عن كل سابق على وجه الإطلاق, وإنما بمدى انقطاعه عن كل سابق استنفد مكامن الإبداع فيه.
ويستخلص الكاتب من تطبيق “مبدأ الرشد” على النموذجين اللذين اختارهما، أن تحديث الترجمة يقتضي أن يمارس المترجم المسلم نوعًا من الاستقلال المسؤول حيال النصوص الأصلية، فيتبع فيها طريق الاستكشاف الذي يوجب وضع ترجمات متعددة لهذا الأصل وليس طريق الاستنساخ الذي ينحصر في وضع ترجمة واحدة للأصل الواحد.
كما يستخلص الفيلسوف من تحليله هذا أن تحديث قراءة القرآن يقتضي أن يمارس القارئ المسلم نوعًا من الإبداع الموصول، فيتبع الخطط الانتقادية المأصولة التي تثبت تكريم الإنسان وتوسيع العقل وترسيخ الأخلاق، وليس الخطط الانتقادية المنقولة التي تمحو القدسية والغيبية والحكمية من النص القرآني.
حق “المواطنة” في الإسلام
يخصص الفيلسوف المغربي الباب الثالث والأخير من كتابه لتطبيق “مبدأ الشمول” على نموذجين، هما “حق المواطنة”، و”واجب التضامن” ومقتضى هذا المبدأ (الشمول) أن الأصل في الحداثة هو الإخراج من حال الخصوص إلى حال الشمول, والمراد بـ”الخصوص” شيئين هما: “وجود الشيء في دائرة محدودة”، و”وجود الشيء بصفات محددّة”, ويقوم هذا المبدأ مثل سابقيه على ركنين رئيسين. الركن الأول هو “التوسّع”، ويعني أن أفعال الحداثة لا تنحصر في مجال أو مجالات معينة, بل إنها تنفذ في كل مجالات الحياة ومستويات السلوك. والحقيقة أن الحداثة لم تستوعب كل مجالات الحياة, فإذا كانت قد استوعبت المجالات العلمية والاقتصادية. فقد بقيت في المجالات المعنوية والاجتماعية شكلية أو سطحية, وهكذا تكون الحداثة قد ورّثت أهل الغرب ضعفًا روحيًا فاحشًا، على قدر هذه القوة المادية الساحقة.
هذا الضعف، كما يقول عبد الرحمن، قائم على مسلّمة مفادها أن ماهية الحداثة ماهية اقتصادية, ويكون بذلك الأمر توسّعا ماديا, فقط. أمّا التطبيق الإسلامي فقائم على أساس أن جسمانية الإنسان تابعة لروحانيته, وأن ماهية الإنسان ماهية خُلُقية, وبذلك يكون توسّعا معنويًا.
والركن الثاني هو “التعميم”، فالحداثة لا تبقى حبيسة المجتمع الذي نشأت فيه, بل إن منتجاتها وقيمها ترتحل إلى ما سواها من المجتمعات. والتطبيق الغربي لهذا الركن ينحصر في دائرة الإنسان فحسب, بل في أمم بعينها, وبذلك يكون تعميمًا بشريًا, أما التطبيق الإسلامي فهو يشمل الكائنات كلها, بشرية كانت أو حيوانية أو طبيعية, جاعلاً منه تعميما وجوديًا.
يستخلص عبد الرحمن من تطبيق هذا المبدأ على نموذجيه أن “المواطنة” في التطبيق الإسلامي ترتقي إلى رتبة المؤاخاة، متحققة بصفة التوسع المعنوي، فهي بفضل عملها بمبدأ “الاخلاص” تتقي الانفصال الذي تقع فيه المواطنة الليبرالية، وبفضل عملها بمبدأ “الأمة” تتقي الانغلاق الذي تقع فيه المواطنة الجماعانية.
كما أن التضامن في هذا التطبيق يرتقي إلى رتبة التراحم، متحققا بصفة التعميم الوجودي، فبفضل استناده إلى علاقة الإنسان بالخالق والمخلوقات جميعًا، يتقي الانفصالات الثلاثة التي يقع فيها التضامن، وهي الانفصال عن التراث، والانفصال عن الطبيعة، والانفصال عن الحيز.
ويتوقع المؤلف في ختام كتابه أن يواجه تساؤلاً عن جدوى كتابه، وجدوى العمل بالتطبيق الاسلامي لروح الحداثة في وقت حل فيه طور “ما بعد الحداثة” محل الحداثة نفسها، لكنه يجيب على ذلك موضحًا أن التجاوز ما بعد الحداثي تعلق أصلاً بالواقع الحداثي الغربي، وليس بروح الحداثة نفسها. كما يبيّن كيف أن مفهوم “ما بعد الحداثة” يبقى هو الآخر تطبيقًا لهذه الروح، مثله في ذلك مثل التطبيق الإسلامي.
ويلاحظ القارئ في هذا الكتاب، على العموم، عمق التحليل الذي يقود المؤلف إلى كشف التناقضات التي بُنيت عليها النظريات المخالفة، وهو في ذلك يُثبت حقيقة أن “ما بُني على باطل فهو باطل”.

 العربية
العربية  English
English