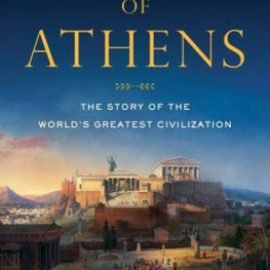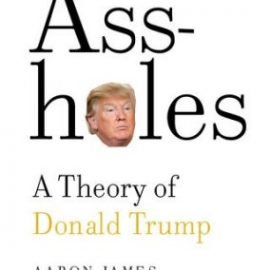الوصف
روح الدين.. من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية
مثلّت العلاقة بين “الدين والسياسة” منذ عدة عقود موضوعًا ثرياً وسجالياً في الفكر العربي والعالمي، وكانت هذه العلاقة محور العديد من الكتابات التي أحدثت جدلاً فكريًا استمر لسنوات طويلة، بل وأصبحت بمثابة “معضلة فكرية” حيّرت العقول، وخلقت منازعات فكرية بين من يدعو إلى الفصل بينهما، ومن يدعو إلى الوصل.
ولم تأت المقاربات التي طُرحت في هذا الصدد بجديد، لجهة كونها لم تتخلص من الانحيازية التي تتبني وجهة نظر خاصة، أو ربما كانت مجرد رد على مقاربة أخرى، لكنها لم تتنج في طرح البديل، ولم تسلك الطريق الاستدلالي.
وهنا، أراد الفيلسوف المغربي العلامة طه عبد الرحمن، أن يدلو بدلوه في هذ الصدد السجالي، مخالفًا كل ما سبق من مقاربات، فجاء كتابه الذي بين أيدينا “روح الدين – من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية” ليطرح مقاربة متميزة عما سبق من مقاربات تناولت العلاقة الجدالية بين الدين والسياسة.
ويأتي التميز في مقاربة عبد الرحمن من كونه – كعادته- يسلك الطريق الاستدلالي، مقيمًا الحجة والبرهان، طارحًا الجديد في “مقاربة روحية” للقضية كما يصفها هو في مقدمة كتابه، مؤكدا أنها ليست تاريخية، ولا سياسية، ولا اجتماعية، ولا قانونية، ولا فقهية، ولا فكرانية.
يقسم المؤلف كتابه هذا إلى بابين يحمل الباب الأول عنوان “ازدواج الوجود الانساني ونهاية التسيّد العلماني”، ويتضمن هذه الباب خمسة فصول. أما الباب الثاني فيحمل عنوان “اتصال التدبير بالتعبد واتساع الوجود الائتماني” ويتضمن أربعة فصول.
يخصص عبد الرحمن الفصل الأول من كتابه لإبطال المسلّمة التي تحصر الوجود الإنساني في عالم واحد، مبينًا كيف أن الحاجة تدعو إلى الأخذ بمسلمة أخرى بديلة، تجعل هذا الوجود يتسع لأكثر من عالم واحد منها المرئي وغير المرئي.
التنزيل والتنزيه
العلاقة بين الدين والسياسة عبارة عن علاقة وجودية بين عالمين متقابلين. هكذا يؤكد فيلسوفنا في هذا الفصل، مبينًا أن الواحد من هذه العلاقة يتخذ عكس الاتجاه الذي يتخذه الآخر، فتكون في الدين عبارة عن “تنزيل” يجعل العالم الغيبي مشاهدًا في العالم المرئي، وتكون في السياسة “تنزيه” يجعل العالم المرئي متواريًا في العالم الغيبي.
وهاتين الوظيفتين للدين والسياسة تترتب عليهما نتيجة مهمة، من وجهة نظر المؤلف، وهي أن الدين والسياسة، لا يشكلان – كما ترسخّ في الأذهان- مجالين مستقلين من مجالات الحياة الإنسانية المعلومة، وإنما هما طريقان متقابلان للفاعلية الإنساني، يتم التوصل من خلالهما إلى تحقيق أغراض كل مجال من مجالات الحياة.
وهذا التحقيق يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين العالمين المرئي والغيبي، على اعتبار أن أحدهما طريق تعبدي والآخر طريق تسيدي، فالإنسان كائن تحددت طبيعته بالممارسة السياسية كما تحددت بالممارسة الدينية إلا أن هذه التحديدات تفرعت كلها على مسلمة خاصة ، وهي أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا إلا في عالم واحد.
ويؤكد فيلسوفنا أن هذه المسلمة تتغافل حقائق إنسانية أساسية، وهي أن جسمية الإنسان ليست غليظة، لذلك يتعين الأخذ بمسلمة تضادها، وهي أن الإنسان يحيا في عالمين اثنين على الأقل، أحدهما عالم مرئي، والثاني غيبي.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، يتعرض طه عبد الرحمن لقدرة الإنسان على أن يرى معاني العالم الغيبي في مباني العالم المرئي، متوسلاً بفطرته الروحية، ومؤكدًا أن الفاعل الديني لا يمتلك القدرة على “التشهيد”، بمعنى القدرة على رؤية العالم الغيبي في العالم المرئي إلا بفضل “مبدأ الفطرة”، التي تنزل منزلة ذاكرة سابقة على وجوده المرئي.
وهذه الذاكرة الفطرية كما يوضح الكاتب، تحتفظ بمعان وأفعال تحدد الغاية من وجود الإنسان التي هي التعبد لله وحده، فقد عرف الكائن البشري الألوهية والوحدانية، وشهد بألوهية الله ووحدانيته وبأحقيته في العبادة، حتى إذا خرج للعالم المرئي وجب عليه أن يطلب الأسباب التي تذكره بما “عرف وشهد”.
لكن الفاعل الديني ولو امتلك القدرة على التشهيد، فإنه لا يمتلك كمال هذا التشهيد إلا بفضل “مبدأ التكامل”، فمقتضى هذا المبدأ أن يطلب في كل مرئي وجه أو وجوه تنزل الغيبي فيه، مُتحققًا بشهود وعموم الوحدانية لله تعالى.
وينتقل المؤلف إلى الفصل الثالث، وفيه يؤكد أن الفاعل السياسي لا يمتلك القدرة على التغييب، بمعنى القدرة على تصعيد العالم المرئي إلى مرتبة الغيبي، إلا بفضل “مبدأ النسبة”، حيث يدخل في نسبة الأشياء إلى نفسه، ويوغل في هذه النسبة سعياً إلى غاية أن يتسيّد على غيره.
ومتى ظفر هذا الفاعل السياسي بهذا التسيّد، تطلع إلى أن يدرك رتبة الحاكم المطلق، وهنا تظهر الشهوات الفاحشة والسلوكيات الصادمة، فيبدو وكأنه يملك أبدان الأحياء، وأرواحهم. وليس هذا فقط، بل يبدو وكأنه يملك قيم الوجود، ومعاني الحياة.
لكن الفاعل السياسي ولو امتلك تلك القدرة على التسيّد، فإنه لا يمتلك كمال التغييب إلا بفضل “مبدأ السلطان”، حيث يجعل من مُلكه ملكوتًا واسعًا، ومن قوته جبروتًا قاهرًا، ومن شخصه ذاتًا متألهة متوحدة، متوسلاً بكل ما لديه من أجهزة ليبث الخوف في نفوس المحكومين.
ويؤكد عبد الرحمن أن الفاعل السياسي لا يمتلك شمول التغييب إلا بفضل “مبدأ التنازع” حيث ينشئ علاقات نفسية مع غيره، تُبني على التنافس في المنافع والأغراض وتتداخل فيها أسباب الشهوة، والقوة، والحُجة، مولدة فضاءً نزاعيًا واسعًا، تُضطر منظمات المجتمع ومؤسسات الدولة إلى ضبط قواعده ووضع حدوده.
ويفسر الكاتب ذلك بأنه لو “خُلّي بين الفاعل السياسي وبين مصالحه في العالم المرئي، لجعلها مطالب مستمرة بغير نهاية، كما يجعل الإله أوامره في العالم الغيبي، بلا نهاية.
ويشرع عبد الرحمن في الفصل الرابع من كتابه في نقده للدعوى العلمانية التي تشترط الفصل بين العملين “الديني والسياسي”، في سياق نهوض المواطنين بوضع قوانينهم بأنفسهم، مؤكدا أن هذه الدعوى تدخل على الوجود الإنساني شتى ألوان التضييق، لكونها بُنيت على افتراضات باطلة، منها أن إرادة التدبير لا تتجلى إلا في القدرة على وضع القوانين، وأن إرادة الله تتعارض مع إرادة الإنسان، كما بُنيت هذه الدعوى على اختلالات وصفها المؤلف بأنها “شنيعة” في فهم الصلة القائمة بين الله والإنسان.
ومن هذه الاختلالات الزعم بأن انحسار إرادة الإنسان يكون على قدر امتثاله لله، وأن إرادة الله تسلب من الإنسان إرادته، وهذه الافتراضات والاختلالات أدت إلى قصر وجود الإنسان على عوالم وهمية غير حقيقية، إما بقطع الصلة بين العالمين المرئي، والغيبي، وإما بقلب مقاصدهما.
ويواصل الكاتب نقده للدعوى العلمانية، مبينًا أنها تضمنت تقريرات فاسدة، منها أن العمل الديني لا يتدخل في الشأن العام، وأن العمل السياسي لا يتدخل في الشأن الخاص، ما أدى إلى إضعاف وجود الإنسان في العالم المرئي، بقطع أسباب وجوده بالعالم الغيبي.
وفي الفصل الخامس والأخير من الباب الأول للكتاب، يؤكد عبد الرحمن أن التسيّد هيمن على تدبير الشئون والعلاقات الإنسانية، واتخذ أشكالاً مختلفة تمارس التغييب وتتعبد للطاغوت، خاصة تسيد الدولة الحديثة. وينهي هذا الجزء من كتابه بالتأكيد على أن من يتعبد لله وحده، طالبًا التدبير، الذي لا تغييب معه يتعين عليه، الخروج من هذا “التسيّد الطاغوتي”.
الوصل بين الدين والسياسة
يصل طه عبد الرحمن إلى الباب الثاني الذي يحمل عنوان “اتصال التدبير بالتعبد واتساع الوجود الائتماني”، فيؤكد في الفصل السادس أن الوصل بين الدين والسياسة اتخذ صورتين، تتمثل الأولى منهما في دمج الدولة للدين في السياسة واقعة في “تسييس الدين”.
ويوضح المؤلف أن الدولة تلجأ إلى هذا الدمج من أجل خدمة أغراضها التسيدية، حتى يتاح لسيطرتها على المواطنين أن تتصرف بغير مراقبة. ولم يتخذ هذا الوصل مطلقًا صورة التدبير التعبدي لبعض الشأن العام، وإلا كان يتعيّن الذهاب بهذا الوصل إلى منتهاه وتحمل النتائج المترتبة عليه بما فيها الخروج من التسيد.
كذلك كان على الدولة أن تلزم نفسها بتنفيذ كامل مقتضيات التعبد لله في الحياة العامة للمواطنين، لكن ما حدث هو أن هذا الوصل اتخذ صورة إخضاع الدين للتدبير التسيدي بحيث تتمسك الدولة بما يخدم أهدافها التسلطية من تجليات التعبد، وتُقصي باسم التعبد نفسه كل ما لا يخدم هذه الأغراض متأولة النصوص الدينية على هواها، أو مصدرة فتاوى “على مقاسها”. ولما كانت الدولة المشتبهة تختلف عن الدولة العلمانية، من جهة أنها لا تنكر السيادة الإلهية ولو أنها تتسيد بطريقتها، كان تسيدها تسيدًا مشتبهًا لا تسيدًا محكمًا.
والصورة الثانية للوصل بين الدين والسياسة تتمثل في دمج “الإسلاميين” السياسة في الدين، واقعين في “تديين السياسة”. وهذا الدمج دخلت عليه شبهات تقليد المفاهيم والآليات التدبيرية ذات الأصل العلماني الذي يجعل منها أدوات تسيّدية لا تعبدية.
ومثل هذا التقليد كان أحيانًا مقصودًا دفعًا لتهمة التطرف أو طمعًا في السلطة، وأحيانا غير مقصود، تأثرًا بأساليب الممارسة السياسية التي تسود في مجتمعاتهم. وتجلى تقليدهم هذا في بعض الشعارات التي رفعوها في نضالاتهم ورسخوها في كتاباتهم، والتي تفصل بين الدين والدولة، كما تفصل بينهما العلمانية، مثل “الإسلام دين ودولة”، و”الدولة الإسلامية دولة مدنية”.
ويعتبر الكاتب أن وطأة هذا التقليد كان يمكن أن تخف، لو أن الإسلاميين استطاعوا أن يمارسوا على المفاهيم والآليات المقتبسة نقدًا كافيًا، يجعلهم يتبينون سياقاتها وحدودها ووجوه مخالفتها لمقتضى التعبد الذي يشكل منطلقهم، فضلاً عن أن يكون في مقدورهم ابتكار مفاهيم وآليات تكون بدائل عن الآليات والمفاهيم العلمانية.
وفي الفصل السابع من الكتاب، يركز عبد الرحمن على دعوى “الحاكمية”، مبينًا أن مجالها ليس كما ظن “الحاكميون” مجال التدبير التسلطي الذي تعد فيه الأعمال والتصرفات محكومة بالأمرية البشرية، وأنه حتى ولو وقع التسليم بوجود الأمرية الإلهية، فإنما هو مجال التدبير التعبدي الذي تُشاهد فيه هذه الأعمال والتصرفات، وهي محكومة بالأمرية الإلهية وحدها، فيوضح أنه لا يقول بالحاكمية لله إلا من يشاهد الحق في الخلق، وهذه المشاهدة لا تتأتى إلا للمتزكي، أي لمن ترقى عن رتبة “العقل المجرّد” الذي ينسب أفعال التدبير إلى الخلق بوصفهم أسيادًا مستقلين.
“تفقيه السياسة”
أما في الفصل الثامن، فيرى المؤلف أن “مبدأ تفقيه السياسة يبنى على تصور صناعي للفقه وللفقيه، موروث عن الطور التدويني، والعصر الصفوي”، هكذا يؤكد طه عبد الرحمن، في الفصل الثامن، من كتابه، مبينا أن هذا التصور، اتسم بالعناية بالجانب القانوني، من الفقه، وإهمال الجانب الأخلاقي.
وقد حدث ذلك، في تقديره، من ناحيتين، إحداهما أنه لم يبن القانون على الأخلاق، والثانية أنه لم يبن أخلاق الظاهر على أخلاق الباطن، فكان أن توسل الفقيه الوليّ في تدبيره بالوازع السلطاني، بدل الوازع الروحاني، متخلفًا عن رتبة “الإمام” من آل البيت، تزكية واقتداء.
ويدعو عبد الرحمن في هذا الفصل إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم الفقه، بحيث تتجدد صلته بمدلوله الحي الأول، الذي يجعله آخذًا بأسباب الفطرة الروحية ومشتركًا بين جميع أفراد الأمة وحاملاً لهم على الاشتغال بتزكية نفوسهم. وهذه الإعادة يترتب عليها أن يغدو طلب الفقه فرض عين، بحيث ينبغي أن يتفقه المجتمع المسلم كله تفقهًا حيًا.
وبناء على ذلك، يصل فيلسوفنا إلى نتيجة مهمة، وهي أنه لا يمكن أن تنحصر الولاية العامة في فئة من المختصين في الفقه، وإنما هي تتسع لكل أفراد المجتمع المتفقه، إذ أن معيار “الأهلية” لهذه الولاية ليس الإحاطة بتفاصيل القوانين والأحكام، وإنما هو التحقق الداخلي بالقيم الأخلاقية والمعاني الروحية التي هي بمنزلة الأسرار من هذه القوانين والأحكام.
وينهي المؤلف كتابه المهم بالفصل التاسع، طارحا فيه دعواه الائتمانية، ومؤكدا أنها لا تفصل بين التعبد والتدبير، كما أنها لا تصل بينهما، وإنما هي تنزل كرتبة سابقة على الفصل والوصل، وهي رتبة الوحدة الأصلية التي منشؤها العالم الغيبي، وتتمثل في “الأمانة” التي تحملها الإنسان باختيار منه.
ويؤكد فيلسوفنا أنه لا فصل ولا وصل بين التعبد والتدبير في الأمانة، كما أنه لا فصل ولا وصل بينهما في الاختيار لهذا اقتضى “مبدأ النسبة الائتمانية”، على خلاف مبدأ الوضع العلماني بأن يكون الإنسان لا متسيدًا، وإنما مستودعًا يرعى حقوق الوديعة.
ويشير الكاتب إلى أن “مبدأ النسبة الائتمانية” يقتضي، على خلاف مبدأ النسبة الديانية، أن يكون الإنسان متصلاً لا منفصلاً عن المودع الإلهي، موضحا أنه “كلما قام هذا المبدأ على الإيداع الإلهي، والاتصال الروحي، استطاع أن يوسع آفاق الوجود الإنساني”.
ويوضح العلامة المغربي أنه إذا كان المبدأ العلماني يحجب العالم الغيبي عن روح الإنسان بل يمحو آثاره من ذاكرته، بسبب إنكاره للإيداع الإلهي الأول، فإن المبدأ الائتماني – على العكس من ذلك- يرفع هذا الحجاب عن روحه، ويحيي ذاكرته جاعلاً عالمه المرئي موصولاً بعالمه الغيبي.
إن كتاب “روح الدين.. من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية”، في التحليل الأخير، يأتي بمنهج استدلالي مبني على الحُجة والبرهان، ثري بالمصطلحات الجديدة التي أبدعها العلامة المغربي طه عبد الرحمن، فهو الفيلسوف الذي يشغله الإبداع إلى حد الشغف، كما جاء الكتاب غنيًا في لغته، مترابطًا في أفكاره. وهذا ليس بجديد على فيلسوفنا الكبير.
روح الدين.. من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English