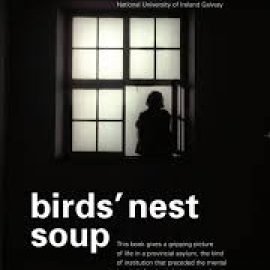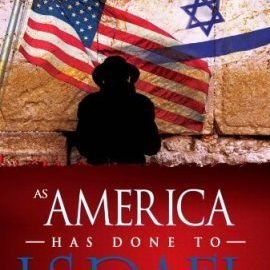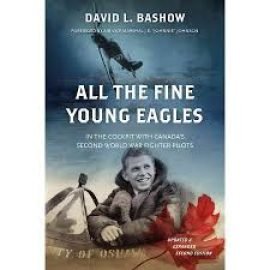الوصف
سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم
شغلت العلاقة بين العلم والدين، وبين العلم والفكر، فلاسفة ومفكري الغرب طويلا، فأبدعوا في بيان حدود هذه العلاقة، وأدلوا بدلوهم في هذا السياق عبر كتابات باتت من كلاسيكيات التراث الفلسفي الغربي، فيما غاب مثل هذا الإبداع عند الفلاسفة العرب والمسلمين، الذين اكتفوا بترديد ما قاله نظراؤهم الغربيون، دون إضافة أو حذف. ولم يكن هذا الوضع في حقيقته سوى جزء من موجة تقليد عامة لكل الإنتاج الفلسفي الغربي، ما أدى إلى نقل أدوات ومناهج غريبة عن ثقافتنا وتراثنا، ومن ثم ظهرت دعاوى “القطيعة” مع هذا التراث العربي الأصيل.
إزاء ذلك كرّس الفيلسوف المغربي العلاّمة طه عبد الرحمن مشروعه الفكري لتغطية تلك المساحات الفلسفية التي غاب عنها الإبداع، ولم يستطع أحدًا تأصيلها بمناهج عربية وإسلامية، فظلت أسئلة دون إجابات، ومجادلات دون حسم.
وفي هذا الكتاب “سؤال العمل.. بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم” يحاول عبد الرحمن استخلاص نظرية جديدة تخالف ما أقرته النظريات المتعارف عليها في هذا الصدد.. ووضع عمل مبدع يبحث في العلاقة بين العلم والدين والعلم والفكر، بعيدًا عن التقليد.
في مقدمة الكتاب، يشرح المؤلف تصوره العام لمفهوم “العمل”، الذي وضعه انطلاقًا من خصوصية عطاء التداول الإسلامي العربي، وانفتاحًا على العطاءات التداولية غير العربية، في وقت معاً.
و”العمل”، كمفهوم، وفقًا لتصور الكاتب الذي تكسوه النزعة الصوفية التأملية، هو “الخاصية التي تحدد الإنسان بما يورثه وصف العبد، لأن العبد لا يكون إلا بين خيارين، إما أن يكون عبدا لله فيتحرر من كل شيء، أو يكون عبدًا لغيره فيستعبده كل شيء”.
والعامل الذي اختار أن يكون “عبداً لله” يرتقي إلى أن يكون دالاً عليه، خالقًا ورازقًا. وهذه الدلالة الاختيارية على الله تجعل لعمله خصوصية لا يحظى بها عمل سواه، إذ يتفجر عمله بنيات التقرب إلى الله حتى تستوي عنده العبادة والمعاملة، ويتحقق بالصلاح الذي يبقى ولا يفنى حتى يستوي عنده العمل والرزق. كما يتحقق العمل بالسعة التي تزيد ولا تنقص حتى يستوي عنده الاخلاص وإخلاص الإخلاص: “إن من يختار أن يتعبد لله وحده لا محالة يكون عمله قاصدًا بقصد الله، وباقيًا ببقاء الله، وواسعًا بسعة الله، فيكون عملا ثقيلاً بحق”.
المأصول والمفصول
ماهية الفلسفة التداولية، وطبيعة الاستقلال الفلسفي، كان موضوع الفصل الأول الذي أكد فيه المؤلف أنه لا سبيل للفلسفة إلى مجاوزة المأصول التداولي، لأنه يؤثر في مفاهيمها وتحديداتها وبراهينها المجرّدة تأثيرا لا فكاك منه. موضحا أن الفلسفة لا يتأتى لها أن تسعى إلى هذه المجاوزة، لأن الاستثمار الواعي لهذا المأصول الفلسفي يوسع آفاق استشكالاتها واستدلالاتها بما لا توسعه هذه المجاوزة، هذا إن لم يضيّق هذا المسعى التجريدي من نطاق هذه الآفاق ويحد من عطائها، كما يورثها هذا الاستثمار المتبصر كونية مشخصة ليس هناك أنسب منها لواقع اختلاف الثقافات واللغات الإنسانية عبر العالم.
غير أن الفلسفة الإسلامية لم تستطع – وفق المؤلف- أن تتجاوز المنقول اليوناني، ولم يكن لها حظ في الإبداع المأصول لأن عطاءها ظل يجانس هذا المنقول أو يحافظ عليه أو يتلاءم معه، فلم يتجاوز في التعامل معه رتبة “الإبداع المفصول”.
وعن حل هذه الإشكالية، يرى عبد الرحمن أنه لا طريق إلى استقلال الفلسفة الاسلامية عن كل منقول إلا من خلال الجمع بين مقتضى الإبداع الموصول ومقتضى الكونية المشخصة، وفي هذه اللحظة بات لزاماً على فلاسفة المسلمين أن يقيموا إنتاجهم الفكري على معطيات المجال التداولي الاسلامي، مجتهدين في استمداد الإشكالات الفلسفية منه وعرض الإشكالات المنقولة عليه.
كما صار لزاماً على هؤلاء الفلاسفة أن يستثمروا في تطلعهم إلى إضفاء الكونية على أسئلتهم وأدلتهم خصوصية تعامل هذا المجال التداولي مع العقيدة الدينية، والخبر السمعي، والعمل السلوكي، واللسان العربي. ومن دون توظيفهم لهذه المقومات الأربعة في إنتاجهم الفكري، تكون جهودهم في تحرير الفلسفة الإسلامية من “سلطان المنقول” عديمة الفائدة.
الفصل الثاني خصصه عبد الرحمن لبيان مفهوم العقل “الموسع” هو العقل الذي يقف على ما يقف عليه العقل المجرّد من القضايا والقوانين، لكنه يزيد عليه أمرًا لا يطيقه هذا العقل المجرًد وهو تأسيس تلك القضايا والقوانين على الحقائق الإيمانية الواسعة. وهذا التأسيس من شأنه – كما يقول عبد الرحمن- أن يجدد النظر إلى هذه القضايا والقوانين، بما لم يكن في حسبان العقل المجرّد، ويمدها بالمشروعية التي كانت تفتقدها، والتي لولاها لتهافت منطق وجودها.
وعليه، فإن من يملك عقلاً بهذا الوصف يصبح إنسانًا جديدًا، فأصحاب العقول الموسعة هم الذين أطلق عليهم القرآن اسم “أولو الألباب”، وهم أولئك الذين انكتب الإيمان في قلوبهم مستوليًا دفقه على مشاعرهم، ومتدفقا مدده في مداركهم.
ينتقل بنا المؤلف بعد ذلك إلى مناقشة مفهوم “الأخلاق العالمية”، مشيرا إلى أنها أخلاق ذات طبيعة عملية لأنها تُستقرأ من التجربة الأخلاقية الحية للإنسان، وهي أخلاق ذات مصادر متعددة حيث تشترك أطراف كثيرة، في تحديد قواعدها، وأحكامها، كما أنها أخلاق ذات توجه ديني، فهي تستقي قيمها ومبادئها من الأديان المختلفة. مستعرضا في الفصل الثالث الظروف التاريخية التي مر بها مفهوم الأخلاق العالمية، وظهور الإعلان من أجل هذه الأخلاق العالمية، مؤكدًا أنه لا يحقق للدين أي تمكين في العالم، كما أن هذا الإعلان يُخل بشرط التقدم العلمي. ومن مظاهر هذا الإخلال، أن بعض القيم التي طلب الإعلان تحصيلها لا يستطيع أن يحققها على الأرض، مثل السلم العالمي، كما أن القيم التي حصلها بالفعل هي أقل من اللازم، وأيضا القيم التي كان يجب أن يحصلها، لكنه لم يحصلها، وفي صدارتها قيمة “الإيمان”.
الحرية والعمل التزكوي
في الفصل الرابع استعرض العلاّمة المغربي التعريفات المختلفة لـ”الحريات”، حسب التيارات السياسية المعاصرة، مشيرا إلى أنها كانت على نوعين، أحدهما بالسلب وقد أخذ به كل من التيارين الليبرالي والجمهوري، فالحرية بالنسبة للتيار الأول هي عدم التدخل، وبالنسبة للثاني هي عدم التسلط.
أما النوع الثاني من الحريات فهو تعريف بالإيجاب، وقد أخذ به التياران الديمقراطي والاشتراكي، فالحرية بالنسبة للأول هي وجود المشاركة السياسية، وبالنسبة للثاني هي توفر القدرة على المشاركة السياسية.
وبعد ذلك قدم فيلسوفنا تعريفه الخاص والشامل للحرية، الذي يراعي حقيقة انضباط العمل متجنبًا السقوط في آفات النقض، والبتر، والوهم، والتي يرى أن التعريفات السابقة وقعت فيها، وعرّف الحرية على أنها: “التعبد للخالق باختيارك، وألا يستعبدك الخلق في ظاهرك أو باطنك”.
انتقل عبد الرحمن بعد ذلك إلى مفهوم “العمل التزكوي”، معتبراً أنه “يشكل نموذجًا لغيره من الأعمال، فهو يتصف بالقدرة على تحويل القلوب والعقول، وأيضا بتكامل مجالات الحياة وجوانب الإنسان فيه”، وكذلك باستمرار من غير انقطاع، وأخيرًا بتصاعد وتيرة تجدده. كل ذلك لأنه قام على أصل الأصول، وهو التعبد لله في كل شيء على شرط الإخلاص.
وهذا العمل التزكوي – من وجهة نظر عبد الرحمن- يستوفى القدرة على تحرير الحريات الحديثة من الآفات التي عرضت لها بسبب مخالفتها لقوانين العمل الثلاثة، والتي أخرجتها إلى حال “اللا حريات”، فهو قادر على أن يحرر الحرية الليبرالية من العبودية للسوق التي أفضى إليها التزامها بمبدأ سيادة الفرد.
والعمل التزكوي قادر أيضًا على أن يحرر الحرية الجمهورية من العبودية للقانون، التي أدى إليها عملها بمبدأ سيادة الشعب المنازع، كما أنه قادر على أن يحرر الحرية الديمقراطية من العبودية للرأي العام التي أدى إليها التزامها بمبدأ سيادة الشعب الموافق، فضلا عن قدرته على أن يحرر الحرية الاشتراكية من العبودية للسلطة التي أدى إليها أخذها بمبدأ سيادة الحزب.
دفع “مفاسد العولمة”
الفصل السادس من الكتاب أفرده المؤلف لأزمة القيم التي تزامنت مع نمو ظاهرة “العولمة الاقتصادية”، وهو يعرّف القيمة بأنها “معنى خفي يجده الإنسان في قلبه ولا يدركه بحسه”، لكن مع وجود هذا الخفاء يبقى هذا المعنى هو الذي يهديه في حياته ويرتقي بإنسانيته، فالقيم هي عبارة عن “معان فطرية هادية وسامية”.
أما “العولمة” فيرى المؤلف أنها عبارة عن “التجلي الحاضر لإرادة الإنسان في أن ينتشر في الأرض بحيث يسعى هذا الإنسان إلى أن يحيط بجميع أطراف العالم”. ولكن هل “العولمة “باعتبارها تجليًا لإرادة الانتشار في العالم بأسره تلتزم بالقيم بحيث تكون “عولمة مهدية ومتسامية”؟
يجيب فيلسوفنا على هذا السؤال مبيّنا السبل التي يمكن من خلالها دفع “مفاسد العولمة”، وأهمها وضع أخلاقيات قادرة على نقل انتشار هذه الظاهرة “التسليعي” إلى انتشار “تقويمي” يرقى بالناس إلى آفاق أخلاقية أكثر رقياً وإنسانية.
ولكن برأي عبد الرحمن أنه لا قدرة للعولمة على ذلك ما لم تأخذ بقيم تحقق التزكية الخلقية، في مقابل التنمية الاقتصادية، وتستقل بمنطق العطاء، في مقابل منطق التبادل، وتختار الإيمان بسلطان الخالق في مقابل قوة التعلق بقانون المادة. هذه القيم تُبنى على مبادئ ثلاثة مقتبسة من الفطرة الإنسانية، وهي: مبدأ الائتمان الذي تتصدر فيه قيمة الأمانة، ومبدأ التكريم الذي تتصدر فيه قيمة الكرم، ومبدأ التحرر الذي تتصدر فيه قيمة الرزق.
ويصل بنا عبد الرحمن في الفصل السابع إلى تأصيل العلاقة بين الدين والعلم، مشيرًا إلى أن “العلاقة بينهما عمل تعبدي نزل به الأمر الإلهي، ونظر تسيّدي ينهض به العقل الإنساني”، فيكون العالم بذلك مُطالبًا بأن يقدم الأمر الإلهي على العقل الإنساني، فيضع علمه النظري وفق المقتضيات الأربعة لهذا العمل الديني وهي الاعتقادات، والقيم، والقواعد، والنماذج.
إن “إرادة الخلود متمكنة في النفس البشرية”، هذا ما يؤكده المؤلف في الفصل الثامن والأخير من كتابه، منوهاً إلى أن هذه الإرادة اتخذت لها عبر التاريخ الإنساني تجليات مختلفة، ويتمثل تجليها المعاصر في إرادة الاشتراك في الخلق والاستقلال به، وذلك من خلال تطوير البحث في “الخلايا الجذعية الجنينية” أملاً في الظفر بأسباب الحياة الخالدة.
غير أن هذه الإرادة ضلت طريقها، حسب الكاتب، حيث إنها طلبت الخلود في نطاق الجسد بواسطة العلم الوضعي، بينما كان ينبغي لها أن تطلبه في نطاق الروح عبر العمل الصالح، مطالبا بضرورة التحول عن هذه النظرة القاصرة إلى رؤية أكثر شمولية.
ويضع عبد الرحمن في هذا الفصل تعريفًا عمليًا للدين يبرز وظيفته العملية الشاملة، فهو: “عبارة عن طريق في العمل يصل المرئي بالغيبي وصلاً يمكن الإنسان من اقتحام عقبات الحياة على الوجه الأفضل”. وهذا الدين – من وجهة نظر فيلسوفنا- يزود الإنسان بجملة من الاعتقادات والتصورات التي تحدد رؤيته الشاملة للوجود، ويتجلى هذا الشمول في كون المتدين يتناول من خلال هذه الرؤية كل ظواهر العالم ومظاهر الحياة التي يصادفها، ويتعاطى معها للجمع بين ما هو داخل في نطاق الحس وبين ما تتصل أسبابه بأفق المعنى.
كما يمد الدين الإنسان بجملة من القيم والمعاني الروحية، التي يوجه بها سلوكه في الحياة، ويتخذها مقاصد لأفعاله، وتصرفاته، وتعينه على التصدي للقيم المادية، التي تقترن بأسباب الحياة الدنيا، وتطوراتها المتلاحقة.
ويحدد الدين أيضًا جملة من القواعد والأحكام التي تبيّن للإنسان كيف يقتحم العقبات التي تواجهه في حياته بدءًا من الابتلاءات المعيشية التي يتعرض لها، وانتهاء بالأسئلة الوجودية القصوى التي تؤرقه، كما يضع بين يدي الإنسان جملة من النماذج تجسد هذه الاعتقادات والقيم والقواعد حتى يجتهد في الاقتداء بأفضلها.
ويختم المؤلف هذا الجزء بالتأكيد على أنه “إذا كان العمل الديني يجمع بين المرئي والغيبي وكان هذا الجمع يتخذ من الأسباب ما يجاوز أسباب العقل المجرّد، فلا سبيل إلى معرفة كيفيات هذا العمل وتبين آثاره على وجه التفصيل إلا بملاحظة هذه الكيفيات والآثار في شخص أو أشخاص تتحقق فيهم على الوجه الأمثل كنماذج تطبيقية، بدءًا من النبي المرسل وانتهاء بالعبد الصالح”.
ويُنهي المؤلف كتابه بملحقين، خصص الأول منهما لبيان كيفية تجديد الصلة بين العلم والدين، والثاني لبيان كيفية تجديد الصلة بين العلم والفكر.
انتقد في الملحق الأول مظاهر التقليد وعدم الإبداع في هذا الصدد، مؤكداَ أن من بحثوا في هذا الأمر وكانوا من المقلدين انقسموا إلى ثلاث فرق، فرقة ادعت أن بين العلم والدين تناقضًا صريحًا وبالغت في التمسك بهذا التناقض، فجعلت العلم حربا على الدين والدين حربا على العلم، ورأت أنه لا مخرج إلا بانتصار العلم وانهزام الدين.
فيما ادعت الفرقة الثانية أن بين العلم والدين تمايزًا لا تناقضاً ما، فما يشتغل به العلم لا يشتغل به الدين والعلم موضوعه المعرفة والحقيقة، بينما الدين موضوعه الشعور والحدس. أما الفرقة الثالثة فادعت أن بين العلم والدين تباينًا، وأنه لا تناقض ولا تمايز بينهما.
كل الادعاءات السابقة رفضها عبد الرحمن، مقدما تصوره الخاص وإبداعه في بيان طبيعة العلاقة، معتبراً أن مفهوم “العلم” يصبح بمقتضى مبدأ مراتب العقل أوسع من المفهوم المتداول للعمل، كما أن كل علم يصبح بمقتضى مبدأ استكمال العلم محتاجًا إلى ما فوقه من العلوم.
أما مفهوم الدين فيغدو بموجب مبدأ تعدد شُعب الحياة أوسع من المفهوم المتداول للعلم، كما أن كل شعبة تصير بموجب مبدأ استكمال الشعبة محتاجة إلى ما يناظرها من الشُعب. ويترتب على ذلك أن العلم لا يقابل الدين مقابلة تناقض ولا مقابلة تمايز ولا مقابلة تباين، وإنما مقابلة تداخل، ويكون العلم بذلك جزءًا واحدًا من أجزاء الدين، كما يكون الإيمان جزءا ثانيًا، والعمل جزءًا ثالثًا من هذه الأجزاء.
ويوضح العلاّمة المغربي أن صلة العلم بالدين من منظور الإسلام هي صلة تداخل يكون فيها العلم جزءًا من الدين، فيلزم بحسب هذا المنظور أن يقدم الدين على العلم لا تقديم الفاضل على المفضول، وإنما تقديم الكل على الجزء كما يلزم أن يدخل في الدين كل العلوم لا دخول التابع في المتبوع، وإنما دخول العنصر الواحد في المجموع.
وأما عن العلاقة بين العلم والفكر والتي خصص لها المؤلف الملحق الثاني، فيؤكد عبد الرحمن أن ليس للعلم تصور واحد، وإنما هي تصورات ثلاثة، بعضها أشمل من بعض، وأن “التصور الضيق” يحصر العلم في بحث الحقائق الطبيعية، بينما “التصور الواسع” يجعل من العلم بحثًا في الحقائق الطبيعية والسلوكية، وأما “التصور الأوسع” فيجعل منه بحثًا في الحقائق الطبيعية والسلوكية والاعتقادية.
وبالنسبة للفكر، يرى عبد الرحمن أنه ليس له نوع واحد وإنما أنواع ثلاثة، بعضها أكمل من بعض، وهي: “التفكير” وهو ينظر في المنافع المادية، و”الافتكار” وينظر في المنافع الخلقية، و”التفكر” وينظر في المنافع الروحية، مؤكدًا أن العلم يكتسب مشروعيته من الفكر والفكر يكتسب من العلم مصداقيته، فلا علم بغير فكر، ولا فكر بغير علم.
سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English