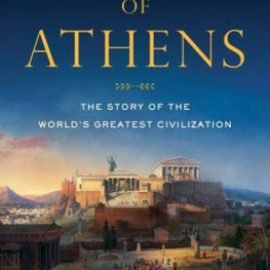الوصف
“فقه الفلسفة2.. القول الفلسفي”
ظل “المُتفلسف العربي” ردحًا طويًلا من الزمن يدور في فلك الفلسفة الغربية، متعاطيًا كل أدواتها، ومناهجها، ونظرياتها، مبتعدًا عن الابتكار، والإبداع من أجل صناعة فلسفته الخاصة، فأصبح مقلدًا لا مبدعًا، في حين يحمل التراث العربي الأصيل كل الأسباب التي كان من الممكن أن تقود المتفلسف إلى “فلسفته الخاصة”، غير أنه آثر الاستسلام لهذا الوافد الغريب الذي سلبه كل شيء، حتى الصلة مع تراثه.
الأكاديمي المغربي، الفيلسوف المعاصر، الدكتور طه عبد الرحمن، يواصل نقده لهذه “الحالة الفلسفية”، مجددًا دعوته إلى الإبداع، والابتعاد عن التقليد، وذلك في كتابه الثاني من مشروعه، “فقه الفلسفة”، والذي جاء تحت عنوان “القول الفلسفي – كتاب المفهوم والتأثيل”.
وفي هذا الكتاب يرد عبد الرحمن على اعتراضات المُقلدين على ترجمته التأصيلية الخاصة بـ”الكوجيتو” الديكارتي، مبينًا مميزاتها التي جعلتها تختص بمقام التفلسف، لا بمقام التعلم كالترجمة التحصيلية، ولا بمقام التعليم كالترجمة التوصيلية، مؤكدًا أن الاعوجاج الذي أصاب قديم الفلسفة الإسلامية العربية، وحديثها، إنما هو لكونها “ابنة هذا التقليد”.
ويتعهد عبد الرحمن، في كتابه هذا، ببذل أقصى جهد من أجل قطع دابر التقليد، وتحرير القول الفلسفي العربي، وهو يقسم كتابه إلى ثلاثة أبواب، يشتمل كل منها على فصلين، خُصص الباب الأول للحديث عن أركان “التأثيل المفهومي”.
الفلسفة والمنطق والتصوف
في الفصل الأول من الكتاب، يؤكد عبد الرحمن أن القول الفلسفي وإن اختلف عن القول المنطقي، وعن القول الصوفي، فإنه لا ينفك يستمد زخمه من عبارية الأول وإشارية الثاني، بحكم أن كمال الفلسفة يكون في الوصل بين المنطق والتصوف، فيكون قولًا لا تتمحض فيه العبارة، ولا تتمحض فيه الإشارة، وإنما هو مزيج بينهما.
وقبل انتقاله إلى الحديث عن الفلسفة الطبيعية، يؤكد العلاًمة المغربي أن هذا المزج يكون بدرجات متفاوتة فيتخلف القول الفلسفي، باختلاف هذه الدرجات. ويبدأ حديثه عن الفلسفة الطبيعية، ببيان أن “كل فلسفة قريبة تداوليًا ومتوازية بيانيًا، ومتى خلت الفلسفة من القرب التداولي، أو خلت من التوازن البياني، أو خلت منهما معا فإنها تعد فلسفة غير طبيعية”.
ويوضح المؤلف، في هذا الموقع من الكتاب، أن الفلسفة الطبيعية على خلاف الفلسفة، في مفهومها التقليدي، ليست إنتاجًا من وضع الخواص من الناس، وإنما هي ثمرة التفاعل الفكري الطويل بين أهل المجال التداولي جميعًا، خاصتهم وعامتهم”.
وبهذا المعنى، تكون الفلسفة الطبيعية هي الدائرة الفلسفية التي تجمع فيما بينهم وتميزهم عن غيرهم، والتي يستخرجون منها أصول فلسفاتهم الخاصة متى كان من بينهم من اشتغل بالفلسفة التقليدية، لذلك فإن الفلسفة الطبيعية توجد حيث لا توجد نظيرتها التقليدية”.
ويؤكد الكاتب أنه “حيثما وُجدت في فكر أمة ما مظاهر الوصل بين البيانين العباري والإشاري على مقتضى مجالها التداولي الخاص، فثمة فلسفة طبيعية. وحيثما وُجدت فيه مظاهر الفصل بين هذين البيانين، فثمة فلسفة صناعية، فإن أخذت بالاعتبارات التداولية كانت فلسفة صناعية موصولة، وإن لم تأخذ بالاعتبارات التداولية كانت فلسفة صناعية مفصولة”.
وينهي عبد الرحمن هذا الفصل بتوضيح أن “العبارة والإشارة” بيانان متباينان، لكل واحد منهما مبادئ هي أضداد لمبادئ الآخر، فمبدأ الحقيقة في العبارة ضد مبدأ المجاز في الإشارة، ومبدأ الأحكام في الأولى ضد مبدأ الاشتباه في الثانية، ومبدأ التصريح في هذه ضد مبدأ الإضمار في تلك.
وينتقل عبد الرحمن بعد ذلك إلى الفصل الثاني، مؤكدًا أن المفهوم الفلسفي ليس مفهوما تصوريًا كالمفهوم العلمي، ولا مدركًا ذوقيًا كالمدرك الأدبي وإنما هو مفهوم منفهم، ولا انفهام من غير اقتران بالصورة اللفظية في لسان مخصوص، فيتميز بذلك من هذه الجهة عن المُدرك الوجداني الذي قد يستغني بالحال عن المقال”.
ويواصل فيلسوفنا حديثه مؤكدًا أنه “لا انفهام من غير انتساب إلى المجال التداولي لمستعمل مخصوص، فيتميز من هذه الجهة الثانية عن المفهوم العلمي الذي لا اعتبار فيه مبدئيا لمثل هذا المجال. والمفهوم المنفهم هو الذي اختص باسم المعنى، إذ المعنى هو كل مفهوم لا انفكاك له عن اللفظ ولا عن اللافظ”.
ولمّا كان المفهوم الفلسفي لا يزول عنه – بأي حال- الاقتران اللفظي ولا حال الانتساب التداولي، فقد ازدوج بسببهما جانبه العباري بجانب إشاري، ويتكون الجانب العباري لهذا المفهوم من مدلوله الاصطلاحي الذي هو مشترك بين الألسن، فيما يتكون جانبه الإشاري من مجموع المُضمرات اللفظية والتداولية التي يُتوسل بها في تأصيل أو تأثيل هذا المدلول الاصطلاحي، والتي تختلف من لسان إلى غيره”.
وطبقًا للمؤلف، ينقسم “تأثيل المفهوم” الفلسفي إلى قسمين أحدهما التأثيل المضموني، وهو التوسل بالإشارات الإضمارية في تأصيل الجانب الاستشكالي من هذا المفهوم، والقسم الثاني هو “التأثيل البنيوي”، وهو التوسل بالإشارات الإضمارية في تأصيل الجانب الاستدلالي من المفهوم الفلسفي.
ومتى استتب للمفهوم الفلسفي قوامه التأثيلي تمتع بالتمكن الاستشكالي والاستدلالي، الذي يضمن له النماء في الاستفهام والغناء في الإفهام. أما إذا لم يستتب له القوام وكان مفهومًا مجتثًا، فيتطرق إليه الضيق في أسئلته والجمود في أدلته، فيصير ضرره أكثر من نفعه.
أما الاعتراضات التي يمكن إيرادها على “التأثيل”، فيحددها الكاتب بثلاثة، وهي: الاعتراض البلاغي الذي يرى في “التأثيل” اللغوي نوعًا من الجناس الذي لا فائدة فيه، والإعتراض الفلسفي الذي ينفي عنه أن يكون تحليلًا علميًا صريحًا أو تحليلاً فلسفيًا صحيحًا، والاعتراض التواصلي الذي يرى في عموم التأثيل مانعًا من تحصيل التواصل بين الثقافات والأمم المختلفة، وقد تولى عبد الرحمن الرد عليها جميعًا.
ماهية “التأثيل اللغوي”
نصل مع المؤلف إلى الباب الثاني من الكتاب، والذي خصصه للحديث عن “المفهوم الفلسفي والتأثيل اللغوي”، منوهًا إلى أن المفهوم الفلسفي الغربي مفهوم متمكن، بينما نظيره الفلسفي العربي مفهوم مجتث، وأن أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو تباين موقفي فلاسفة الغرب والعرب- كل على حدة- من التأثيل اللغوي.
ويبيّن أن فلاسفة الغرب أدركوا منذ أوائل التفكير الفلسفي أهمية “التأثيل” في إرساء قواعد هذا التفكير، كما أدركوا أهمية هذا التأثيل في تجديد هذه القواعد، بينما كان موقف فلاسفة العرب من التأثيل اللغوي مزدوجًا ومتعارضًا، فالعرب أخذوا به في مرتبة وضع المفهوم، عاملين على ضبط مسالكه وتحديد مقتضياته من المطابقة أو المشابهة، بينما لم يأخذوا به في مرتبة استثمار المفهوم لتمسكهم بأسبقية المعنى على اللفظ، وشمولية المعنى العقلي، واستقلالية المضمون عن الصورة .
وهذين السلوكين المتعارضين من التأثيل اللغوي – من وجهة عبد الرحمن- يستندان إلى نظريتين دلاليتين، كلتاهما مردودة، فتصورهم لمسألة وضع المفهوم على تقلده لمبدأ التأثيل يبقى مبنيًا على نظرية تجزيئية للدلالة، تقوم على افتراضين باطلين هما: تشاكل الألسن فيما بينها، وانفصال المعاني بعضها عن بعض البعض. أما تصورهم لمسألة “استثمار المفهوم” فإنه مبني على نظرية تجريدية للدلالة، وهي الأخرى تقوم على افتراضين باطلين، هما الانسلاخ الدلالي، والانقطاع التداولي.
وفي الفصل الرابع يناقش عبد الرحمن المفهوم الفلسفي والتأثيل التقابلي، موضحًا أن المقابلة قانون خطابي أصلي شمولي، وهي خطابية لأنها تنهض بتوجيه الكلام وترتيبه، وهي أيضًا أصلية لأنها تشكل العلاقة الطبيعية التي يتكون بها الفكر وتبنى بها اللغة والأساس الذي يتفرع عليه تعريف المعنى، وتعليله، وهي شمولية لأنها تحيط بجوانب اللفظ وبأشكال المعرفة.
إن خطابية المقابلة – كما يوضح عبد الرحمن- تورث المفهوم الفلسفي الخاصية الحجاجية أو قوة الإقناع، ذلك أن توجيهها للكلام ينفع في وضعه حيث يكسبه بعدًا حواريًا، وأن ترتيبها للكلام ينفع في استثماره، حيث يكسبه بعدًا تدليليا. أما أصلية المقابلة فتورث المفهوم الفلسفي الخاصية الإنتاجية، أو قوة الإبداع.
ويكشف المؤلف سبب ذلك بأن “موافقتها لطبيعة الفكر واللغة تفيد في وضعه، حيث أنه يستمد منها القدرة على التأصيل، وأن تأسيسها لتعريف المعني وتعليله يفيد في استثماره، حيث إنه يستمد منه القدرة على التشقيق”.
أما شمولية المقابلة فتورث المفهوم الفلسفي الخاصية الاكتمالية أو قوة الاتساع، ذلك أن إحاطتها بتمام اللفظ تنفع في وضعه، حيث تجعله يتحرى أكثر ما يمكن من العلاقات، وأن إحاطتها بتمام المعرفة تنفع في استثماره حيث تجعله يتحرى أعم ما يمكن من الحقائق والمقاصد.
تقويم “اعوجاج الفلسفة
أما في الباب الثالث والأخير من الكتاب، فيتحدث عبد الرحمن عن الفلسفة والتأثيل، مستعرضًا نموذجين غربيين، الأول هو نموذج الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر، والذي خصص له الفصل الخامس شارحًا مسلكه الإشاري ذي الصبغة التأثيلية.
ويؤكد عبد الرحمن هنا أن “هيدجر” كان يرى في طريق الإشارة التأثيلية ركنًا من أركان الممارسة الفكرية، لا غنى عن انتهاجه لمن أراد أن ينهض بتقويم “اعوجاج الفلسفة”، وأنه خاض في تأثيل واسع لمفاهيمه بسبب اعتقاده الراسخ بأن المفاهيم الفلسفية ليست تصورات مجردة، وإنما هي – أصلًا- معان مشخّصة، فلا سبيل إلى إلحاقها بالاصطلاحات العلمية التي ليس تحتها إلا التصورات، وإنما الواجب هو إلحاقها بالإشارات الشعرية التي تنطوي وحدها على المعاني.
وفي الفصل السادس والأخير من كتابه، يتناول الكاتب تجربة الفلسيوف الفرنسي جيل دولوز، مبينًا كيف أن “دولوز” أقر بأهمية التأثيل في مستوى النظر في الاستشكال الفلسفي، كما أقر بها “هيدجر” في مستوى الإتيان بهذا الاستشكال.
وحسب المؤلف، فقد مارس “دولوز” التأثيل كما مارسه “هيدجر”، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الممارسة كما خاض فيها “هيدجر”، ولم يبيّن بوضوح كيف كان يبني المدلولات العبارية لمفاهيمه على ما انطوى فيها من إشارات مختلفة.
وفي نهاية كتابه الذي كشف فيه بعض أسرار صناعة المفاهيم الفلسفية، يدعو طه عبد الرحمن إلى الابتعاد عن التقليد والخوض في بحر التجديد، وإلى الإبداع الفلسفي الذي يسهم في إنشاء “فلسفة خاصة بنا”، مستمدة من أصول تراثنا العربي الإسلامي.
“فقه الفلسفة2.. القول الفلسفي”
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English