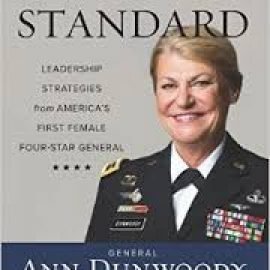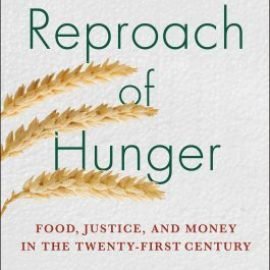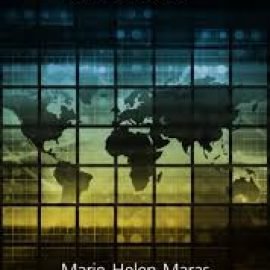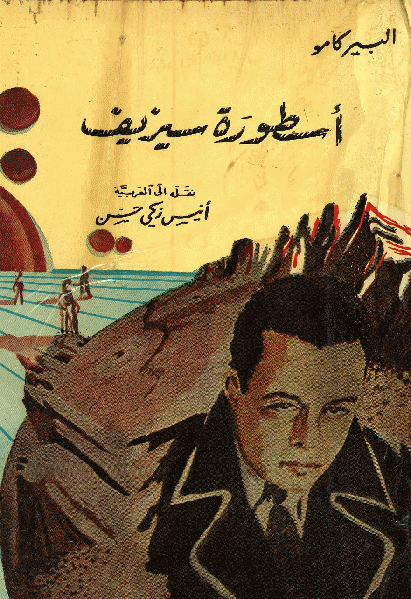الوصف
في إجابة عن سؤال يُطرح بكثرة في الأعوام الأخيرة، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مهمّ يشرح فيه مؤلفه عزمي بشارة ظاهرة الشعبوية وسياقاتها التاريخية؛ فقد أصبح من الضروري شرح جذور الظاهرة وماهيتها وتدقيق المفهوم، ولا سيما بعد أن راج استخدام المصطلح إعلاميًا في وصف حركات يمينية نشأت وانتشرت خارج الأحزاب المعروفة، وفي وصف سياسيين جدد برزوا وصعدوا من خارج المنظومات الحزبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ينفرد هذا الكتاب بالانطلاق من نظرية الديمقراطية وبنيتها، وبالفصل بين ظاهرة الشعبوية في الديمقراطيات؛ إذ يُظهر تميّزها بوضوح على نحو مبيّن لحدودها ودرجاتها من جهة، وحالها في البلدان ذات الأنظمة السلطوية التي يصعب التمييز فيها بين الشعبوي والشعبي في المعارضة. كما يناقش الكتاب مصادر الشعبوية في الخطاب الديمقراطي نفسه، وفي التوترات البنيوية للديمقراطية، ووجود درجات من الشعبوية في خطاب الأحزاب الرئيسة ذاتها، والمصادر الثقافية والسوسيو-اقتصادية للمزاج السياسي الشعبوي.
يتألف هذا الكتاب (216 صفحة بالقطع الصغير، موثقًا ومفهرسًا) من أربعة فصول.
في الفصل الأول، “الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية”، يرى بشارة أن ما يُعدُّ أزمةً تمرُّ بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. وبحسب المؤلف، تتمثل عناصر هذه الأزمة الدائمة بثلاثة توترات بنيوية: التوتر الأهم هو بين البعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية بين البشر، وافتراض المساواة في القدرة على تمييز مصلحتهم، التي تقوم عليها المساواة السياسية بينهم، ويقوم عليها أيضًا حقهم في تقرير مصيرهم، وبين البعد الليبرالي الذي يقوم على مبدأ الحرية المتمثلة بالحقوق والحريات المدنية، وصون حرية الإنسان وكرامته وملكيته الخاصة من تعسّف الدولة، ويتعلق بتحديد سلطات الدولة. أمّا التوتر الثاني فهو داخل البعد الديمقراطي ذاته بين فكرة حكم الشعب لذاته من جهة، وضرورة تمثيله في المجتمعات الكبيرة والمركبة عبر قوى سياسية منظمة ونخب سياسية تتولى المهمات المعقدة لإدارة الدولة عبر جهازها البيروقراطي، من جهة أخرى. وأمّا التوتر الثالث فهو بين مبدأ التمثيل بالانتخابات الذي يقود إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ممثلي الشعب المنتخبين، أو بأصوات ممثلي الأغلبية من ناحية، ووجود قوى ومؤسسات غير منتخبة ذات تأثير في صنع القرار، أو تعديله، وحتى عرقلته مثل الجهاز القضائي والأجهزة البيروقراطية المختلفة للدولة، من ناحية أخرى.
إضافةً إلى ذلك، يجد بشارة أن تفاقم حالة عدم الثقة بالأحزاب في الديمقراطيات المتطورة والنامية، وتزايد وزن العنصر الشخصي في السياسة، وتصاعد دور الإعلام المرئي ووسائل الاتصال الشبكية، كلّها عوامل تؤدي إلى صعود سياسيين غير حزبيين أو متنقلين بين حزب وآخر، يعتمدون على النجومية، والديماغوجيا الإعلامية وغيرها، إضافةً إلى تسلُّل رجال أعمال فاسدين إلى السياسة، لكنهم في نظر الجمهور مؤهلون لأنهم جمعوا ثروتهم خارج المنظومة السياسية، ولأنهم يتكلمون لغة البسطاء، كما ينجذب إليها نجوم الرياضة والسينما.
وبحسب بشارة، لا تنبع شعبوية السياسي هنا من انتمائه إلى الشعب، “بل من تكلّمه لغة الشعب وتنزيل مستواها من خلال ذلك، لأنه لا يتكلم لغة الشعب في الحقيقة، بل لغة الشارع كما يتصوَّرها، وكما يجري تكريسها في الإعلام والسياسة. فيبرز السياسي الهاوي المُعتمِد على العلاقات العامة والنجومية […] ما يؤدي إلى إضرار كبير بالمؤسسات الديمقراطية. وطبعًا، لا ينجح هؤلاء في إعادة الثقة، بل يعمّقون عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية”.

 العربية
العربية  English
English