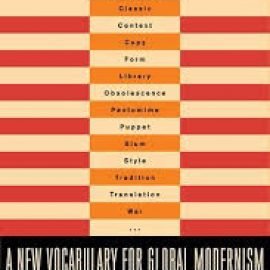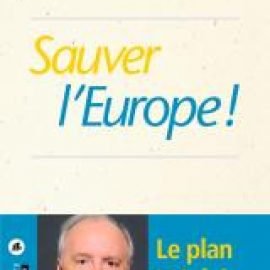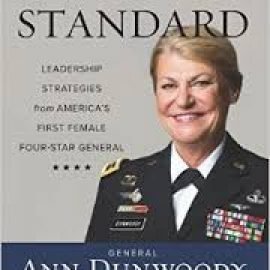الوصف
يمتد تاريخ الأفكار والعمر الفلسفي إلى حقبات بعيدة، منذ البانتيون اليوناني والجدل القائم أوانذاك بين تلك الأعمدة التي تشربت الفكر الفلسفي لعمالقة الفلسفة الكبار أفلاطون وسقراط وأرسطو، والمحاورات التي كانت تدور بين الأساتذة وتلاميذهم الذين سيصبحون بقوة الديالكتيك فلاسفة لاحقين، يناورون، ويجادلون، ويقترحون، ويجترحون الرؤى، والأفكار والمفاهيم الجديدة التي بدأ بها الأساتذة، كما حصل بين سقراط التلميذ وأفلاطون الاستاذ والرائي.
كانت محاورات فيدروس الأفلاطونية قد مهَّدت السبيل إلى تفعيل عملية العقل، والمنطق، وتسريع إثارة المخيلة، بتنشيطها في اقتراح الأسئلة الصعبة، والدالة، والمثالية على ظاهرة الوجود بكل تجلياتها، وبالأخص الصعيد الكائناتي العاقل وغير العاقل، وتثوير مناطق الوعي، وتحفيز اللوغوس على النشاط، والمثابرة في مدار البانتيون، وهو مكان شبه مقدس، عامر بالأفكار والتساؤلات، والأطاريح الفلسفية، وذلك من خلال المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها الموقع، على صعيد الآلهة الإغريقية، وتحكمها بالقضايا المجتمعية، عبر نواب ينوبون عنها، باحثين في المسائل الأرضية.
حين ارتقت الفلسفة مدارج عليا في بدايات عصر التنوير، كان هناك سبينوزا، المفكر والفيلسوف الداحض للإرادة اللاهوتية، والمتجاوز بنظرته الفلسفية، وآرائه الفكرية النسيج المتين لعلم اللاهوت ولشبكته الإكليروسية.
لقد دحض الفيلسوف الألماني سبينوزا كل ما قدم اللاهوت من أفكار دينية، قانعة بالبعد الآخروي، وبوجود حساب وثواب وعقاب في مرحلة ما بعد الموت، والنهايات البشرية، فقد رفضها علمياً وشكك بقواها العليا، غير المنظورة حتى عُدّ أكبر الملحدين، ونعت من قبل الكنيسة بـ “الشيطان الأكبر على الأرض”.
يعد الفيلسوف سبينوزا رائد عصر التنوير، قبل بدئه بمئة عام، والأب المجسّد للمشاكلة الجدلية، فهو من كرّس مفهوم جدلية الوجود، تلك التي سرعان ما انتقلت إلى إنكلترا.
وحسب التاريخ الفلسفي، وتدرُّج مفاهيمه وأنساقه ومدياته، فهو أول من سحب البساط من تحت أقدام اللاهوتيين، وأسس لفكرة أنه يمكن تأسيس الأخلاقيات، وفق قواعد علمانية خالصة، وهو بذلك كان الشخصية المركزية لعصر التنوير، أي الشخصية الجدلية، المُحارَبة، والمطرودة، والمنبوذة من قبل اللاهوتيين وفلاسفتها الصغار، وقد سار على هديه الكثيرون من الفلاسفة المتنوّرين، كهيغل وماركس وإنجلز وغوتة، ونيتشة، وغيرهم من اللاحقين، أبرزهم جان بول سارتر، فقد عملت أفكاره ومواقفه وآراؤه على تجسير الفكرة السبينوزية مع الفكرة الروائية، وقد ولد ذلك التناغم الفلسفي مع الأدبي لدى روائيين متأثرين بالفلسفة السبينوزية التي كانت تغرق الإنسان في تيارها اللا نهائي. فروايات مثل “موبي ديك” لهرمن ملفل، و”الموت في البندقية” لتوماس مان، و”الأمير الأسود” لآريس مردوك، هي أعمال متماهية ومتناغمة ومتفاعلة مع الأفكار الفلسفية، وبخاصة السبينوزية.
هذه المقابسات والأفكار والاجتراحات الفلسفية، سعت إلى تقديمها الكاتبة والمترجمة لطفية الدليمي في كتابها الموسوم بـ “قوة الكلمات”، وما للكلمات من فاعلية فكرية في حياتنا، ونشاط المركز الذهني لدينا، مع هذه المفاهيم الفلسفية، والأدبية التي طرحها كتّاب، وروائيون، وفلاسفة بارزون، في مجال الفلسفة، والإبداع الروائي، المتآخي مع الفلسفة، وطروحاتها العقلية، والنفسية، والأدبية، والفكرية. فنحن نرى أنفسنا ونحن نطالع الكتاب أمام فلاسفة فاعلين في وسطهم العملي الدراسي المتمثل بالجامعات، وبالكتب التي يصدرونها، تلك التي تنال التقريظ الأدبي والصحافي في الميديا العالمية، وتعكس مدى التفاعل الفلسفي مع أزمنتنا المعاصرة، ولا يزال الطلبة الدارسون في العالم يخوضون غمارها، فالفلسفة لم تمتْ كما يشاع أحياناً، وقد أشيع ضمن هذا السياق بموت الشعر، أو موت النقد، ذلك أنّ هذه الحقول الإنسانية، المختصة بالأفكار، والمشاعر، والهواجس، والرؤى البشرية، قد صاحبت الإنسان منذ بزوغ الحضارات الأولى على الأرض، وحتى يومنا هذا، وكل ما أشيع حول موت هذه الحقول، هو نوع من الاجتهاد الشخصي، الفردي، لكاتب معين أو مفكر ما.
تقدم المترجمة نخبة لامعة من الروائيين والمفكرين، أولئك الذين أجريتْ معهم حوارات وأحاديث فكرية، أو أولئك الذين كتبوا مقالات فلسفية وفكرية واجتماعية لامعة، فلفتت نظر العالم إليها، كحالة الفيلسوف البريطاني كولن ويلسون، أو البريطاني الآخر برتراند رسل ومقالاته المنشورة في صحيفة “الغارديان” البريطانية، ذلك الفيلسوف الكبير والمثير للجدل، والذي عاش قرابة المئة عام، قضاها مجادلاً في حقول الفكر، والفلسفة، والمجتمع، والسياسة، وغيرها من المجالات كحقوق الإنسان، على سبيل المثال، أو ذلك المقال الذي يستعرض كتاب الفيلسوفة والروائية ريبيكا غولدشتاين المعنون بـ “أفلاطون في عصر غوغل”، وهو يناقش الأسباب الكامنة وراء عدم موت الفلسفة في حياتنا الحديثة والعصرية، عصر المحرك غوغل. وقد استعرض الكتاب في صحيفة “وول ستريت”، وكاتبه هو فيلسوف بريطاني معروف، إنه كولن ماغن، وهو مُدرّس في جامعات عالمية مثل أكسفورد، وروتريغز، وميامي، وله مؤلفات فلسفية تزيد عن خمسة وعشرين كتاباً، وجلها ينصب حول المفاهيم الفلسفية الحديثة، والملازمة لحياتنا اليومية.
يحمل الكتاب أيضاً في جزئه الأخير موضوعاً مميزاً ولافتاً عن “فكرة الحب الملهمة” وهو مقاربات في فلسفة الحب.
تسلط المترجمة الضوء في هذه الموضوعة على كتاب “عقلانية العاطفة” للبروفسور دي سوسا، إذ فيه يشير إلى أن “بعض الناس دُفع دفعاً إلى الجنون بسبب الحب، ومات البعض الآخر منهم في سبيله، في حين تسبّب الحب في دفع آخرين إلى ارتكاب جريمة القتل” أو الانتحار، كما يحدث في عالم الرواية والمسرح والشعر والقصص والحكايات الشعبية، وما أكثرها تلك التي تتحدّث عن قصص الجنون والانتحار والتفاني في سبيله، كقصتي قيس وليلى وجميل وبثينة العربيتين وروميو وجولييت، وحرب طروادة والقصص الهندية الشهيرة وكذلك الفارسية والكردية والتركية الكثيرة في هذا المجال، فكل شعب له حكاياته وقصصه عن الحب، لهذا نجد تفسيرات البروفسور دي سوسا تبحث في طوايا وأغوار العاشقين والمحبين، وتحاول أن تجد تفسيراً لهذا الأمر الإنساني ومصائبه العديدة المأسوية والجميلة.
في مطلع الصفحات الأولى من الكتاب نجد الفيلسوف البولندي ـ البريطاني سيغموند باومان، وثمة حديث طويل ومفصل معه، يجنح فيه نحو القضايا المجتمعية وبخاصة في عصرنا اللاهث وراء الاستهلاك، والصاعد في التصنيع اللا إنساني، ذلك الذي حول الأكثرية إلى نفايات بشرية، مصيرها مجهول في خضم التنافس والصراع المادي والصناعي المطّردين، فباومان يبدو من خلال حواره وهو في التسعينيات من عمره متوقد الذهن، مُحباً للدعابة مع محاوريه، ولكنه المُشخِّص البارز والأمثل والأشهر، للأمراض المجتمعية، والرأسمالية ووصول الأتمتة إلى أقصى تقنياتها، ما أدى إلى حشر الكائن الإنساني في زاوية حياتية ضيقة، تتمثل في الشبكة العنكبوتية.
لقد ألّف البروفسور باومان أكثر من ستين كتاباً، وجلها ينصب حول المجتمعات المعاصرة، ومشاكلها الوجودية، فهو مؤلف كتاب “الحداثة السائلة” و “الحياة السائلة” و”الحب السائل ـ في هشاشة العلاقات الإنسانية” و”أزمان سائلة ـ في عصر اللايقين”، وأغلب هذه الكتب يعالج مصائرنا اليومية، في عالم التقنيات الحديثة، وعبر نسق الحداثة وما بعدها، وبهذا الصدد يقول باومان: “ما عادت الحداثة في هذه الأيام مهتمة بالحفاظ على البيئة، أو صيانتها، ولا بخلق الحدائق الجميلة مثلما فعلت الحداثة من قبل، وإن كل ما بات الناس يهتمون له في أيامنا هذه هو ملء حقائبهم حتى حوافها الخارجية، من غير أي اعتبار لما يتبقى للآخرين”.
في أحد فصول الكتاب ثمة حوار نابغ مع الكاتبة كارين آرمسترونغ تدور بعض أسئلته حول الأصوليات، فهي ترى في إجابتها عن ذلك أن “الأصولية كظاهرة، بدأت أولاً في الولايات المتحدة مع بواكير القرن العشرين، وقد كان الأصوليون البروتستانت الأمريكان هم رواد النزعة الدينية المتشددة” .
وفي السياق ذاته نجد أن كتاب “قوة الكلمات” من الكتب المستنيرة، ذلك أنه ينطوي على حوارات، وأحاديث ومقالات فكرية هامة، تعيد التوازن لحياتنا المعاصرة، تلك التي شابها الكثير من الاختلال في أزمنة الحداثة وتقدّمها الآلي، تقدّمٌ حوّل الكائنات الآدمية إلى سلعة، وإلى جزء من الآلة العاملة ليل نهار، حيث كل ذلك يجري بمشيئة قوى الرأسمال العالمي.
هاشم شفيق: عن القدس العربي

 العربية
العربية  English
English