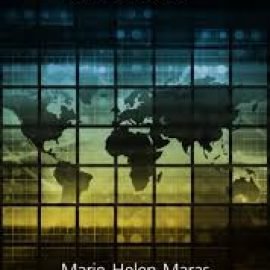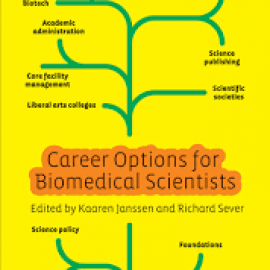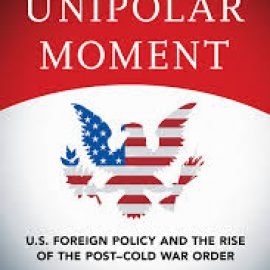الوصف
في كتاب منصف المرزوقي: حياته فكره (حوار – سيرة)، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يُقدّم معطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي حوارًا مطولًا مع محمد منصف المرزوقي، رئيس تونس الأسبق، يُكثَّف فيه عصارة تجربته السياسية والفكرية، وتجري فيه العودة إلى ذكريات طفولته وشبابه اللذين أمضاهما بين تونس والمغرب وفرنسا، إضافةً إلى حياته الشخصية، متحدثًا على نحو مُفصّل عن وقائع وأحداث سياسية عاشها، أو كان فاعلًا فيها، انطلاقًا من انخراطه في نضالات الطلبة العرب والأوروبيين، خلال دراسته الطب في فرنسا في أواخر ستينيات القرن الماضي، مرورًا بمعارضته سلطوية الرئيس الحبيب بورقيبة ودكتاتورية زين العابدين بن علي، إلى جانب ما تعرّض له من جرّاء ذلك من سجن، وطرد من وظيفته الجامعية، ومراقبة لصيقة من جهة البوليس السياسي، وصولًا إلى اندلاع الثورة التونسية في أواخر عام 2010، ومحاولات الثورة المضادة إفشال التحوّل الديمقراطي. يتألف الكتاب (212 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة فصول.
ناصري أولًا
يصوّر الفصل الأوّل، “من القرية إلى العالم”، انتقال المرزوقي من قرية فقيرة في ضواحي مدينة قرمبالية، جنوب تونس العاصمة في ولاية نابل، إلى العالم، وقراءاته، ونضاله. كما يبين هذا الفصل تأثّر المرزوقي أولًا بالقومية العربية؛ إذ يقول: “صورة جمال عبد الناصر كانت لا تفارق جدار غرفتي. كنت أعتبر نفسي ناصريًّا. في تلك الفترة، كان جيلي إمّا مع النظام وإمّا ضده، وبطبيعة الحال وبحكم تاريخ والدي النضالي، كنتُ ضد النظام. كما أن القوى السياسية الحاضرة آنذاك في تونس كانت إمّا قومية عربية أو يسارية. الإسلاميون لم يظهروا في الصورة إلا في أواخر السبعينيات”، مضيفًا قوله: “لم نكن نعلم في تلك الفترة عن الخروقات في حقوق الإنسان التي سادت حكم جمال عبد الناصر، فالصورة الطاغية لجمال عبد الناصر كانت تتمثل في ذلك الشخص الذي وقف في وجه إسرائيل والإمبريالية؛ والذي قام ببناء السد العالي، وعمل على تطبيق الإصلاح الزراعي لمصلحة الفلاحين الفقراء. لم أكتشف صورة المباحث والمخابرات إلا بعد فترة من الزمن. الآن، أعتبره جزءًا من التاريخ العربي المليء بالمواجع، على الرغم من أنه كان أقل الدكتاتوريين سوءًا”.
قبيلة غير قبلية
يقول المرزوقي في الفصل الثاني، “في مواجهة العاصفة”، إن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هو الذي أمر باعتقاله وسجنه، وهو نفسه الذي خلّصه من محنة المتابعات القضائية في بداية حكمه: “لمّا قمت بنشر كتاب دع وطني يستيقظ في عهد المرحوم بورقيبة، توبعتُ قضائيًّا بسبع تهم منها المس بهيبة الدولة والمس برئيس الجمهورية … إلخ. كانت لدي معلومات مؤكدة عما تقوم به النيابة العامة لإطاحتي وسجني، لأني تجاوزت الحدود بانتقادي بورقيبة ونرجسيّته، وكان القاضي يؤجل الجلسة بشكل متكرر، حتى أني أصبحت متعودًا الذهاب إلى المحكمة بشكل دوري في عام 1987. أمسك بن علي مقاليد الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 بعد انقلابه على بورقيبة، فأصدر القاضي حكمًا يقضي بعدم سماع الدعوى. قلت في البداية إن من الممكن أن يحدث انفراج سياسي على يد هذا الرجل قد يؤدي بنا إلى الديمقراطية، خصوصًا أنّه جاء في مرحلة إصلاحات غورباتشوڤ التي ستؤدي كما نعلم إلى سقوط جدار برلين وما عُرف دوليًّا بموجة الديمقراطية التي انطلقت من أوروبا الشرقية لتصل إلى قارات أخرى”.
في عام 1991، انطلق الصراع الحقيقي مع بن علي بخصوص قمع الإسلاميين وتعذيبهم. ويتحدث المرزوقي عن أيامه بفرنسا، حيث لامس طيلة سنوات الجمر وجود “قبيلة عقائدية” لا تجمع الناس على الانتماء إلى العرق أو الدين أو الأيديولوجيا، “إنّما تجمعهم على القيم. كان ذلك بالنسبة إلي اكتشافًا هائلًا، حيث تجد يهودًا يدافعون عن الفلسطينيين، وأوروبيين يدافعون عن العرب، وعربًا يدافعون عن الأفارقة. لم أكتشِف أفكار حقوق الإنسان من الناحية الفكرية فحسب، بل من خلال ذلك النسيج الجديد الذي يُبنى على أساس قِيمي عابر للقارات والأديان. يمكن القول إن الأمر شبيه بقبيلة غير قَبلية، بُنِيت على أواصر متينة”.
بكاء التنصيب
بحسب رأي المرزوقي، في الفصل الثالث الذي ورد بعنوان “من السجن إلى قصر الرئاسة”، لم يُتوقع أنّ “حادث استشهاد البوعزيزي سيكون القشة التي قصمت ظهر النظام وأنهته، وذلك لسبب بسيط يتمثّل في أنّ ذلك الفعل الذي قام به البوعزيزي سبق أن تكرّر تسع مرّات”. وبحسب رأيه أيضًا، أربك نجاح الثورة المنظومة الحاكمة، وتركها تخبط خبط عشواء للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، فأُجبرت على إعلان هروب بن علي، ثم تسمية الرئيس الجديد للبلاد بناءً على النص الدستوري المعتمد. ويعترف المرزوقي، في هذا الفصل، بخطأ القبول بأنصاف الحلول، قائلًا: “وكان علينا ألا نمنح الفرصة للنظام القديم، لكنّ هاجس انهيار الدولة كان مهيمنًا على وعينا الجمعي. قال البعض: لنوافق على استمرار بعض رموز النظام في السلطة من أجل تسيير دواليب الدولة لمدة ستة أو سبعة أشهر ريثما نعمل على إرساء أسس النظام الديمقراطي الجديد، وحتى لا نقع في فخ سقوط الدولة. لكن تلك الفرضية أثبتت فشلها وعدم نجاعتها، كأنّنا منحْنا الوقتَ الكافي للنظام القديم للتآمر على الثورة، وإخفاء ملفات الفساد العالقة في القصر والإدارة العامة”.
يتحدث المرزوقي عن لقائه راشد الغنوشي في باريس ولندن مرات عدة. قال إن بعضهم لم يكن يرى في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلا جماعة سياسية مؤلفة من بضعة أشخاص، وأنه لا وزن شعبيًّا لهم. ولكن حينما أُعلنت نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، “كانت المفاجأة: فوز حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تشرّفْتُ بقيادته، بالمرتبة الثانية بعد حركة النهضة”. ويقول المرزوقي حين انتخب رئيسًا: “لم أستطع التحكّم في نفسي ففاضت دموعي وأنا ألقي خطاب التنصيب. تذكّرتُ الشهداء وكلَّ من أدّى فاتورة النضال التي لا تقدّر بثمن، فلولا البوعزيزي وشهداء القصرين وسيدي بوزيد والرقاب وجلُّ الشهداء الذين سقطوا في ساحة معركة الحرية، لما كنتُ في هذا المكان”. ويسهب في وصف أيامه في قصر قرطاج رئيسًا.
يساري فديمقراطي
في الفصل الرابع، “اليسار والديمقراطية والعلاقة مع الإسلاميين”، يقول المرزوقي: “في سبعينيات القرن الماضي كنّا نعتبر أن الإسلام السياسي يسير بنا نحو التخلف والجهل. وفي أواسط الثمانينيات بدأ الصدام مع الإسلاميين في الجرائد والمجلات، وطغت النقاشات الفكرية معهم وحولهم. وقد كتبت في ما بعد كتاب سميته في سجن العقل، جاء فيه أن الإسلاميين يفكرون بالكيفية ذاتها التي يفكر بها الماركسيون، أي يُقرّون بأنهم وحدهم من يمتلك الحقيقة الدينية والآخرون يقرّون بامتلاكهم وحدهم الحقيقة الموضوعية، وبذلك فإنهم يتوفرون على البنية الذهنية نفسها، فصار الصدام بين الجهتين”.
يرى المرزوقي أن القمع يقوي الإسلاميين، وأنه لا يُمكن وضع الإسلاميين كلهم “في سلّة واحدة”؛ “فالكثير من اليساريين لا يميّزون بين التيار الإسلامي الديمقراطي والتيار المعادي للديمقراطية كالسلفية الجهادية مثلًا”. ثمّ إنّ أغلب اليساريين كانوا ضد الديمقراطية التعددية باعتبارها شكلية وبرجوازية، مُبرّرين موقفهم هذا بالقول إن جزءًا من الإسلاميين كان سلفيًّا عنيفًا في سبعينيات القرن الماضي، “لكنّهم يتناسون أني أنا كنت قريبًا من الماركسية، وحتى من فكر ماو تسي تونغ، وتبنيتُ في ما بعد أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ويقول المرزوقي حين كان قريبًا من التيار الماركسي من دون أن يصنف نفسه ماركسيًّا: “كانت لدي انتقادات وتحفظات على بعض الأفكار. مثلًا: أنا لا أتفق على أن صراع الطبقات هو المحرك الوحيد والمركزي للتاريخ، وكنت متأكدًا من أن ذلك غير صحيح. وكذلك الفكرة القائلة إن للطبقة العاملة اليهودية في إسرائيل والطبقة العاملة العربية بفلسطين المصالح نفسها، وهي فكرة لا تدخل العقل”. ثم تبنّى المرزوقي الفكرة الديمقراطية لكن مع بعض المراجعات والانتقادات، فـ “الديمقراطية عندما تقرن بالليبرالية الاقتصادية يمكنها أن تؤدي إلى كوارث”.
أمّا بشأن الحداثة، فيقول المرزوقي إن التحديث في العالم العربي “لم يؤسس كاستمرار لعملية أنطولوجية، أي إنه لم يفرز كنتيجة لمجموعة من التطورات والصراعات والأحداث التي عاشتها جماعة إنسانية محددة، إنّما فُرضَ من فوق، بسبب نضال نخب بعينها أو مصلحتها”.
إضاءات فكرية
في الفصل الخامس، “إضاءات على السيرة الفكريّة لمنصف المرزوقي”، تُفصَّل مسيرة المرزوقي من القومية والماركسية إلى اليسار الاجتماعي؛ فهو قد انتمى إلى اليسار العُروبي في وقتٍ مبكّرٍ، وتشبّع بالأفكار الثورية المستلهمة من أدبيات المنظمات الماركسية ومن المشروع الفكري والسياسي للوحدة العربية، “لكن مع تقدم تجربته في الحياة والانجذاب نحو فكرة حقوق الإنسان بدأ يبدي بعض الحذر من التفكير المُرتكز على الحتميات، أو التفكير اللاعلمي كما يُسميه. وتجذّر هذا الحذر مع مرور الوقت ليقرّر أخيرًا مراجعة فكرية شاملة قادته إلى التخلّص من الإرث السلطوي الغالب على صفوف اليسار المحلي وبين ظهراني القومية المنغلقة على الذات، ليعمل على المساهمة في تأسيس تيّارٍ ينهل من عُروبةٍ ثقافيّةٍ غير مؤدلجة، ويسارٍ اجتماعيٍّ يجمع العدالة الاجتماعية – الاقتصادية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وديمقراطيّةٍ سياسيّةٍ ليبرالية ترتكز على ضمان الحقوق المدنيّة والسياسيّة لشعب المواطنين”.
ينتقد المرزوقي في كتاباته أنظمة الحكم الشمولي التي تسعى إلى تبرير سياساتها القمعية باستخدام مفاهيم من قبيل “الصالح العامّ” أو “المصلحة العليا للجماعة” (وفي حالة العرب “المصلحة العليا للأمة”)، ويرى أنّ “البضاعة الأيديولوجية قد تبيع الوهم للفرد، الذي يجب ألا ينجرّ وراءها وينخدع بمفاهيمها الساحرة وغير الواضحة: الاشتراكية؛ حتمية التاريخ؛ التقدم؛ حق الأمة العربية … وغيرها”.
يقف المرزوقي ضد شخصنة الحكم واللغة المذهبية، ويمارس مقاومة الاستعمار ومجاهدة الاستبداد، ويدعو إلى تبنّي التفكير العلمي، أي التفكير القائم على الفرضيات لا الحتميات، ويرفض الشيوعية على النمط السوفياتي، كما أنه لا يُقرّ بالليبرالية الاقتصادية التي قد تخلط عن عمد بين حرية المبادرة وحرية الاستغلال، ويرفض كذلك تحميل الإسلام السياسي أو الثقافة العربية مسؤولية إخفاق أغلبية الدول العربية التي عرفت حراكًا سياسيًّا في عام 2011 في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.

 العربية
العربية  English
English