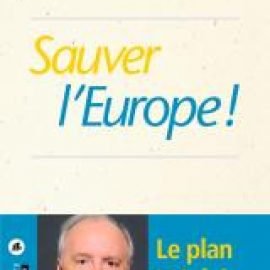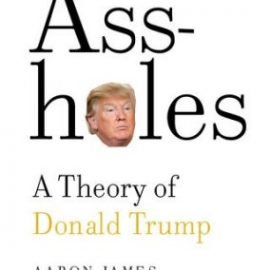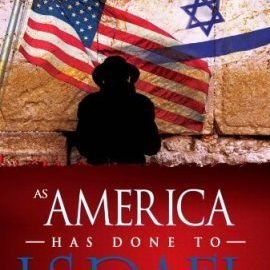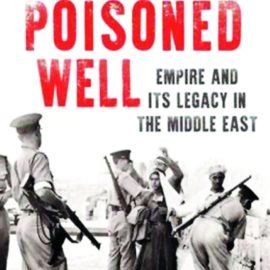الوصف
صدر عن مؤسّسة الفكر العربي الكتاب السنوي أوضاع العالَم 2020، تحت عنوان “نهايةُ الزَعامَة الأميركيّة؟”، وتضمّن دراسات معمّقة حول الهَيمَنة الأميركية، وقوّتها المتّسمة بالغلبة والجبروت، وعلاقاتها بالدول الأخرى، وتجلّيات أزمتها الراهنة في ظلّ الظروف الدولية المتغيّرة، التي يُعاد توزيع الأدوار والفُرص فيها بسرعةٍ كبيرة.
أشرف على الكتاب أستاذ العلاقات الدولية في المَعهد العالي للعلوم السياسية في باريس برتران بادي، والصحافي والمؤرّخ الفرنسي دومينيك فيدال، ونقله إلى العربية الأستاذ نصير مروّة. يشرح برتران بادي في تقديمه للكتاب، أنّ الغالب على استخدام الهَيمَنة كمفردة وكمصطلح، هو استخدامها كصورةٍ بلاغية وتعبيرٍ بيانيّ، وليس كمفهومٍ علميّ. وأنّه في حال الولايات المتّحدة، فإنّ الهَيمَنة برأيه أفضت إلى إذكاءِ العداء لها، وإلى تعميق الودّ والتعلّق بها في آنٍ معاً. ولا يزال مصطلح الهَيْمَنة هذا، مُرادِفاً لمفاهيم متنوّعة مثل الغلبة والسيطرة، وصولاً إلى المصطلح المدهش الذي وصفها “بالجبّار”، أو “بالقوّة الأعظم الأحادية”.
ويرى بادي أنّ أهمّ ما يُقال في هذا المجال إنّها هَيمنَة بدأت أحادية منفردة في العام 1945، أصبحت ثُنائية “مُتناظرة” وتنافسية لدى تحوّل الاتّحاد السوفياتي إلى قوّة نووية في العام 1949، وظهور ما سُمّي مذ ذاك بتوازن الرعب، والتعايُش السّلمي بين “القوّتَين العظميَين”. توازن كان يُفترض أن ينتهي بسقوط جدار برلين، وأن يُعيد إلى أميركا هَيمنَتها الأُحادية الأولى، لولا طارئ العَولَمة، وما يُرافقها من ترابُط بين الدول قويّها وضعيفها، وهو ترابطٌ يجعل القويّ مُرتهَناً للضعيف.
وهكذا فإنّ أميركا، ستكتشف بعد مغامرتَيْها اليوغوسلافية والعراقية، أنّها لا تستطيع تنظيم العالَم وفق إرادتها، ثم تصل أخيراً مع أوباما إلى ابتداع هَيمنَة رشيقة وحديثة قوامها الضغط المُتكتّم والتدخّل بواسطة الحلفاء، ثم وبخاصّة استخدام ما تتيحه العَولَمة من اتّفاقيات تجارية واقتصادية، لكنّها هَيمنَة ستقوّضها سياسات ترامب.
أميركا بدأت “انعزالية” كما يقول المؤرّخون، لكنّ الانعزالية هنا لا تعني “عزل النفس”؛ فهي لم تمنع واشنطن من توقيع مُعاهدتَين مع الصين في عامَيْ 1844 و1858، ولا عن إرسال أسطول عام 1854 لفتح اليابان أمام التجارة الغربيّة، كما لم تمنعها من المُطالبة منذ العام 1823، عبر مبدأ مونرو Monroe)) بالهَيمنَة على مجمل القارّة الأميركية (شمالها وجنوبها)، ولا حالت دون الحرب مع إسبانيا حول كوبا وكسب الفيليبين غنيمة حرب منها.
لقد سجّلت الحرب العالَمية الثانية نهاية حقبة طويلة من الغلَبة والسيطرة الأوروبية، وانتهت إلى بروز مُهَيْمِنٍ واحد، ثم إلى اثنَيْن كما بَيّن برتران بادي، الأمر الذي أدّى إلى قيام كتلتَين وهَيمنَتَين ومنظّمتَين دفاعيَّتَيْن (منظّمة حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو). وإذا كان توازن الرعب وقفَ حائلاً دون مُواجَهة مباشرة بين القطبَين، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الحروب بالواسطة: حرب كوريا في الخمسينيات، ثمّ حرب فيتنام وجوارها (لاوس، كمبوديا) ..
وفي المقابل، كان هناك قطاع واسع من الأميركيين يُدافع عن الرؤية التقليدية للمجتمع من خلال حركةٍ مُمانِعة مُحافِظة؛ أتبعها وصول المُحافظين إلى الحُكم عبر وصول نيكسون إلى سدّة الرئاسة، ومعه وزير خارجيّته، كيسنجر، “داعي دُعاة” السياسة الواقعية، وهذا يقود إلى الحديث عن الليبراليين الآخرين الذين اشتهروا باسم المُحافظين الجُدد. وهنا يطرح فريديريك شاريون السؤال عمّا إذا كان يصحّ الكلام على فشل المحافظة- الجديدة؟
الليبرالية الأميركية هي “مذهب الأمّة الرسمي”، هي باختصار مُحافظون جُدد “طموحون” في مقابل واقعيّين، أو “صقور” في مقابل أهل رويّة وفقاً لتوصيف فريديرك شاريون. لكنّ عهد المُحافظين الجدد انتهى بانتخاب باراك أوباما في العام 2008، وقد حاول أوباما جاهداً، كما يلاحظ سيلفان سيبيل، الإجابة عن مختلف الآمال والرجاءات، لكنّ عهده بدأ بأعظم أزمة شهدتها البلاد منذ أزمة الكساد العظيم. ثم توقّفت مساعيه كلّها مع انتخاب دونالد ترامب في العام 2016، والعودة إلى ما يشبه أن يكون الانعزالية القديمة، التي يوجزها شعار “أميركا أوّلاً”، خير إيجاز حتى اليوم. فالرئيس الجديد حمل معه كما يُشير جيل باريس بقايا تفوّقية عرقيّة وانعزاليّة؛ وعلى الرغم من أنّه يتخلّى عن تعهّدات الولايات المتّحدة وينسحب من اتّفاقات ويهدّد بتعطيل مُعاهدات، إلّا أنّه لا يتخلّى حقيقة عن “دَور شرطي العالَم التائب ولا يتوقّف عن الانبهار بالقوّة: أَفَلَم تصل ميزانية البنتاغون معه، إلى أعلى حدّ تاريخي بلغته حتى اليوم (760 مليار دولار)؟”
ويسأل روبير مالّي: هل تكون الولايات المتّحدة في حالة تقهقُرٍ سياسي دبلوماسي الآن؟ فالأمّة التي أسموها بالأمّة التي لا غنى عنها، باتت قيد التهالك والاستنفاد، لكنّ هذا التقهقر لا يمنع البنتاغون من مُواصَلة السعي إلى تحقيق تفوّقٍ عالَمي شامل كما يُلاحظ مايكل كلير، لتأمين “الانفراد بالتفوّق” وتجاوز الخصوم تجاوزاً “بلا حدود”، والتخلّي عن المُعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، التي هي الأساس النهائي للأمن وللسلام.
لكنْ إذا كان الأخصام يغضبون من مثل هذه الاستراتيجية، فماذا عن الحُلفاء؟ الرأي عند نيكول غنيسوتو هو أنّ هناك تحالفات وحلفاء الحرب الباردة، وهُم الأوفياء بالضرورة. وهناك الحلفاء اختياراً كبريطانيا، فضلاً عن بلدان أوروبا الشرقية التي دخلت مؤخّراً في التحالُف الأطلسي، وهناك أخيراً الحلفاء الأوفياء فرقاً وخوفاً: كالحلفاء في عهد ترامب.
يبقى أنّ بين الولايات المتّحدة والتعدُدية الدولية، تاريخ جفاء مُستدام كما ترى آنّيك سيزيل. أمّا جان مارك سيروين، فيلاحظ أنّنا إزاء هَيمنَة تجارية مُعرّضة للتهديد، وخصوصاً مع ظهور أمواج التدفّق الصيني المُتلاطمة. ويشير الاقتصادي دومينيك بليهون إلى أنّ الدولار الذي كان محور النظام النقدي الدولي، بات سلاحاً يجنح إلى التآكل.
ويتناول شارل تيبوت مسألة الغلبة التكنولوجية، والمنزلة المركزية التي تحتلّها التكنولوجيا في العالَم السياسي والاجتماعي الأميركي: فالليبرالية الأميركية هي عملياً فكر “الخبرة والخُبراء”؛ وكائناً ما كان الأمر، فإنّ الغلبة التكنولوجية الأميركية تجد نفسها الآن في مُواجَهة التحدّي الصيني الذي بات يهدّد الأنموذج الأميركي.
أمّا الجانب الثقافي فتناوله أدريان ليرم، أستاذ الحضارة الأميركية في السوربون، الذي يجد أنّ الولايات المتّحدة تُثير الدهشة لجهة مَوقع الصدارة الذي لا تزال تشغله في الميدان الألسُني والثقافي والعِلمي، على الرغم من ظهور مُنافسين مُحتَمَلين لها. وهذا التصدّر القائم منذ زمنٍ طويل، لم يذوِ ولم يضعف، بل إنّه يُعطي الانطباع بأنّه يتعزّز ويتوطّد. فهو ما انفكّ، منذ نهاية الحرب العالَمية الثانية، يواكب الإشعاع الدولي للبلاد، كما أنّ اللّغة الإنكليزية باتت اللّغة المسكونية الجامِعة، يتكلّمها 800 مليون، ويتعلّمها خلقٌ لا يحصون عدداً، كا أنّ الجامعات الخمس الأولى في العالَم هي أميركية.
والواقع هو أنّ لهذا الكلام كلّه على الولايات المتّحدة خبيئاً مُضمَراً يُدعى الصين. ودومينيك باري يتحدّث عنه صراحةً كما يتبدّى في لعبة الشدّ والجذب المستمرّة معها. إنّها السياسة الأميركية ذاتها، ولو كانت هادئة مع أوباما، صاخبة مع ترامب.

 العربية
العربية  English
English