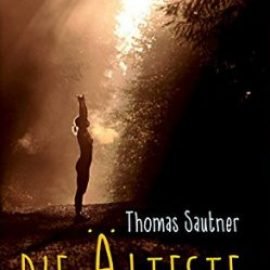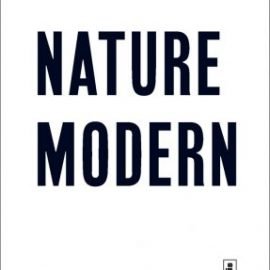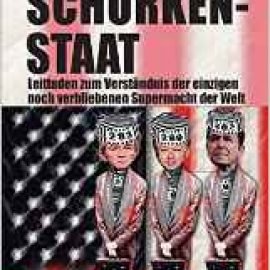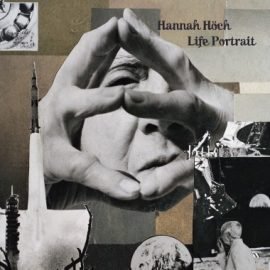الوصف
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
كرة القدم – اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم- ليست ظاهرة مستقلة عن السياقات التاريخية الإنسانية، شأنها في ذلك شأن الظواهر الكبرى كالتدين مثلا وإن كانت أحدث منه بكثير، فعمرها لا يتجاوز تقريبا نحو 150 عاما، لكنها تكاد “تكون عينة نموذجية لتاريخ القرن العشرين”، كما كتب الباحث النمساوي فيندلين شميت-دينجلر، وهي “ليست مجرد انعكاس للعلاقات الاجتماعية، بل إنها تقدم نفسها أيضا “كنموذج للواقع” في أقصى صور التعبير، وكأنها جهاز لقياس الزلازل يقيس التغيرات والتحولات الاجتماعية والسياسية”، كما تقول الباحثة السياسية النمساوية إيفا كرايسكي.
في هذا الكتاب يسعى كلاوس تسايرينجر إلى فك شفرة العلاقة بين كرة القدم والتاريخ والمجتمع والسياسة، فيرسم خطوط تطورها من تسلية للنخبة الإنجليزية في القرن التاسع عشر حتى آخر بطولة لكأس العالم في 2014، حيث كانت كرة القدم في بداياتها الأولى –وفق تحليل تسايرينجر- لعبة بسيطة وباردة، وكان انتشارها حول العالم ما بين 1880-1930 متوافقا مع تمثيلها لأسلوب الحياة الإنجليزية الذي كان بالنسبة لكثير من رجال الطبقات العليا والوسطى على مستوى العالم مثالا للحداثة، وقد دعمت القوة الاستعمارية والصناعية لبريطانيا العظمى اقتصاد السوق والنظام البرلماني ونجاح السادة الذين كانوا يعتبرون ليبراليين ومتعطشين للمغامرة التجارية وغريبي الأطوار، وعندما تكون مثل هذه الحياة لعبة قتالية ومعركة رياضية، حيث يجري اللاعبون وراء كرة من الجلد من الطبيعي أن يتسابق الناس بالفعل وراء “كرة من الجلد”.
“وبما أن كرة القدم كانت منذ العشرينيات الرياضة السائدة في كثير من المجتمعات الوطنية فقد ساعدت في بناء الأمة، وارتقت المنتخبات الوطنية إلى مستوى الأسطورة في تصور المجتمع، ونقلت سردية العلاقة بين الانتصارات الكروية والتقدم تفسيرات بسيطة لعمليات معقدة، فقيل في مونتيفيديو –مثلا- أن تحديث أوروجواي نشأ على يد اثنين “فاريلا”، الأول هو خوسيه بيدرو فاريلا إصلاحي النصف الثاني من القرن الـ 19 والثاني أوبدوليو فاريلا كابتن منتخب أوروجواي الذي فاز ببطولة العالم عام 1950”.
يعرض الكتاب لطريقة المعالجة الإعلامية لهذه الرياضة في البدايات، ومدى أهمية دور الصحف والإذاعة والتلفزيون كقوة محركة روجت لمسيرة انتصار كرة القدم على ما عداها من الرياضات، ومع انتشار كرة القدم لتصبح لعبة عالمية: يظهر التداخل في التاريخ الثقافي بين القارات، وتظهر الخصائص الفردية لكل مجموعة ثقافية، ويعرض المؤلف لعاملين ربما كانا الأكثر أهمية في نجاح هذه اللعبة هما انفتاح مجال كرة القدم على جميع الطبقات (وهذا ينطبق على اللاعبين والمتفرجين) وطرق اللعب المثيرة للدهشة، فكرة القدم كما يقول الأرجنتيني خورخي فالدانو المدير التنفيذي الأسبق لريال مدريد تمتلك “قدرة خيالية على التكيف، وهي تتكيف مع أي اقتراح للحداثة رغم أنها في حد ذاتها رياضة بدائية، وأقيم ما فيها أنها تعمل من خلال العاطفة، ولذلك لا تكبر في السن أو تصاب بالعجز”.
يرى المؤلف -وبشكل مقنع تماما- أن كرة القدم كانت الرياضة المناسبة في الوقت المناسب خاصة عندما غير التصنيع واتساع المدن شكل المجتمعات، وكما أوضح ماكس فيبر بدأت “البيوت الحديدية” للحداثة بمبدأها العقلاني كنوع من الالتزام الصارم بالقواعد والانضباط في الانغلاق، وكانت قواعد كرة القدم وتنظيم البطولات تحقق ذلك تاركة أيضا مساحة لمتعة اللعب، وبذلك استطاعت جميع الطبقات أخيرا التحرك في هذا المجال دون شعور بالضيق أو التأفف.
وفي هذا النوع من الدراسات العلمية يستطيع من مارس كرة القدم أن يجد ما أدركه نتيجة للخبرة المباشرة مصاغا بطريقة تبدو أكثر تركيبا، فعلى سبيل المثال: “عالجت الحداثة تصورات الذات والهوية والمكان والزمان من جديد، فلم تفرض رياضة الفريق “تشكيل الذات” على النحو الذي فعلته المؤسسة العسكرية، بل أعطت داخل الفريق مساحة من الحرية الفردية ودعمت في الوقت نفسه هوية جماعية.. حددت الملاعب نطاقا خارج الزمن الاجتماعي المعتاد، فعندما يدخل الناس إلى المدرجات تقف الحياة اليومية ساكنة، وعلى مدار عقود طور الجمهور طقوسا للعبور لكي يحدد أنه هنا يغادر نطاق الحياة العادية، وفي هذا النطاق “الساحة” يستقبل المشهد والترفيه الذي يمكن أن يسبغ عليه في هذا الإطار مشاعر قوية ويتعامل معه بجدية: وهنا تحركه الحالة الجماعية”.
وفي متابعته للعبة على العشب لا يميل المؤلف إلى التقعير الفكري، مثل كلاوس تيويليت في “مرمى العالم”، بل يقدم التاريخ الثقافي لتطور كرة القدم في كل بلد على حدة ولكن من خلال المنظور العالمي تنشأ في التركيب التشابهات والخطوط العامة، ومن بينها تلك الصلة بين كرة القدم والطقوس الدينية والقومية القديمة، “فالطقوس المعتادة التي تمارس الآن على مستوى العالم هي مزيج من موكب النصر الروماني وتقديم القرابين المقدسة ومشهد الشرفات السياسية”، فعند “تسليم درع الدوري الألماني، يرفعه البدلاء العصريون “لرؤساء الكهنة” [بلغة العصور القديمة] لكي يراه المؤمنون الذين يشاركون في النشيد، ومن الاستاد يسير الموكب إلى وسط المدينة، ومن سلطة الرياضة إلى سلطة السياسة تماثل جولات الفرق المنتصرة التي تحتفل بها الجماهير على جانبي الطريق مواكب العائدين منتصرين من المعارك في روما القديمة”، و”يطل أسياد اللعبة من شرفة مقر البلدية، يقفون فوق الجماهير يرفعون الكأس الآن ليراه الناس في الفضاء العام، يتم أداء مشهد شرفة شعبي في مسرح سلطة معروف تريد أن ترى نفوذها متجسدا”.
ولم تأخذ كرة القدم من الدين طقوسه فقط، بل بعضا من أساطيره أيضا، ونسجت على منوالها، ثم صنعت لنفسها أساطير أخرى بلغة ووعي اللحظة المعاصرة، “فاصطبغت أسطورة مارادونا في الأرجنتين [مثلا] بالمكونات الأساسية لتاريخ الخلاص المسيحي: الأصل الفقير ودافع البشارة، وكان يُحكى بجدية -كما كان يحدث من قبل- أن مارادونا أعلن عن مجيئه قبل ولادته بركلة من قدمه، وأن أمه صاحت لحظة ولادته “جوول!”، وأنه قال أمام كاميرات التليفزيون عندما كان في التاسعة من عمره إنه يريد أن يلعب في الدوري الممتاز والمنتخب الوطني وأن يفوز بكأس العالم”.
يستعرض المؤلف أيضا العديد من العناصر المشهدية يبدأ بها كل فصل من فصول الكتاب، معتمدا على مجموعة واسعة من المصادر وعلى الاقتباس من كثير من الشعراء والمفكرين المعروفين من بينهم ألبير كامو وتيودور أدورنو ويورجن هابرماس وفرانز كافكا، بما يدعم أفكاره عن دور كرة القدم، لكنه يقدم للمطلعين على كرة القدم مفاجآت أيضا، مثل إثباته أن الجذور الأولى لنشأة فريق برشلونة تعود إلى سويسرا، وإشارته إلى أن أسلوب اللعب البرازيلي الجمالي “جوجو بونيتو” قد استخدمته أنظمة الحكم في البداية للتعبير عن الهوية البرازيلية، وأن فن المراوغة الأسطوري لدى لاعبي أمريكا اللاتينية ينبع من عدم احتساب الفاولات التي يرتكبها اللاعبون البيض ضد اللاعبين السود في السنوات الأولى مما فرض عليهم أن يجيدوا المراوغة ليتجنبوا الإصابات ودون ردع لمرتكبها في الوقت نفسه.
من المشاهد الطريفة التي يرصدها المؤلف مشهد لاعبي فريقي هايدوك الكرواتي وريد ستار الصربي في مايو 1980 وهم يتوقفون عن اللعب إثر سماعهم نبأ وفاة تيتو من الإذاعة الداخلية في الملعب، وينخرطون في البكاء والعويل، وكأن تيتو كان وحده الذي يجمع معا مثل هؤلاء الفرقاء (الكروات والصرب وغيرهم من المكون العرقي ليوعوسلافيا السابقة) ويمنع ما حدث لاحقا من قتال ومجازر بدأ بعضها في ساحات الملاعب.
وفي المجر في زمن “الاشتراكية” يمكننا أن نتخيل مسار تاريخ ذلك البلد الذي غزته القوات السوفيتية عام 1956 لو أن “تسديدة لاعبها ران أخطأت المرمى وأحرز بوشكاش الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3: 2 للمجر” فتفوز بكأس العالم 1954 بدلا من ألمانيا، كانت الفرحة -وليس السخط- سيسود في أوساط الجماهير المجرية، “وكان النظام سيستفيد من الانتصار ليغطي به على السخط السياسي، وكذلك لم تكن لتحدث انتفاضة في 1956، وبالتالي لا يحدث ذلك الاستياء الهائل في الكتلة الشرقية – وهلم جرا” حسب تصور الكاتب المجري بيتر إسترهازي.
وهو ما يقودنا هنا إلى الموضوع الرئيسي للكتاب: التداخل ما بين كرة القدم والسياسة، الذي يمتد – ليس فقط في عهد هتلر أو ستالين أو فيديلا – كخيط ثابت عبر تاريخ اللعبة، يتمثل عادة في التوظيف السياسي لكرة القدم الذي يدعمه في الغالب مسؤولون عن كرة القدم سذج أو جهلة، وهنا تبدو إشارة المؤلف لعدد المرات التي استخدمت فيها الملاعب كسجون أو أماكن اعتقال أو إعدام صادمة، بينما يبدو اتهامه الصريح للفيفا بأنها تتصرف كما لو كانت “دولة داخل الدول” في نهاية الكتاب أقوى مكونات هذا الكتاب، ومن خلال استعراضه للاحتجاجات التي اندلعت في البرازيل بالتوازي مع تنظيم كأس العالم 2014 بها والاتهام بالفساد حول تنظيم كأس العالم 2018 في قطر يظهر الكاتب بشكل متعمق جانبا من “التاريخ المخزي” لهذه الرياضة.
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)

 العربية
العربية  English
English