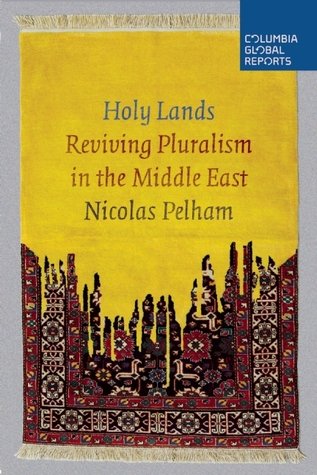الوصف
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
الأراضي المقدسة.. إحياء التعددية في الشرق الأوسط
من المفترض بديهياً أن يكون مرادف مفهوم “الحداثة” الواقعي في العالم بأسره، هو التسامح والتقدم، ولكن بطريقة أو بأخرى، فإنها لم تسر على هذا النحو أبدا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
هكذا يستهل المعلق الأمريكي جوناثان بيركى مقاله التحليلي عن كتاب نيكولاس بيلهام “الأراضي المقدسة.. إحياء التعددية في الشرق الأوسط” الصادر حديثا عن مؤسسة “كولومبيا للتقارير العالمية” بالولايات المتحدة، حيث شهد “بيلهام” الكثير من الأحداث المأساوية التي مرت بها المنطقة خلال عمله كمراسل لصحيفة “إلإيكونوميست”، وهو يقدم في كتابه خلاصة تجربته ورؤيته الحيادية.
ويقول المؤلف إن الشرق الأوسط أكثر تسامحا وانفتاحا من أوروبا الغربية، قبل أن تقوم القوى الغربية بتقسيم الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وتحويلها إلى مجموعة من الدول العلمانية؛ لكن المشروع الغربي فشل بامتياز، حيث تراجعت التعددية الدينية في المنطقة بعد سقوط العثمانيين.
ويرى “بيلهام” أن “المستقبل يكمن في الماضي” أي إعادة “النمط العثماني” إلى الحياة. ولتعضيد هذه الفكرة المحورية، يستشهد الكاتب برأي البروفيسور شارل عيساوي أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون خلال (1970- 1980) والذي كان يرى أن كل هذه المشاكل والصراعات في المنطقة يمكن أن تحل إذا عادت الإمبراطورية العثمانية للحياة من جديد، باعتبار أن ذلك – في تقديره- أفضل بكثير من الدول التي حكمها أبناؤها، والتي أججت تلك الصراعات وأبقت على الخصومات العرقية والطائفية.
وهذه الصراعات، كما يقول الكاتب، لم تختف إبان الحكم العثماني، ولكنها للحقيقة لم تنفجر إلى “جروح مفتوحة” تنزف إلى ما لا نهاية. صحيح أن معظم صراعات الشرق الأوسط نبعت بطريقة أو بأخرى من الاختلافات الثقافية القديمة، ولكن الجديد هذه المرة هو اشتعال الصراع الطائفي العنيف وعلى نطاق أوسع، ومحاولة قمع “ثقافات الأقليات”.
ويقول “بيلهام” إن “السنة والشيعة، والعرب، والأكراد، والأتراك، والأرمن.. كل هذه المكونات كانت موجودة في الشرق الأوسط منذ قرون، وعلى امتداد الأزمنة والعصور، فقد شهد سكان المنطقة مستوى من التنوع لم يعرفه من قبل الذين يعيشون الان في أوروبا أو أمريكا الشمالية، على الأقل حتى العقود الأخيرة. وللضرورة الملحة وضعوا آليات للتعامل مع هذا التنوع وخاضوا في المياه الضحلة الصعبة من الاختلاف الثقافي، ولكن ظروف العصر الحديث أخلت بهذا التوازن، وتحول الاختلاف إلى صراع مدمر، فما هي هذه الظروف التي أدت لذلك”؟
يجيب المؤلف أن تلك الظروف تمثلت في وجود عدد من الصراعات بين الطوائف، والتي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن العنف الذي كان يواكب هذه الصراعات، ففي الوقت الحالي هنالك العنف المرتبط بما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية” أي “داعش”، والذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال عن هذا التنظيم، ولكن بصفة عامة، فإن أجندتها السياسية هي التعصب البراغماتي. غير أن العنف الذي يصدر عنه يعكس حالة من التهميش، ويمكن القضاء عليه إذا أمكن القضاء على الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية.
وكان نصيب بعض الجماعات الدينية أسوأ بكثير من غيرها، فـ”الإيزيديون”، على سبيل المثال، وهم أتباع ديانة توفيقية تعتمد على عناصر من الإسلام والمسيحية والزرادشتية، وتقاليد بلاد ما بين النهرين القديمة، دمرت طائفتهم تماما، وقُتل منهم الآلاف، ونزح عشرات الآلاف من منازلهم، وسيقت النساء والفتيات “الإيزيديات” كعبيد لخدمة المطالب الجنسية لمقاتلي “داعش”.
والهاجس الأكبر عند مقاتلي التنظيم هو أعداء المسلمين، ولأن “داعش” من أهل السنة فهو يتهم الشيعة بالهرطقة ويطلق عليهم لقب “الروافض”، وهم في نظر مقاتلي “داعش” وغيرهم من المسلحين السنة، رافضين للتاريخ الإسلامي، وهو ما أثار الذعر في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق، ودفع الزعماء الشيعة المتنازعين في نهاية المطاف للعمل معا لتنظيم رد على هجوم “داعش”.
وليس الشيعة هم المسلمون الوحيدون الذين طالهم سخط هذا التنظيم السلفي، ولكن أيضا بعض الأشكال الرجعية من أهل السنة أنفسهم، حيث كان مفهوم “الخلافة الإسلامية” صورة رمزية للنضال ذات توجه روحي حتى وقت قريب، ويمكن القول إنها كانت المهيمنة وكانت الشكل السائد لـ”التقوى “في كثير من بلدان العالم الإسلامي.
وقد أصيب العالم بالذعر عندما قام “داعش” بتدمير آثار ما قبل الإسلام في مدينتي “تدمر” السورية و”نينوى” العراقية، وكان الأكثر كارثية هو تدمير الأضرحة والمساجد والمزارات الصوفية، وتقريبا أي مقام أو مزار أصبح هدفا للتدمير بالتجريف أو بالديناميت ليصبح ركاما، كما تم بناء مسجد سني في الموصل على أنقاض ما يعتبره المسلمون والمسيحيون قبر النبي “يونان”، (أو “يونس” كما هو معروف في القرآن الكريم).
تعصب استثنائي
والتعصب لدى “داعش” هو تعصب استثنائي يصل حد المرض، فقد دمر التنظيم أبرز المقابر والأضرحة الصوفية في العراق وسوريا، كما فعل عملاؤه في ليبيا نفس الشئ، وتم اضطهاد الشيعة الذين أوقعهم حظهم السيئ أن يعيشوا تحت حكم التنظيم.
غير أن التعصب في الواقع، كما يقول المؤلف، هو فكرة مهيمنة في تاريخ الشرق الأوسط خلال القرن والنصف الماضي، وهو محاولة لفرض النموذج السائد أو القاعدة الثقافية، الدينية، أو العرقية، أو تهميش “الآخر” أو حتى إنكار وجوده. وفوق كل ذلك كان الموضوع مطروحا في مختلف القوميات حتى وقت قريب، وكان ضمن الأجندة المطروحة في جميع أنحاء المنطقة، فهي تقف وراء سياسة الحكومة التركية في إنكار ورفض الحكم الذاتي للشعب الكردي، وجهودها لقمع الثقافة والهوية الكردية، ولسنوات عديدة، كان الأكراد في شرق الأناضول مهملين ومرفوضين وكانوا يسمونهم “أتراك الجبل”.
وعلى النقيض من ذلك، كانت الإمبراطورية العثمانية متسامحة بشكل ملحوظ، وكان تضم الكثير من عناصر التنوع الثقافي والديني والعرقي. وكانت الدولة العثمانية ترغب في تسوية تركية في الأناضول بعد هزيمة الجيش البيزنطي، وظلت اللغة التركية جنبا إلى جنب مع اللغتين العربية والفارسية، موجودة لأغراض دينية وأدبية وكانت اللغة الرسمية للدولة.
ولكن لم يكن العنصر التركي، بأي معنى، هو العرق الحصري، على الأقل حتى السنوات الأخيرة. بل على العكس من ذلك، فلفترة كطويلة من التاريخ كان ذوى الأصول التركية، من الناحية النظرية على الأقل، مستبعدين من العديد من المناصب القيادية في الدولة وقواتها المسلحة، وكان الغرض من هذا النظام هو خلق طائفة عسكرية وإدارية يكون ولاؤها فقط للسلطان والدولة، وبالتالي ترتفع البلاد فوق أي مطالبات من أية جماعة عرقية.
والأكثر أهمية في رواية “بيلهام” بعيدا عن النظام القانوني أو العسكري للدولة العثمانية، كان عن الملة، حيث كان الدين بدلا من العرق هو الأساس الذي تتعرف من خلاله على الدولة وعلى علاقتها برعاياها. فكل جماعة دينية تشكل ملة، وهى كلمة عربية تعني “الدين” أو “المجتمع الديني”. ومن خلال هذه الملة تحكم الحكومة العثمانية في المسائل المتنوعة. وكل ملة كان يقودها رئيس طائفة دينية (مثل البطريرك في الكنيسة الأرثوذكسية) وكانت تتمتع بحكم شبه ذاتي، وإدارة خاصة بها في أمور الدين، وتطبيق وإنفاذ القوانين الدينية، حيث كانت الملة هي القناة المؤسسية للتسامح العثماني في مجال الاختلاف الديني.
وكانت نظام الدولة العثمانية، وفقا لمعايير الدولة الحديثة اليوم، هو نظام الحكم المتسامح الذي يحترم المجتمعات غير الإسلامية تطبيقا للفهم المعتدل للشريعة، الذي يعطى حقوقا واسعة لأهل الذمة باعتبارهم “شعوبا محمية”، تُمنح حكماً ذاتياً من قبل الخلافة الإسلامية.
أما الطوائف الأخرى الذين هم خارج الديانات السماوية غير الإسلامية (الإبراهيمية واليهودية والمسيحية)، مثل “الإيزيديين” فقد تم وضعهم أيضا تحت عهد الحماية ولكن هذا لا يعني أن المجتمعات الإسلامية قبل العصر الحديث كانت بمثابة “يوتوبيا” بالنسبة للأديان، فقد كانت الحماية والحكم الذاتي جانبا واحد للعملة، وكان الحرمان السياسي والمواطنة من الدرجة الثانية هو الوجه الآخر للعملة، غير أن التسامح كان حقيقيا ويستحق التقدير، ويستدل على ذلك بواقعة طرد اليهود من إسبانيا عام 1492، فقد لجأ معظمهم الى الإمبراطورية العثمانية وليس إلى أوروبا .
وبحلول أوائل القرن العشرين أصيبت الإمبراطورية العثمانية بداء القومية، وهى أيديولوجية سياسية، على الأقل في أشكالها الشرق أوسطية إن لم يكن أيضا في معظم البلدان الأخرى، تمجد مجموعة عرقية باعتبارها متفوقة على أي مجموعات أخرى، وهو التطبيق التركي لـ”الشوفينية”. ورفق ذلك ظهور “لجنة الاتحاد والترقي”، وهو الحزب السياسي المعروف شعبيا باسم “تركيا الفتاة”، والذي هيمن على السياسة العثمانية في العقود الأخيرة من الإمبراطورية، ونما على نحو متزايد على الرغم من أصوله الليبرالية ومتعددة الأعراق.
وارتُبكت عام 1915 مجزرة مخطط لها بعناية قتل فيها 600 من الأرمن في العراق على يد رجال القبائل الكردية ولكن بتحريض من الحكومة التركية. وكان الحادث مأساويا بكل المقاييس، خاصة أن الأرمن كانوا لفترة طويلة يقال عنهم من قبل العثمانيين أنفسهم بأنهم “الملة الصديقة أو المخلصة”.
صعود القومية التركية
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية في 1918-1919، قام مصطفي كمال، المعروف باسم “أتاتورك” (أبو الأتراك)، بتأسيس الجمهورية التركية الحديثة في الأناضول، وكانت أولى قراراتها هي طرد الملايين من المسيحيين اليونانيين من الأناضول، وتوازى مع ذلك طرد الأتراك من اليونان، ومحاولة الاستيعاب القسري للأكراد. ووجد القوميون الأتراك أنفسهم في صراع مع العديد من المجموعات العرقية الأخرى، مثل اليونانيين والأرمن والأكراد والعرب، بعد أن كانوا يحتضونهم.
وكان صعود القومية التركية بمثابة محفز لانشقاق المنطقة على أسس عرقية، وظهور القومية العربية، التي كانت في جزء منها ردا على “الشوفينية التركية” التي أصابت الحكم العثماني في وقت متأخر، فظهرت العديد من مظاهر التعصب القومي والتنافس بين الهويات العرقية والثقافية في الشرق الأوسط.
وكانت “الملة” وثيقة التسامح العثماني للأقليات الدينية، ووفق هذ المفهو، كانت الهوية الطائفية غير مرتبطة بالمكان. حيث التصقت بالناس، وليس بالأماكن. والآن فإن الهوية الطائفية غالبا ما تكون مرتبطة بالمطالبات الحصرية لبعض دول المنطقة. وكانت النتيجة في كثير من الأحيان هو اضطهاد الأقليات، أو تهجير السكان قسرا ، ونشوب الحروب الدموية التي يطلق عليها “بيلهام” اسم “إبادة الملل”.
وهذا هو جوهر كتاب “بيلهام”: سلسلة من الحكايات التي توضح انقسام مجتمعات الشرق الأوسط إلى “قليل من الدول الوحدوية” التي تم القضاء عليها، ودول أخرى متعددة الطوائف، هى بقايا الإمبراطورية العثمانية. وبطبيعة الحال، فإن سوريا تعتبر رقم (1) في هذا التطور التاريخي،. وقد لاحظنا خلال الاحتجاجات التي قام بها الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد والتي بدأت في ربيع عام 2011 قد تحولت إلى حرب أهلية بشعة، تنامت خلالها الهويات الطائفية بشكل متزايد حتى صارت هي القاعدة الأساسية للمواءمة السياسية.
ولكن الفوضى الطائفية في العراق كانت مبكرة، لذلك يمكن القول بأن عواقبها كانت أكبر نتيجة الغزو الأميركي للعراق في مارس 2003، فقد أثار الغزو التوترات بين السنة والشيعة، وكانت السنة هي المسيطرة على الأوضاع تحت حكم النظام “البعثي”، ثم شعرت بعد ذلك بأن البساط “يُسحب من تحت قدميها”.
وبحلول عام 2005، كان العراق قد انزلق إلى حرب أهلية شرسة، بعد انهيار حوار “التوافق الوطني” في ظل الحكومات التي هيمن عليها الشيعة ابتداء من رئيس الوزراء نوري المالكي، وحتى الآن في حكومة حيدر العبادي.
وعملت حكومة الولايات المتحدة في نهاية المطاف للتوفيق بين العراقيين السنة وعودتهم إلى النظام السياسي فيما بعد صدام حسين، ولكن المالكي، الذي تم اختياره رئيسا للوزراء بموافقة أمريكية، بجانب جهود الولايات المتحدة في تجريد العشائر السنية من الدعم المالي، وأيضاً فشلها في كبح جماح الميليشيات الشيعية المختلفة، ما جعل الوضع يزداد سوءا في السنوات الأخيرة تحت حكم الشيعة، وحتى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، الذي كثيراً ما كان بمثابة “صوت ضبط النفس والتوفيق”، بات يحشد لصد التقدم الرهيب لـ”داعش” في المنطقة. وكان نتيجة ذلك هي زيادة تمكين الميليشيات الشيعية والسياسيين المرتبطين بإيران.
وشهدت بغداد، حسب المؤلف، عمليات تطهير طائفية للسنة من قبل الشيعة الذين كانوا جيرانهم بالأمس، كما أن السنة الذين كانوا يعيشون في المدن الجنوبية مثل البصرة، في قلب المنطقة الشيعية، أُخرجوا من ديارهم ومنهم من لاذ بالفرار، ملمحا إلى أن الحل هو: تقسيم العراق إلى دويلات بين الشيعة والسنة والأكراد.
من جهة أخرى، أكد بيلهام أن الصراع “الإسرائيلي- الفلسطيني” قد تحول من صراع قومي إلى صراع ديني. مشيراً إلى الدور الرئيس للفلسطينيين في نشأة “حركة الجهاد”، وأنه في النصف الأخير من القرن العشرين، كان القوميون العلمانيون هم المسيطرون على الحركة الفلسطينية، خصوصا “حركة فتح”، والتي كانت النواة الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبذلك، كان أول من قام بالتعبئة الفعالة للمقاومة الفلسطينية ضد الصهيونية هو عز الدين القسام، الذي كان خطيبا وواعظا في حيفا، وكان يعتنق عقيدة “الصحوة الإسلامية والجهاد ضد المحتل”، ولقد قتل القسام على يد البريطانيين في أواخر عام 1935، ورغم موته إلا أنه كان مصدر إلهام للثورة العربية التي تحدت الحكم البريطاني في فلسطين عشية الحرب العالمية الثانية.
وبرز الفلسطينيون بشكل خاص في الحركات الجهادية الحديثة، فهناك عبد الله عزام، على سبيل المثال، وكان مرشدا لأسامة بن لادن، وأحد القادة الأوائل لما أصبح بعد ذلك تنظيم “القاعدة”، وأيضاً حماس التي برزت كمنافس لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية.
وأياً كان الأمر، فإن واحدة من الفضائل العظيمة لكتاب بيلهام هو أنه ناقد غير متعصب، لكنه ينتقد التعصب السياسي المرتبط بنواح دينية. فإذا كان قد تحدث عن الفلسطينيين ودورهم الكبير في صعود “الحركات الجهادية”، فإنه قد تحدث أيضا وبإسهاب وكرس عدة فصول في كتابه عن تزايد “الشوفينية” عند رجال الدين الصهاينة في إسرائيل، وعلى سبيل المثال فإن 47 % من اليهود صوتوا مؤخرا – وفقا لإحدى الاستطلاعات – لصالح طرد المواطنين العرب من إسرائيل إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ويقول بيلهام موجها الحديث لرئيس بلدية الناصرة : “ولكن إن كنتم سوف تقومون بطرد سكان الأرض الذين هم موجودون من قبلكم ؛ فيجب أن تتأكدوا أن الذين سمحت لهم بالبقاء سوف يكونوا كالحصى في عيونكم، وكالشوك في أجنابكم، وسينكدون عليك عيشتكم” .
ويختتم الكاتب هذه النقطة بأن “اسرائيل قد أصبحت جزءا من دول الشرق الأوسط الطائفية، والتي تقمع فيها الملة الآخر”، وأن إحياء النزعات القومية والدينية قد تضافرت لتقويض تقاليد عريقة في استيعاب الاختلاف الثقافي في الشرق الأوسط.
وحول إمكانية الخروج مما نحن فيه، والعودة إلى التعددية في الشرق الأوسط، يقول بيلهام إن الحل هو العودة إلى شكل من أشكال الدولة العثمانية، حيث عالم “المجتمعات المقدسة” بدلا من “الأراضي المقدسة”، أي “إحياء التقاليد المفقودة للتعددية”.
وليس هناك شك في أن الإمبراطورية العثمانية كانت نسبيا نظام حكم متسامح، به تعددية، ولكن على أساس أن المسلمين السنة لهم مكانتهم الاجتماعية والسياسية البارزة. وبعبارة أخرى، فإن النموذج العثماني في التعددية، كان رائعا في وقتها، لكنه لا يتوافق مع العالم الحديث.
نقوش على “باب الخليل”
يفتتح “بيلهام” الفصل الأخير بلفت الانتباه إلى النقش الموجود على “باب الخليل” منذ أيام العثمانيين في البلدة القديمة في القدس: “أشهد أن لا إله إلا الله وإبراهيم هو خليل الله ( مكتوبة خليل الله )، والذي يوضح مدى إيمان المسلمين وأيضا: “أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله”. ويُفهم من ذلك، حسب المؤلف، أن الدين يمكن أن يكون مصدرا للانسجام بشرط اعتراف اليهود والمسيحيين والمسلمين بـ”القواسم المشتركة النبيلة” كما وصفها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.
ولم تكن الملل دائما أداة التعددية العثمانية، حيث يقول “بيلهام” أنه كان هناك 17 فرقة من الملل، يمثلون التنوع الدينى الهائل للإمبراطورية، فهناك السنة والشيعة والأرثوذكس والمسيحيين الكاثوليك (البروتستانت في وقت لاحق)، والكاثوليك البابويين وحاخامات اليهود، وهناك أيضا “القرائيين”، وغيرهم، لكن بالنسبة للتاريخ العثماني، كان هناك ثلاثة طوائف لغير المسلمين معترفا بها رسميا، الأرثوذكس واليهود والأرمن. وكان السنة العثمانيون ينظرون بعين الاعتبار إلى طوائف المسلمين الشيعة والعلويين باعتبارهم مسلمين، وكانوا يعترفون بهم، ولم يكن عليهم أي خلاف.
وتشكلت مؤسسات الملل في وقت متأخر نسبيا، بسبب جهود الإصلاح وتحديث الحكومة العثمانية المركزية، على الرغم من منحهم السلطة قبل تشكيل المؤسسات من خلال هذه النقطة. وكان أصحاب الملل أنفسهم يخضعون لعملية تحول، مثل اليونانيين والأرمن، على سبيل المثال، عبر زيادة القلة المحددة كأعضاء في المجتمع الديني عن الجماعات العرقية أو الوطنية.
وفي تركيا وإيران الحديثة، فإن الملة لا تعني “الدين”، ولكن “الأمة”، ذلك أن معنى التغيير في المصطلح يعكس بدقة الواقع المتغير الذي يصفه.
وثمة نقطة أخيرة أدركها “بيلهام” في كتابه جيدا، وهي التداخل العميق بين الدين والعرق، فبالنسبة لليهود واليونانيين والأرمن ترتبط الهوية الدينية والهوية العرقية ارتباطا وثيقا. وينطبق الشيء نفسه بطريقة مختلفة قليلا عند العرب. صحيح أن القومية العربية، وخاصة في العقود الوسطى من القرن العشرين، باتت قضية ناصرها المسيحيون العرب، الذين رأوا أنها الطريق إلى منحهم حق التصويت السياسي في عالم يهيمن عليه المسلمون ديموغرافيا، ولكن من الصحيح أيضا أن النشأة الفكرية للقومية العربية كانت وثيقة الصلة بالجهود المبكرة في بدايات القرن العشرين لإصلاح و”إحياء الإسلام”.
ويضرب المؤلف المثل على ذلك بالكاتب القومي ميشيل عفلق مؤسس حزب “البعث”، والذي ولد مسيحيا، ولكن العروبة التي كان أحد أبطالها كانت قائمة على الفهم اليهودي والمسيحي للدور التاريخي للإسلام.
أما القومية التركية التي طرحت من قبل “أتاتورك” فكانت قومية علمانية قمعت العديد من التنظيمات ذات المفهوم الإسلامي في الدولة التركية الحديثة. ومع ذلك، فالقومية التركية التي شيدت من قبل “أتاتورك” وخلفاؤه بنت علاقة وثيقة بين العرق التركي والإسلام السني، وتجاهلت في نفس الوقت لسنوات طوال الهوية العرقية للعلويين الشيعة، وكانت أحيانا تستخدم القمع معهم رغم أنهم كانوا نسبة كبيرة من فلاحي “الأناضول”.
ويتحدث “بيلهام” أيضاً عما أسماه “الاختلاف الهائل” الناشئ بين السنة الشيعة، رغم أنهم كانوا جنبا إلى جنب يعيشون بشكل متساو تماما فيما سبق، ولكن ما لاشك فيه أن الثورة الإسلامية في إيران، جنبا إلى جنب مع تمكين الأغلبية الشيعية في العراق نتيجة للغزو الأمريكي للعراق، دفعت الشيعة لتحدي “الكسوف السياسي” الطويل لهم على يد الأغلبية السنية.
وتجاه ذلك خطت المملكة العربية السعودية، المصدرة للفكر الوهابي غير المتسامح مع الشيعة، خطوات ملموسة للتصدي لهذا التغلغل الشيعي، فكان التدخل السعودي في البحرين للوقوف بجانب النظام الملكي السني الذي كان يترنح، وحطمت بذلك مجتمعا كان من أكثر المجتمعات تسامحا في المنطقة.
ومؤخراً، كان التدخل بقيادة السعودية في “الحرب الأهلية” الدائرة في اليمن، وهي نزاع محلي في المقام الأول تحول إلى “حرب بالوكالة” مع إيران، التي يرى السعوديون أنها وراء حركة “الحوثيين”، على الرغم من أن التشيع الزيدي يختلف تماما عن التشيع الجعفري الموجود في المذهب الشيعي لآيات الله في إيران.
منذ أربعين عاما، كان “الإسلام الوهابي” قوة ضئيلة في العالم الإسلامي، ولكن السعوديين- كما يقول المؤلف- استخدموا مواردهم المالية الهائلة لقيادة الحركات السلفية للمحافظة على تفسيرات الإسلام في جميع أنحاء العالم. وكان لجهودهم تأثير في تقييد نطاق الفكر والممارسة المعترف بها شرعيا لمسلمي بلدان بعيدة مثل باكستان، حيث كان كل من الشيعة والصوفية أهدافا لهجمات مسلحة، وفي إندونيسيا، قوضت الجماعات السلفية التسامح من التقاليد الإسلامية المحلية.
نهاية القصة
ينهى المؤلف القصة من حيث بدأ، مع الأتراك، والإسلام، والتاريخ الطويل من التعددية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان يحرك تركيا بعيدا عن تقاليد الجمهورية العلمانية بسرعة كبيرة، ويقوم بذلك في لحظة تغير للإسلام السني. وعندما يشعر أردوغان أن مفاهيم التسامح تحت التهديد، يراوغ بين عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي ومغازلة السنة، ويبذل جهود معقدة في التحدي واحتواء “داعش” في نفس الوقت، مدفوعا بطموحه الغامض لإحياء الهيمنة التركية العثمانية على الشرق الأوسط.
ويختم المؤلف كتابه بسؤال: هل يصلح الدين أن يكون أساسا للتعددية الفعلية في الشرق الأوسط الحديث، مرة أخرى، كما فعلها في السابق؟ إن هذا هو السؤال الذي طرحه هذا الكتاب المهم، وأي إجابة يجب أن تعترف بأن الدين، هو مكون أساسي في تعريف الذات وتجربتها، وهو مكون غير مستقر، فالأديان تتغير وتعبر عن نفسها في وقت واحد بطرق مختلفة، و”داعش” لا يمثل الإسلام بأي حال، مثلما أن منظمة “كو كلوكس كلان” الأمريكية لا تعبر عن المسيحية، بل إن الأول (داعش) ردة إلى الإسلام في العصور الوسطى أكثر منه منتج متحول في العالم الحديث، إنها بالضبط “مأساة الحداثة” في الشرق الأوسط.
الأراضي المقدسة.. إحياء التعددية في الشرق الأوسط
للمزيد من الكتب، زوروا منصة الكتب العالمية
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)

 العربية
العربية  English
English