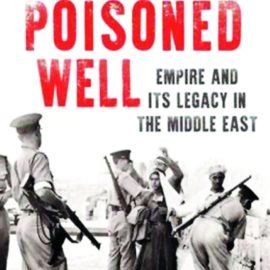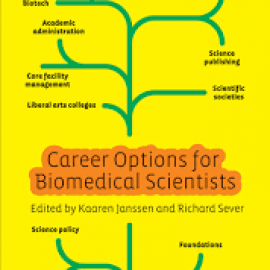الوصف
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
الأمل والذاكرة: خلاصة القرن العشرين
تمت ترجمة هذا الكتاب بواسطة دار نشر العبيكان
كتاب “الأمل والذاكرة – خلاصة القرن العشرين” يلخص القرن العشرين وما جناه البشر فيه، فكان هذا الكتاب كالمرآة التى تعكس أسوأ ما فى هذا القرن وأفضل ما فيه، ورغم أن التقويم يشير إلى ذهاب القرن العشرين بلا رجعة إلا أن أحداثه لا تزال تطرق باب الذاكرة، فقد كان القرن العشرين عصر المواجهات الكبرى والمعارك الجبارة؛ فكان هناك الصراع بين الديمقراطية والشمولية الذى لم يقتصر على ساحات القتال والمجالات الاقتصادية فحسب، بل تعداه إلى مستوى المبادئ السياسية والأخلاقية التى تطال وجود كل نظام.
في هذا الكتاب (الأمل والذاكرة، خلاصة القرن العشرين) يكتب “تزفيتان تودروروف” عن القرن العشرين بجرأة كبيرة. إنه مرآة عكست أسوأ ما في هذا القرن وأفضل ما فيه.
يسأل تودوروف في مقدمة كتابه: «ترى ما هو الانطباع الذي سنحمله عن هذا القرن؟ وهل سنطلق عليه «قرن ستالين وهتلر»؟ أم ترى هل سنسميه بأسماء أشهر أدباء ومفكري العصر الذين سحرونا بكتاباتهم لدرجة أثارت فينا، نحن قراءهم، الحماس والجدل؟».
قرن المظالم
إنه قرن مظلم، كما يقول تودوروف، ويستشهد بفاسيلي غروسمان: «إن العالم بأسره والكون برحابته، ينم عن الاستسلام السلبي للمادة الجامدة، فالحياة وحدها هي معجزة الحرية».
(أنظمتنا الديمقراطية الحرة) هو عنوان البحث الأول من الكتاب، ويبدأ القص هنا من إحصاء ضحايا الحرب العالمية الأولى: ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جثة على الحدود، ما يقارب عشرة ملايين مدني، وستة ملايين معاق. ثم تكون حصيلة ضحايا الحرب العالمية الثانية أكثر من خمسة وثلاثين مليوناً لقوا حتفهم في أوروبا وحدها، منهم خمسة وعشرون مليوناً على الأقل في الاتحاد السوفييتي. هذا بالإضافة إلى تعرض المدنيين في ألمانيا واليابان لقصف بالقنابل من قبل الحلفاء، والحروب الدموية التي قادتها الدول الأوروبية داخل مستعمراتها.
يا لهذا القرن! قرن المجازر والقتل والإبادات!
لقد أطلق المؤرخون على القرن الثامن عشر قرن «الأنوار»، فهل يا ترى سينتهي بنا الأمر إلى تسمية قرننا بـ «قرن الظلمات؟».
أثناء حديثه عن الديمقراطية يعود تودوروف إلى عصر الأنوار، ويجلب تصريحاً من روسو من مؤلفه «العقد الاجتماعي»، ويقول: «لا تتخذ أية حكومة الصفة الشرعية إلا إذا كان حكمها مبنياً على أساس النظام الجمهوري. إنني أعني بالحكومة تلك التي تقودها إرادة الشعب والتي تمثل القانون نفسه».
بعد الثورة الفرنسية واجتثاث الحكم الملكي، لم تكن النتيجة مشرقة كما كان متوقعاً، إذ إن الرعب لا يزال مسيطراً في أوروبا والحرية غائبة. وتساءل كبار المفكرين: أين كان خطؤنا؟
إنسان جديد
يتطرق تودوروف إلى مذهب العلمية والفلسفة الإنسانية، ويرى أن العلم فاعلية المعرفة، ومنه تتولد التقنية التي هي فاعلية تغيير العالم. يتساءل تودوروف: «إذا كانت شفافية العالم الواقعي تمتد إلى عالم الإنسان، فما الذي يمنع إذاً من التفكير بخلق إنسان جديد، جنس خال من عيوب الجنس الأولي؟
إن تغيير النوع يتطلب كشف العيوب، لكن من هو المؤهل للتعرف على العيوب وتحليل كنهها من جهة، وعلى طبيعة الكمال الذي نتطلع إليه من جهة أخرى؟ يجيب ماركس: «لم يقدم لنا الفلاسفة حتى الآن، إلا تفسيرات مختلفة عن العالم. وقد حان الوقت ليبدأوا بالتغيير».
أين يقع مذهب العلمية بالنسبة إلى التاريخ؟ يعود تودوروف إلى ديكارت الذي أعلن أن المعرفة يمكن أن تكون كاملة شريطة الاعتماد على العقل وعلى الإرادة دون غيرهما.
سيد الطبيعة
وبالتالي «لا مانع من أن يعتبر الإنسان نفسه سيداً للطبيعة وسيداً لذاته». وانطلاقاً من هذه المعرفة – كما يقول تودوروف – بإمكان مهندس واحد أن يعيد تنظيم الدول والمواطنين وأخيراً توجيه دفة التغيير وفقاً لنشاط المعرفة.
لم يدخل مذهب العلمية إلى السياسة إلا بعد قيام الثورة الفرنسية، حيث يفترض من الدولة الجديدة أن تقوم على قرارات عقلانية وليس وفق تقاليد اعتباطية. وسيزدهر هذا المبدأ في القرن التاسع عشر عند كافة المفكرين، سواء أكانوا أصدقاء للثورة أم مناهضين لها، كون نفوذ العلم الذي يأملون باعتماده كبديل أوسع من نفوذ اليوتوبيا المنهارة.
إذاً، ينتمي مذهب العلمية إلى العصر الحديث بلا منازع، وهو يسعى إلى أن تستمد المجتمعات قوانينها من البشر أنفسهم، كما يستدعي هذا المذهب وجود علم قائم بحد ذاته مكتسب من العقل البشري حصراً بدلاً من أن يكون موروثاً بشكل آلي جيلاً بعد جيل. ولكن مع ذلك، لا يشكل النهاية الحتمية والحقيقة الخفية للمدنية الحديثة، كما يصر عليه أصحاب العقول النيرة.
يوجه روسو للعلماء وأصحاب الفكر النير من معاصريه نقداً صريحاً ويقول: «إن المعرفة لا تولد الأخلاق، والأفراد المثقفون ليسوا بالضرورة أناساً صالحين». ويقول أيضاً: «يمكن أن نكون رجالاً ولكننا لسنا بالضرورة علماء».
عنون تودوروف الفصل الثالث بـ «الحفاظ على الماضي»، وفيه يتساءل: هل يحق لنا تقييم الماضي؟ ويجيب بأنه تكفينا مراقبة كتابات المؤرخين لنلحظ أنهم لم يمتنعوا عن ذلك إلا في حالات استثنائية. ولكن هل فعلاً يملكون الحق في التصرف على هذا النحو؟
نقف هنا متسائلين عن حقيقة كتابة التاريخ وعن شرعية الأحكام التي يطلقها المؤرخون. ويمكننا أن نقف أيضاً موقفاً متشككاً من تدوين تفاصيل التاريخ، حين نحدد المكان الذي يقف فيه المؤرخ وموقفه مما يجري من أحداث.
ينحرف تودوروف نحو دراسة المنهج الأخلاقي السليم للبشر، ويعرج على تعريف المصلح الأخلاقي، يقول: «إن المصلح الأخلاقي هو ذلك الإنسان الذي يجني الفخر من جراء تعريفه لمظاهر الخير والشر، وكونك مصلحاً أخلاقياً لا يعني البتة أنك تتمتع بالأخلاق الحميدة. فالفرد الذي يتمتع بالخلق يقوم بإخضاع حياته الخاصة إلى معايير الخير والشر، بغض النظر عن إشباع رغباته وملذاته. أما المصلح الأخلاقي فهو يسعى لإخضاع حياة من يحيطون به لتلك المعايير، ويستفيد من ذلك بأن يجد نفسه في الجانب السليم من الحاجز الذي يفصل بين الخير والشر».
مخاطر الديمقراطية
جاء الفصل السادس بعنوان (مخاطر الديمقراطية) وافتتحه تودوروف ببحث «القنابل على مدينتي هيروشيما وناغازاكي». وفيه يستعرض الفظائع التي حدثت في الحرب العالمية الثانية بشكل عام وباليابان بشكل خاص جراء إلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية عليها.
يقول تودوروف: «حسب الإحصاءات الأولية التي صدرت غداة الحرب، تسبب إلقاء القنابل الذرية بخسائر في أرواح الشعب الياباني بلغت تقريباً 140 ألفاً في هيروشيما في السادس من شهر آب 1945 و70 ألفاً في ناغازاكي في التاسع من الشهر نفسه من العام نفسه، وتم تعديل هذه الأرقام بعد عدة سنوات فكانت على التوالي 180 ألفاً و140 ألفاً».
والشيء المخيف هو التبرير الأمريكي لقتل اليابانيين، حيث تم الترويج بأن القنبلة الذرية أنقذت مليون جندي كانوا مجهزين للهجوم على اليابان. أي أن هؤلاء المليون تم افتراضهم في عداد الموتى في حال الهجوم المفترض.
وهكذا فالقنبلة قد أنقذت حياتهم. وبناء على المعطيات والدراسات والبحوث اللاحقة، وبناء على نسبة المدنيين الموجودة في المدينتين، توضح أن الهدف الأمريكي قتل أكبر عدد من الضحايا المدنيين وإنزال أعظم أثر نفسي ممكن بمن بقي حياً.
عن المؤلف:
تزفيتان تودوروف فيلسوف فرنسي-بلغاري وُلِد في 1 مارس 1939 في مدينة صوفيا البلغارية. يعيش في فرنسا منذ 1963، ويكتب عن النظرية الأدبية، تاريخ الفكر، ونظرية الثقافة. توفي يوم 7 فبراير 2017 عن عمر 77 سنة.
نشر تودوروف 21 كتابا، بما في ذلك ” شعرية النثر (1971)”، “مقدمة الشاعرية (1981)”، و “غزو أمريكا (1982)”، ميخائيل باختين : مبدأ الحوارية (1984)”، “مواجهة المتطرف: الحياة الأخلاقية في معسكرات الاعتقال (1991)”، “حول التنوع الإنسان (1993)”، “الأمل والذاكرة (2000)”، “والحديقة المنقوصة : تركة الانسانيه (2002)”. وكتاب “مدخل الى الادب العجائبي”، وكتاب “الأدب في خطر”.
وقد ركزت اهتمامات تودوروف التاريخية حول قضايا حاسمة مثل غزو الأمريكتين ومعسكرات الاعتقال النازية والستالينية.
وقد عمل تودوروف أستاذا زائرا في عدة جامعات، منها جامعة هارفارد، وييل وكولومبيا وجامعة كاليفورنيا، بيركلي.
تم تكريم تودوروف بأكثر من جائزة، من بينها: الميدالية البرونزية لويزار، وLévêque تشارلز وجائزة موراليس وجائزة الأكاديمية الفرنسية وجائزة أمير أستورياس للعلوم الاجتماعية، وهو أيضا حاصل على وسام ضابط من قصر الفنون والأدب.
تودوروف يعيش في باريس مع زوجته نانسي هيوستن وطفليهما. انفصلا في “2014”.
ويعتبر أعظم إسهام لتودوروف هو إنشاء نظرية أدبية جديدة، عرضها في أكثر من كتاب، وبالتحديد في كتابه “مدخل إلى الأدب العجائبي”.
للمزيد من الكتب اضغط هنا
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)

 العربية
العربية  English
English