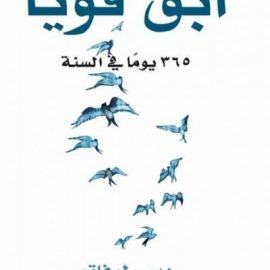الوصف
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)
مثل الكتاب رحلة فكرية – سياسية سجلت وقائعها صحافية أميركية تستند إلى خبرة طويلة في الشأن الروسي، إذ عاشت هذه الرحلة وخبرت تلك التفاصيل عن كثب، على الأرض الروسية ذاتها على مدار سنوات عدة. ويتميز الكتاب بأن المؤلفة عمدت إلى الابتعاد عن العاصمة موسكو.
واختارت بدلاً من ذلك أن ترسم للقارئ صورة الدواخل الروسية التي لا تزال تعيش مرحلة ما بعد الحقبة السوفييتية بكل مواريثها الصعبة والمعقدة، ثم حقبة يلتسين في التسعينيات من القرن الفائت بكل تهافتها.. فوصولاً إلى حقبة بوتين الراهنة التي تتابع محاولات شق طريق التوازن بين مواريث الماضي ومتطلبات الحاضر.
والمعنى الذي انطلقت منه مؤلفة الكتاب أن روسيا ليست العاصمة موسكو، بل إن روسيا هي التي تعبر عن واقعها وتكاد تفصح عن مكنون ضميرها على صعيد المناطق والأصقاع التي ما برحت ممتدة عبر الرقعة الشاسعة والمتنوعة التي تشغلها روسيا على خارطة العالم الذي نعيش فيه، حتى لتعد روسيا صاحبة أكبر- أوسع رقعة من مساحة الأرض في العالم (أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع)، وتليها في ضخامة المساحة، كندا فالصين ثم الولايات المتحدة الأميركية.
انطلاقاً من هنا، وبحنكة المهنة الصحافية، عمدت مؤلفة كتابنا إلى معايشة الواقع الروسي الراهن، لا على أرض العاصمة موسكو أو سائر الحواضر الروسية الكبرى، وإنما ركزت في كتابها على «شليابنسك»:
المنطقة التي تضم في الأساس واحداً من أهم المراكز الصناعية – العسكرية وتبعد عن موسكو بنحو ألف ميل. وأما سبب هذا الاختيار فيتمثل في أن المنطقة المذكورة ظلت على مدار سنوات طوال، محوراً بالغ الأهمية للبرنامج النووي الروسي وذلك منذ أيام الاتحاد السوفييتي، بطبيعة الحال.
وتصف المؤلفة الصحافية الأميركية هذا الموقع بأنه يضم بحيرات رائعة وحواضر تلّفها غوامض الأسرار، فيما يشتمل أيضاً على مصانع باتت مهجورة، ناهيك عن أماكن تعد، كما تضيف المؤلفة، من أسوأ مواقع التلوث على وجه الأرض.
مع هذا كله فقد كانت هذه المنطقة التي تحفّها من الشرق جبال الأورال الروسية، شبه مغلقة أمام الزائرين، بسبب حساسية الأنشطة العسكرية – النووية التي تضمها. ولعل هذه الحقيقة هي التي اجتذبت المؤلفة إلى زيارتها أكثر من مرة، بعد أن سمحت السلطات بالزيارة خلال عقد التسعينيات في القرن الفائت. وفي سياق هذه الزيارات عمدت إلى الالتقاء بالعديد من الروس من ساكنيها..
وكانوا ينتمون إلى مختلف المهن والاتجاهات ومستويات التعليم، وهو ما لا يزال يرسم صورة أقرب إلى الواقع المُعاش بالنسبة إلى «الحالة الروسية»، كما يفيد بالتالي في سلامة التعامل مع روسيا- الدولة والرئاسة والتوجهات، بعيداً عما يمكن أن ترسمه وسائل الإعلام الدولي أو القطري، ذاك بكل ما يحتمل أن يشوب ممارساتها من تحيّزات أو تصورات.
ومن هنا تفيد ملاحظات المؤلفة في تنبيه جمهور كتابها إلى أن روسيا تمتلك تاريخاً أكثر تعقيداً وتميزاً من سائر الدول الأوروبية: حكمتها صولجانات القياصرة ولم تشارك مع دول أوروبا في تطورات عصر النهضة (الرينسانس).. ولا في قطف ثمار عهود التنوير، بل تعرضت للغزو العسكري والاجتياح الدموي، مرة من جانب بونابرت (عام 1812)، ومرة أخرى من جانب هتلر (عام 1941)، إلى أن خضعت لحكم الديكتاتورية الأيديولوﭽﻲ، خلال الحقبة السوفييتية التي امتدت عبر الفترة من 1917 وإلى 1992.
ولم يُقَّدر لهذه المعاناة في روسيا أن تنتهي، حتى مع سقوط وزوال الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينيات القرن الـ20، بل قُيض لها أن تتواصل ما بين عهد يلتسين في العقد المذكور وحتى مفتتح حقبة بوتين الراهنة، وهو ما أدى إلى شيوع الاتجاه إلى التشكك في النوايا وفي القيادات وفي جدوى التغيير على مدار المراحل القريبة وربما الحالية من الزمن على نحو ما تشير إليه مؤلفة الكتاب.
وها هي استطلاعات الرأي العام في روسيا الراهنة تأتي لتعكس مدى تشكك الجماهير، من الناخبين أو مشاهدي التلفزيون، الذين كان من بينهم ضابط متقاعد أوضح أنه بادر إلى تحويل الجهاز إلى قناة أخرى، في موعد مناظرة خاصة بالانتخابات الرئاسية.. وعندما سئل عن السبب أجاب قائلاً: لأنهم جميعاً يكذبون (!) ثم، ها هي الموظفة المتقاعدة التي بلغت خريف العمر وقد أفادت من جانبها بأن كثيراً من المرشحين ما هم إلا «باعة.. كلام»، لا أكثر ولا أقل.
This post is also available in:
![]() English (الإنجليزية)
English (الإنجليزية)

 العربية
العربية  English
English