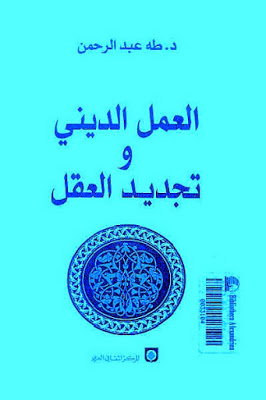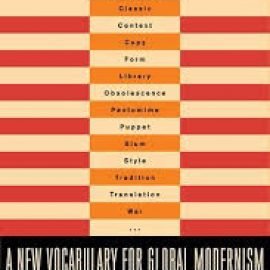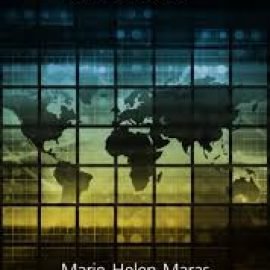الوصف
العمل الديني وتجديد العقل
شهد العالم الإسلامي خلال عقديّ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، نوعاً من “اليقظة الدينية” التي انتشرت انتشارًا واسعًا، وكان لها تأثير كبير، بالتزامن مع متغيرات سياسية واجتماعية وفكرية طرأت على العالم برمته، غير أنها “يقظة” أثارت مواقف متفاوتة، ومتباينة عند أنصارها وخصومها، معاً.
هذه المواقف المتباينة كادت أن تنتهي بـ”فتنة كبرى” جديدة، ذلك أنها لم تكن مستندة إلى إطار فكري محرّر على شروط المناهج العقلية والمعايير العلمية المستجدة. ومن هنا ظهر الغلو في الإختلاف المذهبي، إلى جانب الخلو من السند الفكري، ليشكلا سوياً مقدمة قادتها إلى نتائج وخيمة، أشدّها تراجع هذه اليقظة في وقت أسرع مما استغرق ظهورها.
وإزاء هذا الوضع المأزوم والملتبس، لم يكن من سبيل غير البحث الجاد في كيفية علاج هذا الخلل، وخلق يقظة متكاملة، وليست متنافرة، متجددة، لا متحجرة. وعندها يمكن تفادي النتائج الكارثية التي قد تنجم عن هذا الخلل الجسيم الذي شاب يقظة، لم يكن العيب في وجودها وإنما في نقائصها.
ويأتي كتاب “العمل الديني وتجديد العقل” للفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، ليقدم مساهمة في بيان الشروط التكاملية والتجديدية الواجبة لعلاج خلل اليقظة الدينية، أو كما يسميه المؤلف “تيّقظ اليقظة الدينية”، من أجل إمعان النظر في صنفين أساسيين من هذه الشروط، يدخل أحدهما تحت مسمى “التجربة” والآخر تحت “التعقل”.
أما شروط التجربة فهي أنه لا سبيل إلى إحداث التكامل في اليقظة الإسلامية إلا عن طريق النفاذ إلى أعماق التجربة الإيمانية، فيما تعني شروط “التعقل” أنه لا سبيل إلى حدوث التجدد في اليقظة الإسلامية بغير اتخاذ طريق التوسل، في تأطير وتنظيم وتأسيس هذه التجربة الإيمانية العميقة بأحدث وأقوى المناهج العقلية وأقدرها على مدنا بأسباب الإنتاج الفكري.
حدود العقل المجرّد
قسم طه عبد الرحمن كتابه إلى ثلاثة أبواب، كل باب منها يتفرع إلى ثلاثة فصول. ويختص الباب الأول بالنظر في “العقل المجرّد” وحدوده، فيما يتناول الفصل الأول من هذه الباب المقدمتين اللتين يستند إليهما ذلك العقل المجرد، وهما أنه فعل من الأفعال وليس ذاتًا من الذوات، وأن هذا الفعل تحده حدود، منها الخاص ومنها العام.
هذا التصور للعقل كما قدمه المؤلف يقع في نزعة تجزيئية وتشييئية لأنه يقسم تجربة العاقل الإنساني المتكاملة إلى أقسام مستقلة ومتباينة، ذلك أن تخصيص العقل بصفة الذات يجعله منفصلاً عن أوصاف أخرى للعاقل لا تقل تحديدًا لماهية الإنسان، كالعمل والتجربة مثلاً، إن لم تكن أدق تحديدًا لهذه الماهية.
وهي كذلك نزعة تشييئية – وفق وجهة نظر المؤلف- لأنها تجمد الممارسة العقلانية، بأن تتنزل عليها بعضا من أوصاف الذوات، مثل التحيز، والتشخص، والاستقلال، والتحدد بالهوية، واكتساب الصفات، والأفعال.
وإذا كان المبحث الإلهي هو أخص المباحث النظرية الإسلامية، وأدلها على طبيعة الممارسة العقلية المجرّدة عند المسلمين، فلقد جرت العادة لدى الباحثين باستخراج أصول هذا العلم ومناهجه ومسائله من أبحاث فلاسفة الإسلام ومقالات المتكلمين، أو باختصار كلام المؤلف: “عبر الرجوع إلى النصين الفكريين، النص الفلسفي، والنص الكلامي في تحديد معالم هذا البحث”.. ويعود وينبه إلى أنه في الاكتفاء بهذين النصين العقليين حصرًا، قصورًا عن الإحاطة بتمام الإشكالية الإلهية كما عرفتها الممارسة الإسلامية، ذلك لأنهما لم ينفردا عن باقي النصوص الإسلامية بتناول تلك الإشكالية، داعيا إلى توسيع دائرة النصوص المعتمدة في إقامة “الإلهيات الإسلامية” بحيث تشمل أبحاثًا أخرى غير الفلسفة وعلم الكلام. ومن بين الأبحاث التي يرى ضرورة إدراجها ضمن هذه النصوص كتب التفسير، مدللاً على ضرورة هذا الإدراج بأن من بين المفسرين من كان متمرسًا بأساليب النظر في الإلهيات، من أمثال فخر الدين الرازي والزمخشري، وسواهما.
الاقتراب من المعرفة الإلهية
وفي الفصل الثاني من الكتاب، يرسم المؤلف الحدود الخاصة للعقل المجرّد من خلال الممارسة النظرية الإسلامية، ويؤكد أن فرار الناظر الإلهي من التشبيه يوقعه في نقيضه، وهو التعطيل الذي لا يقل سوءًا عن سابقه، ولا يخلصانه من حيرة النظر وقصور اللغة عن الاقتراب من المعرفة الإلهية، وعن تحقيق التنزيه اللائق بذات الله سبحانه وتعالى.
مبينا أن الدعاء بـ”الأسماء الحسنى” في نظر أهل العقل المجرّد من المفسرين هو تسمية الذات الإلهية وتسمية أفعالها باعتبار الذات والصفات والأفعال في أعلى مراتب العلو والشرف، وهذا الاعتبار وحده كاف كدليل على أن هذا الدعاء ليس غرضه مجرد التسمية لذاتها، وإنما الغرض المتوخي منه هو استفادة التقرب من المدعو الأسمى، وهو الله تعالى. ويذهب عبد الرحمن إلى إن التقرب بالتسمية وفق مقتضى ركني العقلانية والإحسان، هو طلب معرفة للأسماء الحسنى بطريق العقل المجرّد، إنه طلب ينال حظًا من إحسان هذه الأسماء يرفعه إلى مقام الفعل الحسن ومن إرادة الحسنى.
ويخلص المؤلف في هذا الفصل إلى أن حدود العقل المجرّد الخاصة التي تقدم بيانها بصدد مسألة الألوهية عند النظار، وبصدد آية الأسماء الحسنى عند المفسرين، هو أن هذه الحدود تقوم في عدد من الأوصاف.
أولها الوصف الرمزي: لمّا كان أهل العقل المجرّد من المتكلمين والمفسرين هدفهم الأول هو العلم بالوجود بعينه، وليس مجرد العلم بتصور هذا الوجود، فإن توسلهم باللغة التي هي مجموعة من الرموز تسد مسدها أي مجموعة أخرى. وسواء ورد هذا التوسل على صورة تسميات أو في صورة عبارات، ما كان ليمدهم بأكثر من تصورات عن هذا الوجود. وتبقى تلك التصورات عند أصحابها حبيسة الأذهان، فلا تُدخلهم أبدًا إلى عالم التحقق والبيان، كما أن استعمال الرموز اللغوية أبعد عن الإيفاء بالحاجة من المعرفة الإلهية من بعده عن الوفاء بالحاجة من معرفة غيرها.
وثانياً، الوصف الظني: ينشئ أهل العقل المجرد من النُظار وأهل التفسير الأدلة اللازمة لبلوغ مرادهم في البرهنة على الوجود الإلهي، لكن أدلتهم هذه تقع فيما يُخرج صورتها عن صورة البرهان، فالتصورات التي تقوم عليها غير محددة المعالم، وطريقة تحصيلها غير مضبوطة، كما أن صفتها الإجرائية غير معلومة.. مفترضا أن أدلة هؤلاء النُظار خلت من هذه التصورات المضطربة، وأنها سلكت طريقًا سليمًا في التركيب والترتيب، في حتى في هذه الحالة ما كان ذلك ليجعلها كافية ولا ضرورية لإفادة اليقين بالوجود الإلهي.
وثالثا، الوصف التشبيهي: إن المتكلمين والمفسرين وإن بدوا بنزعتهم العقلانية التجريدية أكثر استعدادًا لطلب الحقائق الموصوفة بالتنزيه من غيرهم فإنهم أحبوا أم كرهوا واقعون في التشبيه بصنفيه، أي التشبيه الاضطراري الذي لا تنفعهم معه حيلة لميل العقل النظري إلى القياس على المعلوم من الأشياء، فضلا عن التشبيه الاختياري الذي يسوقهم إلى الخوض المتكلف والشنيع في حقائق لطيفة تستلزم من الأدب والتعظيم ما لا يطيقه العقل المجرد.
وهكذا، يصل المؤلف إلى نتيجة مؤدّاها أن الطريق إلى إدراك الحقائق الإلهية بواسطة العقل المجرّد ذي الأوصاف الثلاثة، الوصف الرمزي، والوصف الظني، والوصف التشبيهي، طريق مسدود، أو على الأقل هو طريق محدود.
وإلى ذلك، ينتقل المؤلف في الفصل الثالث لمناقشة فكرة الحدود العامة للعقل المجرّد، موضحا أنها تتمثل في أصناف ثلاثة من الحدود، هي: الحدود المنطقية المُستدل عليها بالبراهين الرياضية الصحيحة، مثل استحالة البرهان على قضية صادقة (عدم التمام) وامتناع الحصول على طريقة آلية للبرهان (عدم البت).. ومن ثم، تأتي الحدود الواقعية المستمدة من الممارسة العلمية، كنسبية الأنساق المنطقية، واسترقاق الآلة للإنسان، فضلا عن الفوضى في النماذج والنظريات العلمية. ثم تجئ الحدود الفلسفية المستنبطة من أصول ومبادئ العقل المجرّد، مثل الصفة المادية بمظاهرها الثلاث: التظهير، والتحييز، والتوسيط، ومثل التداخل مع اللاعقلانية والاتصاف بعدم الضرورة.
آفات العقل المسدّد
الباب الثاني من الكتاب، خصصه المؤلف للنظر فيما سماه “العقل المسدّد” وآفاته، فعالج في الفصل الأول من هذا الباب المقدمتين اللتين يستند إليهما هذا العقل، وهما أنه يأخذ بالعمل الشرعي، وأنه معرض لآفات خلقية وعلمية.
ويقوم “العقل المسدد”، حسب الكاتب، على أركان ثلاثة أساسية هي: ركن الموافقة للشرع التي من شأنها أن تجنبه مساوئ التوجيه، وركن اجتلاب المنفعة الذي يُبني على القيم المعنية ويتطلب بعد النظر ونزاهة النفس، وركن الاشتغال الذي يفيد في تجسيد العمل ورفع قيمة العلم المقترن به وتوسيع المدارك، وفي تصحيح السلوك أصلاً ومقصدًا ووسيلة.
أما الآفات التي تظهر من خلال الممارسة الفقهية، فقد حددها المؤلف في آفتين، هما: آفة التظاهر: وهو عبارة عن وصف يقوم به كل متقرب بالطاعات، أو كل قرباني يقع منه التفاوت في الأعمال بين واقع الاشتغال وبين المقاصد المتوخاة من هذه الأعمال.
ويميّز عبد الرحمن في سلوك التظاهر هذا أصنافًا ثلاثة هي التكلف: وتقوم هذه الآفة على الاتيان بأعمال لا تطابق واقع الاشتغال، مع إخراجها عن قصد التقرب بها إلى الله إلى قصد التقرب بها إلى الناس، أو على الأقل مع إشراك الناس مع الله، سبحانه وتعالى، في قصد التقرب بهذه الأعمال.
والصنف الثاني، هو التزلف: وتقوم هذه الآفة على الإتيان بأعمال تطابق واقع الاشتغال، مع إخراجها عن قصد التقرب بها لله إلى مراءاة الناس، أو على الأقل مع إشراك الناس بالله في قصد التقرب.
وثالث هذ الأصناف هو التصرف: وتقوم هذه الآفة في الإتيان بأعمال تطابق واقع الاشتغال مع إخراجها عن قصد التقرب بها لله، إلى قصد التوجه بها إلى النفس أو مع إشراك النفس بالله في قصد التوجه.
أما الآفة الثانية فهي التقليد، وهو إجمالاً – عبارة- عن الوصف الذي يقوم بكل متقرب بالطاعات أو بكل قرباني يقع منه العمل بقول الغير على سبيل الاتفاق، أو على سبيل العادة بالاستناد إلى دليل نظري.
ومن ذلك “التقليد الاتفاقي”، وهو العمل بقول الغير من غير تحصيل دليل نظري يثبت صحة هذا القول، بالإضافة إلى “التقليد النظري”، وهو العمل بقول الغير مع تحصيل دليل نظري لا عملي يصحح هذا القول، ثم “التقليد العادي” وهو العمل بقول الغير مع حصر الدلالة العلمية لهذا القول على الحركات الظاهرة، سواء استند هذا العمل إلى دليل يصحح القول المعمول به، أو لم يستند إلى أي دليل.
ويصل الفيلسوف إلى الفصل الثالث والأخير من الباب الثاني للكتاب، والذي خصصه للبحث في الآفات العلمية التي تظهر من خلال الممارسة السلفية، إذ يبدأ بتحديد طبيعة الممارسات التي أخذت بها “الحركة السلفية” المعاصرة في مشروعها الإصلاحي، وأولها الممارسة القربانية، أي تخليص الدين مما لحقه من بدع بدلته عن أصله، وذلك بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وهي العودة التي تشترط طريق التقرب إلى الله بواسطة العقل المسدد.
أما الممارسة السياسية، فهي تهدف إلى تخليص المجتمع من آثار التخلف وعوامل التبعية للقوى الاستعمارية وذلك بتحقيق التعبئة الشاملة لمختلف الطاقات وإدخال الإصلاحات الضرورية على كافة المستويات المجتمعية والممارسة النظرية، التي هدفت إلى تخليص العقل مما علق به من الخرافات والأباطيل، وما دخل عليه من الجمود الفكري، وذلك باستعمال كل أساليب “التنوير” الممكنة من تجديد طرق التعليم وتكثيف أساليب التوعية والتثقيف، وخلافه.
وهذه الممارسات السلفية وقعت، كما يقول عبد الرحمن، في عدة آفات، أولها آفة التجريد. و”التجريد” مصطلحاً هو انفراد الفعل العقلي النظري بالقدرة على التأمل في النصوص، على اعتبار أن قيمة هذه النصوص تنحصر في التصورات والأفكار التي تُنال بهذا التأمل.
وآفة “التسييس”، وهو انفراد الجانب السياسي بالقدرة على الإصلاح والتغيير، على اعتبار أن قيمة الفرد تنحصر في الفوائد والآثار السياسية التي يتركها أو يتلقاها في نطاق اجتماعي تتشابك فيه الاختيارات المذهبية، والمصالح السلطوية والنزاع على مراكز القوة.
التجربة الباطنية
ونأتي إلى الباب الثالث والأخير من الكتاب، والذي خصصه المؤلف للعقل المؤيّد، وكمالاته، فيتناول الفصل الأول، المقدمتين اللتين يستند إليهما هذا العقل، وهما أنه يقوم على التجربة الحيّة، وأنه يطلب كمالات تحقيقية، وتخليقية، تجلت في الممارسة الصوفية.
وعن طبيعة هذا العقول يقول عبد الرحمن إن “العقل المؤيّد عبارة عن الفعل الذي يطلب به صاحبه معرفة أعيان الأشياء بطريق النزول في مراتب الاشتغال الشرعي، مؤديًا النوافل زيادة على إقامة الفرائض على الوجه الأكمل”، معتبراً أن هذا العقل المؤيد “لا تظهر كمالاته في الممارسة العقلانية الإسلامية، بقدر ما تظهر في الممارسة الصوفية”.
إن العقل المؤيد في فكر عبد الرحمن يشكل خطوة بعيدة في تكميل الحقيقة العقلية عند الإنسان، حيث إنه يقطع به مرحلة يحصل فيها القدرة على اتقاء الآفات الخلقية. ولا يبتعد المؤلف هنا عن تجربته الروحية الخاصة، عندما يؤكد أن الصوفي باتخاذه التجربة الحية سبيلاً في إقامة الأعمال، يكون قد اختار أكمل طريق في التعقل. ولا يكون هذا التعقل كاملاً إلا إذا استوفى شروطا ثلاثة، أوفتها التجربة الصوفية حقها، باعتبارها شروط كمال العقل.. ويجب في هذا الصدد، ألا ينفك العلم عن العمل في الممارسة العقلية، وألا تنفك معرفة موضوع أي علم عن معرفة الله في الممارسة العقلية، كما يجب أن يكون في الممارسة العقلية متسع للاستزادة الدائمة.
إن “التجربة الباطنية” عند الصوفي، كما يرى المؤلف، لا يُستفاد منها قط الانفعال المتصرف بالتشهي، وإنما التزود بمعايير عملية حية دالة على التبعية الأصلية، فصاحب العقل المجرّد يعمد إلى محو آثار العمل منها وإخراجها عن دلالتها المباشرة على التبعية الأصلية، باصطناع تبعية فرعية يسميها “الموضوعية” تحجبنا عن هذه التبعية الأصلية.
ويخلص العلاّمة المغربي إلى أن مسلك القرب في معرفة الألوهية يتوقف على تجربة التحقيق التي هي تجربة اشتغالية راسخة قائمة على المحبة التي تكسب القدرة على أداراك أعيان الأشياء عن طريق إدراك الذات. كما يوضح أن التقرب بالذكر في معرفة الأسماء الحسنى عبارة عن تجربة تخلق وهي تجربة إحسانية، جامعة بين فضائل الروح ومنافع الحس معا، وباعثة على تجديد وتخصيص طريق التخلق والتخليق التي توصل إلى تعرف الحق للمتقرب.
وينهي طه عبد الرحمن كتابه بالفصل الثالث الذي تعرض فيه للكمالات التخليقية، مبينًا مكانة النموذج في التربية الدينية، ووظيفة التعبير الإشاري في هذه التربية، والصفة الالزامية لمهمة التخليق وما يترتب عن التصدي لها من غير استحقاق.
ويؤكد فيلسوفنا أنه اذا كان هدف التخليق هو “التسلف العملي”، وكان هذا التسلف العملي هو تحصيل طريقة عملية في الرجوع إلى النصوص الإسلامية الأصلية، بقصد الظفر بمضامينها والاستمداد من معانيها حتى يقع الانتفاع بها في تلبية متطلبات الحياة وفي مواجهة مشاكل الواقع، فإنه لا يمكن لهذا التخليق أن يبلغ هدفه إلا إذا عمل على الوفاء بصنفين من الشروط. وأحد هذه الشروط علمي، يقضي بالتزام الحقائق العلمية التي ثبتت بصدد الاستفادة من النصوص، والشرط الآخر عملي يقضي بالأخذ من النماذج في العمل بمضامين النصوص.
موضحا أن التخليق الذي يضطلع به المقرب أصلا يُبني أساسًا على تمكين الغير من القدرة على فهم معاني النصوص الإسلامية الأصلية، وعلى الاستفادة من وجوه توظيفها لسد حاجات الحياة وحل مشاكل الواقع والمجتمع. وهذه هي القدرة التحصيلية المطلوبة في التسلف العملي،ويتخذ لذلك وسيلة عملية تستجيب للمقتضيات العلمية التي لا يستجيب لها نظيره النظري.
هذه الوسيلة عند عبد الرحمن هي “التنمذج”، أي التوسل في عملية الإصلاح بالنموذج. ويقتضي هذا الإصلاح النموذجي الأخذ بعمليتين هما عملية التطهير وعملية الترسيخ. ويؤكد فيلسوفنا أنه لا سبيل إلى التطهير والترسيخ إلا بالتوجه والمراقبة لنموذج حي يخاطبنا ونخاطبه، بصير بشئون المراقبة، ومتحقق بالفهم، ومتمرس بالتجديد، ومتمتع بالقبول بين الناس.
العمل الديني وتجديد العقل
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English