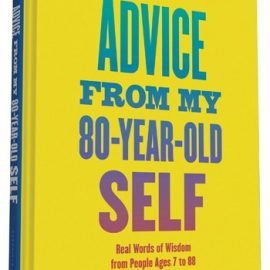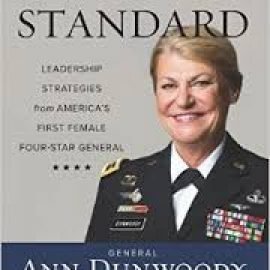الوصف
في كتابه “حوارات من أجل المستقبل”
طه عبد الرحمن: الحوار ينزل “منزلة الحقيقة”.. و”العولمة” ليست نهاية التاريخ
يقول الفيلسوف الفرنسي الشهير جان جاك روسو “تكلّم، حتى أعرفك”. وفي هذا الكتاب يتكلم الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن باستفاضة معرفا عن نفسه ومشروعه الفكري، ومتفرعا في مواضيع وقضايا مثارة في فضاءات الثقافة والفكر والفلسفة.. ومجيبا عن تساؤلات شتى تبحث عن أجوبة محددة وشافية.
الكتاب عبارة عن حوارات أجرتها مؤسسات إعلامية عربية مع عبد الرحمن، الذي أعاد ترتيبها وصياغتها، بما يسهل على القارئ فهمها، على أن هذه الحوارات لم تكن من نوع “الدردشات” التي يُملئ بها الفراغ في الصحف، كما يشدّد المؤلف، بل هي بمثابة بيانات كاشفة، وتأملات هادفة، لا يقل فيها هم الاجتهاد والتجديد، عما تنطوي عليه مؤلفاته الأخرى الكاملة.
من هذا المنطلق يحتل الحوار أهمية كبيرة في فكر الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، الذي عُني على مدار عشرات السنين بسبل تعزيز الحوار، بما يخدم الفضاء الفكري الكوني، ويصحح المفاهيم الخاطئة التي يؤمن بها بعض المفكرين.
ويرى عبد الرحمن في كتابه “حوارات من أجل المستقبل” أن الساحة الفكرية في بلاده مازالت تنأى بنفسها عن هذا الفضاء الحواري الجديد، وأن “أهل الفكر المغاربة لا يتحاورون”، داعيًا إياهم إلى “التعجيل بوضع خطة تربوية دقيقة وشاملة توفر تكوينًا متينًا في منهجيات الحوار وأخلاقياته”.
مؤكدا أننا لا نحتاج إلى شيء خلال منعطف التغيير الذي دخلت فيه المجتمعات العربية في مطلع القرن الجديد، قدر احتياجنا إلى “الروح العقلانية النافعة”، و”الروح الجماعية الصالحة”، اللتين تورثهما الممارسة الحوارية.
الحوار.. منزلة الحقيقة
ينطلق عبد الرحمن في كتابه “حوارات من أجل المستقبل”، من اعتبار أن “الحوار ينزل منزلة الحقيقة،” موضحًا أنه إذا كان الأصل في الكلام من جهة مضمونه هو الحقيقة، فكذلك الأصل فيه من جهة قائله هو الحوار”.
ويقول المؤلف “إن طريق الوصول إلى الحق ليس واحدًا، وإنما طرق شتى لا حدّ لها” معتبرا أن “الحق هو نفسه على خلاف الرأي السائد، ليس ثابتًا لا يتغير بل أصله أن يتغير ويتجدد، وما كان في أصله متجددًا، فلابد من أن يكون الطريق الموصل إليه متعددًا، ومتى وُجد التعدد في الطرق، فثمة حاجة إلى قيام حوار بين المتوسلين بها”.
إن تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة، من وجهة نظر المؤلف، يُفضي مع مرور الزمن إلى تقلص شقة الخلاف بينهم، فالحوار يسهم في توسيع العقل، وتعميق مداركه، لأن الحوار هو بمنزلة نظر من جانبين اثنين، وليس النظر من جانب واحد كالنظر من جانبين اثنين.
ومادام العقل يتقلّب بتقلب النظر في الأشياء، كما يرى، فعلى قدر تقلبه يكون توسعه وتعمقه، والعقل الذي لا يتقلب ليس بعقل حي على الاطلاق، وأن “العقل الذي يبلغ النهاية في التقلب هو العقل الحي الكامل، فلزم أن يكون تقلب العقل في حالة النظر من جانبين، ضعف تقلبه في حالة النظر من جانب واحد”.
يقسم عبد الرحمن كتابه إلى تسعة فصول، يتضمن كل فصل منها حوارًا دار حول موضوع ما أو قضية معينة، في مقدمتها “قضية التراث”، والتي شكلت محورًا مهمًا في مشروع المؤلف الفكري، ولذا خصص لها مؤلفات مستقلة.
وفي الفصل الأول الذي جاء على شكل أسئلة طُرحت عليه، يفسّر المؤلف أسباب تراجع الاشتغال بالتراث الاسلامي العربي، نافيًا أن “يكون دليلاً على أن اشكالية التراث قد وجدت حلّها النهائي أو أن وزنها قد ضعف في النفوس”، ومؤكدًا أن “التعامل مع التراث الأصلي كان وسيبقى مطلوبًا لنا كلما أردنا أن نجدد ثقتنا بقدراتنا، ونُؤصل مصادر استلهامنا”.
ويدحض الكاتب المنهجيات والنظريات المطروحة على الساحة الفكرية للتعامل مع التراث، موضحًا أن “أغلبها يصعب قبول مسلماته، بسبب وقوع هذه المنهجيات، والنظريات في أخطاء صريحة بصدد مضامين التراث، فقد استعجل أصحابها إصدار الأحكام على هذه المضامين، مع أن واجبهم الأول هو أن يطلبوا معرفتها على حقيقتها”. مضيفا إلى ذلك، “ضعف قدرة هؤلاء على امتلاك ناصية الأدوات المنهجية، العقلانية، والفكرانية، التي توسلوا بها في نقد التراث”، ويستعرض هنا وجهة نظره التي كان قد طرحها في كتابه “تجديد المنهج في تقويم التراث” وتعرّض فيه لنموذج المفكر الشهير محمد عابد الجابري في نقده التراث مبينًا أوجه القصور في هذا التناول.
وردًا على سؤال حول تعريفه الجامع لـ”التراث” يبدأ عبدالرحمن إجابته بالمقارنة بين مفهوم التراث، ومفهومين آخرين يدخلان في حقله وهما “الثقافة”، و”الحضارة”، مؤكدًا أن “التراث أعم من الثقافة ومن الحضارة”.
وبناء على هذه المقارنة، يضع تعريفه الجامع للتراث الاسلامي العربي وهو “أن التراث عبارة عن جملة المضامين، والوسائل الخطابية، والسلوكية، التي تحدد الوجود الانتاجي للمسلم العربي في أخذه بمجموعة مخصوصة من القيم القومية، والانسانية، حية كانت أم ميتة”.
آفات الفلسفة العربية
في الفصل الثاني الذي خصصه لقضية “الفلسفة”، يشخّص عبد الرحمن الواقع الفلسفي في العالم العربي، باعتبار أنه “واقع مترد لا يقل سوءًا عن تردي الوضع السياسي لهذا الوطن، لأنه واقع تقليد بالغ، وتبعية عمياء”. مشيرا إلى أن “الخطاب الفلسفي العربي، مصاب بالكثير من الآفات أهمها الآفة السلوكية، وهي الخلط بين الفلسفة والسياسة، والآفة الخطابية التي يقع فيها المقلدون من المتفلسفة العرب، وهي آفة الفصل بين الفلسفة والمنطق”.
أما سبب اقتران اسمه – كأكاديمي- بالمنطق، فيكشف عن عبد الرحمن في الفصل الثالث من الكتاب، موضحًا أن هناك سببين للربط بين اسمه والمنطق، أولهما تدريسه لمادة المنطق بالجامعة، وجهوده الكبيرة في العمل على تطويرها، أما السبب الثاني فهو تعاطيه البحث والتأليف في هذه المادة التي كانت موضوع أطروحته لنيل درجة الدكتوراه.
وفي الفصل الرابع يتحدث الفيلسوف عن ملامح مشروعه العلمي والبحثي، موضحا أن هذ المشروع يتحدد بواقع البحث في التراث الإسلامي العربي، خاصة في المناهج العلمية التي تميز هذا التراث؛ حيث سيطر على هذا البحث اتباع منهجيات لا يسلّم بصلاحيتها، فهي “منتجات منقولة لا موصولة”.
وهذه المنهجيات، في تقديره، لا تستوفي الشروط المنطقية للموضوع الذي تُنزل عليه؛ كونها مستعارة من مجالات معرفية مغايرة لهذا المجال الذي تُسلط عليه تسليطاً، من غير مراجعة لصفاتها الإجرائية، أو مراعاة للخصوصيات المنطقية في هذا المجال.
غير أن مشروع عبد الرحمن يسلم من هذه النقائض التي تندرج تحت عيبين اثنين، هما “النقل والدخل”، فهو يأخذ منهجه بطرق المنطق الرياضي الحديث، وطرق نظريات الحجج المعاصرة، وبما تتناسب في خصائصها مع خصائص الموضوع الذي تنصب عليه؛ منوها إلى أن “الموضوع التراثي مبني بناءً لغوياً منطقياً، ولا يمكن وصفه وصفاً كافياً ولا تعليله تعليلاً شافياً، إلا إذا كانت الوسيلة الواصفـة ذات طبيعة لغوية منطقية”.
ويعود الفيلسوف إلى واقع الفلسفة العربية مرة أخرى في الفصل الخامس، لدى حديثه عن الترجمة، مؤكدًا أن “الترجمة، وإن كانت تعني بالنسبة للفلسفة العربية مسألة حياة أو موت، إلا أن ذلك لا يعني أن الفلسفة تحيا بوجود الترجمة وتموت بفقدها، بل إن الفلسفة قد تموت مع وجود الترجمة”.
ويعتقد عبد الرحمن أن “هذا هو وضع الفلسفة العربية، فعلى الرغم من وجود الترجمة فهي أشبه بالميت منها بالحي، لأن حياة الفلسفة تُقاس بوجدان الإبداع فيها، فيما يُقاس موتها بفقدان هذا الإبداع منها”، والفلسفة العربية –كما يقول- “لا إبداع فيها، والسبب في موتها هو الطريقة التي تمارس بها هذه الترجمة”، حيث يصفها بأنها “طريقة بكماء لا تنطق، ولا إبداع بغير نطق، وهي كذلك طريقة عمياء لا تبصر، ولا إبداع بغير إبصار”.
ما الحل إذن؟
يجيب المؤلف بأنه لا سبيل إلى حياة الفلسفة إلا بترجمة ناطقة، ومبصرة، ولا يمكن أن تكون الترجمة ناطقة، حتى تتوسل بالبيان العربي في نقل ألفاظ الأصل، وتبليغ مضامينه، ولو اقتضى ذلك التصرف حسب الحاجة في هذه الألفاظ وتلك المضامين.
“التعولم” التاريخي
أما الفصل السادس، من كتاب “حوارات من أجل المستقبل”، فيوضح فيه عبد الرحمن رؤيته لفلسفة “ابن رشد”، والأسباب التي دفعته إلى رفض أفكاره، والتي لخصها في كون “ابن رشد” مقلدًا، في تقديره، بل إنه “فتح الباب لغيره في التقليد، فجاءت مؤلفات كثيرة مبنية على منهجيات غربية طرحت قراءات منقوصة ومغلوطة للتراث العربي الإسلامي”.
ولماذا حقق “ابن رشد” شهرة كبيرة؟.، يجيب عبد الرحمن بأن “شهرة ابن رشد جاءت نتيجة لاحتياج رجال الفكر الغربيين في القرون الوسطى، إلى من يقرب لهم فلسفة أرسطوطاليس ويُعينهم على مواجهة سلطان اللاهوت الكنسي”.
ويوضح عبد الرحمن ذلك بأن أوروبا أقبلت في تلك الفترة على ترجمة كتب “أرسطو” النفسية والطبيعية وما بعد الطبيعة ولم تكن تعرف من كتبه إلا جزءًا ضئيلاً، فوجدت في “ابن رشد” خير من يوضّح ويفصّل لها المضامين الجديدة لهذه الترجمات، ولا سيما أنه بدا أقدر من غيره على العودة إلى الأصول الأرسطية.
ويرى أن دخول فلسفة أرسطو إلى أوروبا أدى لزعزعة السلطة اللاهوتية ذات التوجه “الأوغسطيني” في النفوس، وقد وجد أهل الفكر اللاتيني في “ابن رشد” خير من يستندون إليه ويحتمون به في تقرير وتمرير دعاويهم المناهضة لهذه السلطة.
كما ترجع شهرة “ابن رشد”، من وجهة نظر عبد الرحمن، إلى انقسام المفكرين اللاتين بشأن فلسفته وإصدار الكنيسة لفتاوى تحرم الاشتغال بها، فقد انقسم هؤلاء المفكرين إلى فئتين متصارعتين، هما فئتي “الموالين”، و”المعادين”.
ويخصص عبد الرحمن لتجربته الصوفية والروحية الفصل السابع من الكتاب، لافتا إلى أنها “على خلاف ما انغرس في العقول، لا تتعارض أبدًا مع المعرفة العقلية، بل إنها قد تكون سببًا من أسباب إثراء هذه المعرفة والتغلغل فيها”، وأنه “أقبل على هذه التجربة اختيارًا بينما أقبل عليها الإمام الغزالي اضطرارًا”.
ويكشف الكاتب عن أسباب إقباله على التصوف، ويلخصها في سببين: الأول، رغبته في تقوية صلته بالله حبًا فيه لذاته، لا فرارًا من غيره، مؤكدًا أنها كانت “متعة أكبر من أن ينشغل بسواها”. أما السبب الثاني، فهو “التحقق من طبيعة المعاني، التي هي فوق طور العقل الفلسفي، هل هي غير عقلية كليًا، أم أنها عقلية بوجه عام”.
وفي الفصل الثامن من الكتاب، يطرح رؤيته للأصوليات الإسلامية التي ظهرت بقوة خلال العقود الأخيرة، وكيف أنها “جاءت بنتائج هي أقرب إلى السياسة الخالصة التي تنفع الجماعة المحدودة، منها الى العمل الإسلامي الروحي والعقلي الذي ينفع الناس جميعًا”.
وينتقد عبد الرحمن الخطاب الذي استخدمته فئة الأصوليين، إلى جانب فئتي الحكام والمفكرين، أمام الغرب، بهدف تقديم صورة صحيحة عن الإسلام، فجاءت النتائج عكسية، لأن الوسائل التي تم استخدامها في هذا الصدد كانت غير قادرة على الإقناع.
وعلى ذلك، فإن المسلم من وجهة نظر المؤلف مُطالب في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى بأن يكون متمكنًا من الوسائل العلمية والعملية التي بإمكانها أن تبيّن للغير حقيقة الإسلام، وتقنعه بضرورة هذا الدين بوصفه عنصرًا أساسيًا في الحضارة العالمية، لأنه تاريخ وتراث ما يزيد عن مليار شخص حول العالم.
وهذه الوسائل يجب أن تكون مختلفة عن تلك التي تم استخدامها من جانب الفئات الثلاث المشار إليها، أي الأصوليين والحكام والمفكرين، حيث يرى الفيلسوف أننا “يجب أن نقدم للآخر من القيم ما ليس عنده، حتى يشعر بالحاجة إلى الإسلام، وأن نقدم له من وجوه الدفع بالتي هي أحسن الموجودة في الاسلام، ما ليس عنده، أو لا يمكن أن تكون عنده، حتى يشعر بالاطمئنان إليه”.
وينهي الفيلسوف كتابه بالحديث عن “العولمة”، موضحًا أن أهم ما يميز “التعولم التاريخي” الذي نعاصره هو ازدواج العامل الاقتصادي، فيه بالعامل الاعلامي، متتبعًا العامليّن السياسي والثقافي.
ويدعو عبد الرحمن إلى النظر هذا “التعولم” كغيره من “التعولمات” السابقة، رافضًا التهويل بالقدر الذي يجعلنا نتخيل أن فيه نهاية للإنسان أو نهاية للتاريخ، ومشيرًا إلى أنه “إذا كان البعض يتخيل هذا حد الهوس به، فإن ذلك يرجع إلى بعض الفلاسفة الذين غرسوا في أذهان هؤلاء هذه المفاهيم، ذات الأصل المسيحي”.
ويسلّم المؤلف بأن “الفكر سيكون له شأن كبير لا يقل عن شأن الاقتصاد في التعولم الجديد، لكن ذلك ليس مرده أن هذه العولمة ستجعل له مكانة عملاقة، كما تجعلها للاقتصاد، وإنما لأن الانسان قادر على أن ينتزع هذه المكانة منها، بفضل قدرته على إبداع قيمًا أقوى من تلك القيم التي تفرزها، وأنه لن يضعف، مثلما تضعف هي”.
ويدعو الفيلسوف المغربي المفكرين العرب إلى أن “لا يتشاءموا وألا يستسلموا بحجة أن العملاق الاقتصادي الإعلامي الذي يسكن التعولم الجديد هو السيد المطلق، وأن القزم الاقتصادي الإعلامي الذي يمثله العرب لا يمكن أن يكون إلا عبدًا مطلقًا، بل إن عليهم أن يعوا حقيقة واجباتهم المستجدة في سياق هذا التعولم الجديد”.
ولا يقف الكاتب عند هذا الحد ، بل يذهب لأبعد من ذلك عندما يؤكد أن “دور المفكر العربي في قيادة الأمة في هذا الوضع العالمي المستجد سيكون أهم بكثير وأقوى بدرجات من دور الممارس السياسي”، لأن العمل السياسي – من وجهة نظره- سيكون “محكومًا بمقررات العملاق الاقتصادي، حتى أن الحكام العرب لن يبقى لهم إلا تنفيذ التعليمات، والأوامر، التي تفرض عليهم فرضًا، فيكون المنقذ من هذه التبعية الشديدة هو المفكر وحده”.
هكذا ينهى طه عبد الرحمن كتابه “حوارات من أجل المستقبل”، والذي جاء ملخصًا لأفكاره العامة وملامح مشروعه الفكري وبسيطًا يسهل استيعابه من خلال “التحاجج” بطريقة منطقية، وجمل رصينة ومحكمة، تعتمد على الألفاظ السهلة، بعيدا عن الكلمات المعجمية المستغلقة على الفهم.
في كتابه “حوارات من أجل المستقبل”
طه عبد الرحمن: الحوار ينزل “منزلة الحقيقة”.. و”العولمة” ليست نهاية التاريخ
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English