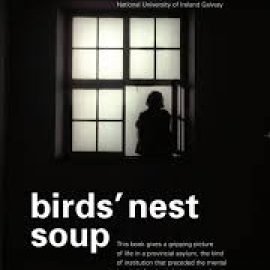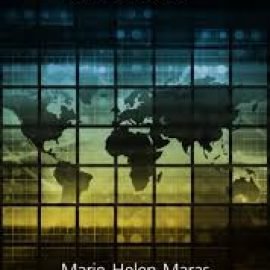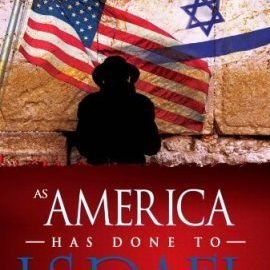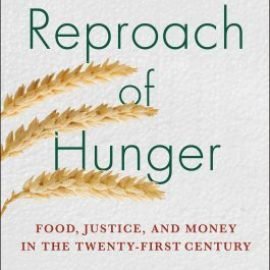الوصف
دين الحياء – من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني (1) أصول النظر الإيماني
يمثّل انفصال الفلسفة عن الثقافة العربية الإسلامية وتراثها إشكالية كبرى، ويخلق هوة واسعة بين المتفلسف العربي وبين بيئته، ذلك أنه ظل مستهلكًا للمناهج والنظريات الغربية الوافدة ومقلدًا لها، فكان هذا الانفصال أمر طبيعي.
ولم يتكلف هذا المتفلسف عناء البحث من أجل إبداع فلسفته الخاصة، بل استسلم لموجة “الحداثة” التي ضربت الفضاء الفكري العربي، قاطعًة الصلة بينه وبين التراث الأصيل المليء بقيم رفيعة، يمكن من خلالها بناء هذه “الفلسفة الخاصة”.
يتصدى الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن لهذه المشكلة، مبينًا تهافت تلك المناهج الغربية التي طالما كانت بمثابة “القدوة والمثل” لغيره، فيستنكر على هؤلاء ابتعادهم عن التراث في غير كتاب، شكلت جميعها بناءًا فكريًا متكاملًا، هدفه الأسمى بناء فلسفة إسلامية خالصة مستمدة من التراث، يتحقق فيها شرط الإبداع.
ويأتي كتاب “دين الحياء – من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني”، ليشكل أحدث لبنات هذا المشروع، ويقدم المؤلف عبر ثلاثة أجزاء من كتاب واحد رؤية جديدة للفقه الإسلامي، تُبرز القيم الأصيلة التي تتشكل فيها حياة الإنسان، حيث تمده بالمقومات التي يستطيع من خلالها مواجهة التحديات المعاصرة.
وفي الجزء الأول، أو الكتاب الأول، الذي بين أيدينا، ويحمل عنوان “أصول النظر الائتماني”، يجتهد عبد الرحمن، في إبراز الجانب الفكري من النظر الإسلامي، المُكمِل لجانبه العلمي الذي ينهض به الفقه.
كما يجتهد المؤلف، في هذا الجزء من الكتاب، من أجل استخراج المفاهيم والأصول التي يقوم عليها النظر الإسلامي، بما يمكنه من رفع التحديات، التي تواجه الإنسان المعاصر. وهو نظر يجب أن يستوفي شرطين، أحدهما أن يكون أخلاقيًا، لأن الأخلاق هي الجانب الذي تتجلى فيه معقولية الأحكام الشرعية. أما الشرط الثاني فهو أن يكون نظرًا أسمائيًا، بمعنى أن يكون نظر في أسماء الله الحسنى، لأن القيم الأخلاقية مستمدة من هذه الأسماء.
“الأمانة” وأصل الإسلام
يقسم عبد الرحمن كتابه هذا إلى بابين، ضم كل باب أربعة فصول، ويخصص الفصل الأول، من الباب الأول، لبيان صلة الإدراك المُلكي بالإدراك الملكوتي، مؤكدا أن هذه الصلة تتمثل في أن الأول يتقدم على الثاني تقدمًا كيانيًا ومنطقيًا، وأن هذا التقدم يجعل الإدراك المُلكي تابعا للإدراك الملكوتي.
وهذه التبعية تجلت في أشكال ثلاثة، أحدهما تبعية المشروط للشرط، والثاني تبعية الوسيلة للمقصد، والثالث تبعية الفرع للأصل. وهذا الأخير يتأسس على مبادئ ثلاثة تتحدد بها خصوصية النظر الائتماني.
المبدأ الأول، هو “مبدأ الشهادة” المأخوذ من الميثاق الملكوتي، الذي شهد الإنسان بموجبه بربوبية خالقه سبحانه وتعالى، والثاني هو “مبدأ الأمانة”، المأخوذ من الميثاق الملكوتي الثاني الذي حمل الإنسان بموجبه الأمانة. أما المبدأ الثالث فهو “مبدأ التزكية” الذي يذّكر الإنسان بهذا الوجود الملكوتي السابق، ويمكنه من الارتقاء إليه بروحه مستبدلًا العيان مكان البيان، ومستبدلًا حق ربه مكان حظ نفسه.
ويقدم الكاتب في هذا الفصل تعريفا لـ”الأمانة”، فينظر إليها باعتبارها “عبادة الله التي ينهض بها الإنسان في كل أعماله بمحض إرادته، ولا ينسب منها شيئًا إلى ذاته”. ومن خلال هذا التعريف يؤكد أنه إن الإنسان قد تفرّد بحمل “الأمانة” دون سواه من المخلوقات، فهذا يعني أنه تعهّد لله بأن يعبده بكلية أفعاله، اختيارًا خارجًا عن نسبة عبادته إلى نفسه.
وفي الفصل الثاني، يعالج عبد الرحمن مسألة الأسماء الحسنى، فيُبرز خصائصها الأساسية الثلاث، وهي أنها لا متناهية، وأنها تكوّن وحدة مطلقة لأن الكمالات الإلهية التي تتضمنها تترابط وتتكامل فيما بينها. أما الخاصية الثالثة فهي أنها منشأ القيم الأخلاقية، ويتوسل الإنسان في إدراكها بالاستبصار، ويحقق تخلقه بالرجوع إلى أحكام الشرع، باعتبارها تتضمن هذه القيم الأخلاقية، كما يتوسل الإنسان في تحصيلها من هذه الأحكام بالاستدلال.
ويؤكد عبد الرحمن أنه “لمّا كانت أحكام الإسلام بهذا الوصف، فقد رُد مفهوم الإسلام إلى أصله، وهو إسلام الوجه لله سبحانه، وهذا ينقل المسلم من رتبة الائتمار إلى رتبة الائتمان، كما يؤكد فيلسوفنا أن الكمالات الإلهية التي تدل عليها الأسماء الحسنى عبارة عن تجليات السمو المطلق الذي تختص به هذه الأسماء، أي تجليات لقيم الجلال والجمال التي تنطوي عليها”.
ويخلص المؤلف في هذا الفصل إلى “ضرورة أن تكون علاقة الإنسان الخلقية بالأسماء الحسنى، علاقة ائتمان لا علاقة احتياز، مادامت هذه الأسماء هي في حقيقتها تجليات سمو مطلق”.
الفقه الائتماني
الفروق بين تصورات الفقه الائتماري وتصورات الفقه الائتماني للآمرية الإلهية، كانت موضوع الفصل الثالث من الكتاب، وفيه يشير المؤلف إلى أن تصورات الفقه الإئتماري هي تصورات جلالية، تقوم على مبدأ القهر الإلهي لإرادة الإنسان، في حين أن تصورات الفقه الائتماني هي تصورات جمالية قائمة على مبدأ الرحمة.
وفي تصورات الفقه الائتماني، تأتي الأوامر الإلهية في سياقين اثنين، هما سياق الاقتران بالرحمة الإلهية، وسياق الاقتران بالأسماء الحسنى، فكل حكم شرعي عبارة عن حكم موصول باسم أو أكثر من الأسماء الحسنى، وحامل لقيمة أو أكثر من القيم التي تنطوي في هذا الاسم، أو هذه الأسماء الإلهية.
ويؤكد عبد الرحمن في هذا الفصل أن الفقه الائتماري الذي اختصر الإسلام في الآمرية الإلهية لابد أن يورث للمسلم تصورًا جلاليا للإلوهية، فباتت أخص صفاتها هي ما يسميه “الإلقاء من بعيد” الذي لا يحتاج إلاّ إلى السمع، و”الإيجاب من بعيد” الذي لا يحتاج إلاّ للامتثال. وهكذا فإن المسلم الذي أشرب عقله أو قلبه فقهًا ائتماريًا لا يمكن أن يتصور الإلوهية إلا محتجبة عنه احتجابًا مطلقًا، فهي قاهرة لإرادته قهرًا كليًا.
وعلى ضوء ذلك، يؤكد عبد الرحمن أننا أصبحنا في أمسّ الحاجة إلى مراجعة هذا المنظور الإلقائي، وهذا الميزان الايجابي، اللذين صارا يحددان العلاقات بين المسلمين.
إن الفقه الائتماني – من وجهة الكاتب- وإن اشترك مع الفقه الائتماري في طلب معرفة الآمرية الإلهية، إلاّ أنه لا يقع في هاتين الآفتين اللتين وقع فيهما هذا الأخير، وهما آفة “الإلقاء البعيد”، وآفة “الإيجاب البعيد”.
“حدود الله”
ينتقل الفيلسوف بعد ذلك إلى الفصل الرابع الذي يتناول فيه مفهوم “حدود الله”، مبرزًا المدلول الأصلي الواسع لهذا المفهوم، والحاجة إلى رد الاستعمال الفقهي الضيق إلى هذا الأصل الموسع، حتى يستعيد صلته بالراحمية الإلهية، وبالشاهدية الإلهية، كما يبيّن وظائف هذه الحدود الإلهية من حيث كونها تدفع ما يسميه “الحالة الاختيانية” عن الإنسان، وتحفظ له الحالة الائتمانية واصلة له بالعالم الملكوتي، كما أنها تحرر عقله وتوسّع اعتباراته ودائرة اختياراته، وكذلك تحرر إرادته.
إن “حدود الله” – طبقا لعبد الرحمن- تُخرج الإنسان من الحالة الاختيانية الناتجة عن نقض ميثاق تحمّل الأمانة، إلى الحالة الائتمانية في جانبها الخاص بالائتمان على رعاية مربوبية، على مقتضى القيم الأخلاقية، فهي تسترجع إرادته بفضل هذه الحدود وقدرتها على تمام الاختيار.
إن مدى الاختيار هنا يتسع بما لم يكن يتسع له، بدءًا بائتمانه، فيما تأخذ إرادته في التحرر من ثوران الشهوات وتداعيها، حتى كأن رغبته في أي شيء رغبة إلى المنعم بها عليه، بدءًا بالرغبة في تحمل الأمانة.
ويوضح مؤلف الكتاب أن الإنسان تقلب في حالتين، هما “الحالة الاختيانية” التي خان فيها الميثاقين “ميثاق حفظ الشهادة بربوبية الخالق”، و”ميثاق الائتمان على رعاية مربوبية المخلوق”.
أما الحالة الثانية فهي “الحالة الائتمانية” التي ردته إليها راحمية الخالق سبحانه وتعالى، بفضل الحدود الرحموتية التي حدها له إذا استعاد عقله طاقة الإبصار الحديد، واصلاً الملك المتناهي بالملكوت اللامتناهي، كما تستعيد إرادته طاقة الاختيار السديد، متخلقة من آفتي “تسلّط الاحتياز، وتلوّن الاشتهاء”.
ويصل المؤلف إلى الباب الثاني، فيتناول في الفصل الأول منه والخامس في الكتاب، “شاهدية الإنسان”، مؤكدًا أنها من شاهدية الإله التي توجب عليه حفظ المراقبة، ومبينًا أن راحمية الإنسان من راحمية الإله التي توجب عليه حفظ الأمانة.
وعلى ذلك، يؤكد فيلسوفنا على ضرورة أن تكون الشاهدية الإلهي هي الأصل في الأخلاق، لأنها تتضمن الآمرية، وتقترن بالراحمية وبائتمان الإنسان على القيم، كما تقوم أعماله وتتوسط فيها.
أما في الفصل السادس، فيستعرض العلاّمة المغربي حقائق الشاهدية، والتي أولها أن الشاهدية إلهية كانت أو إنسانية عبارة عن ازدواج السامعية بالباصرية، وهذا يفيد في أن سامعية الإنسان التي تقوم على الأخذ بالآمرية لم تعد تكفيه في الإقبال على العمل، ذلك لأن سمع الواحد من الخَلَف بعكس سماعه من السلف.
والحقيقة الثانية هي أن إدراك الإنسان العامل لمراقبة الشاهد الأعلى له يكون على ضربين، أحدهما أن يكون هذا الإدراك علمًا نظريًا، والثاني أن يكون تجربة حية. أما الحقيقة الثالثة فهي أن الشاهدية الإنسانية ولو أنها تتكون من شقين “السامعية والباصرية”، فإنها توجب تقديم الباصرية على السمعية، أي تقديم الإبصار على السمع.
ويفسر الكاتب ذلك بأن الشاهد الإنساني يقدم التعامل مع الذات الإلهية مستبصرًا لها على التعامل مع صفاتها، وذلك بموجب حقيقة أسمائها الحسنى، لأن هذه الأسماء عكس ما يعتقد الناس ليست صفات مجرّدة، بل هي أسماء الذات الإلهية حاملًة لصفات مخصوصة. والحقيقة الرابعة، هي أن الشاهدية الإنسانية تتوسل بالشاهدية الإلهية، مع العلم أن الإسلام دين شاهدي صريح، وليس مجرد دين آمري، كما أن الفقه، الذي يميزه فقه ائتماني موسع، وليس مجرد فقه ائتماري ضيق.
حالة “الخيانة”
في الفصل السابع، ينتقد عبد الرحمن الحضارة الغربية، مؤكدًا أنها دخلت “حالة الخيانة” عندما تقررت فيها عقائد دينية تقول بامتزاج الذات الإلهية بالذات الإنسانية، وأن هذه الحالة الاختيانية ترسّخت منذ أعلن مفكروها عن “موت الإلهط، وكان خروجهم من الدين سببًا في خروجهم من الأخلاق.
إن الحياء، وهو خُلق مميز للإسلام، يمثل إشكالًا أخلاقيًا راهنًا، يُرجع عبد الرحمن أسبابه إلى أن الحضارة المعاصرة بُنيت على دعوى “موت الإله”، بينما الحقيقة التي تكشفّت هي أن الموت الذي أصاب هذه الحضارة هو “موت الإنسان”.
وهنا يوضح فيلسوفنا أن هذا الموت ليس المقصود به الموت الذي ينسبه أهل هذه الحضارة نفسها إلى كون الإنسان أضحى منظورًا إليه من كل جانب، ومحاطا بكل سر من أسراره حتى لا باطن له، وإنما المقصود هو الموت الذي حفظ للإنسان باطنه، لكنه أعماه فلم يعد هذا الباطن يبصر الميثاقين الملكوتيين اللذين أخذهما الحق سبحانه وتعالى من الإنسان، وهما “ميثاق الشهادة بروبية الخالق”، و”ميثاق الائتمان بمربوبية المخلوق”.
ويصل عبد الرحمن إلى الفصل الثامن، وهو المحطة الأخيرة في هذا الكتاب، مستخلصًا نتيجة مهمة وهي أن النظريات التحليلية والفلسفية للحياء لا تجدي نفعًا في إعادة الحياة إلى الإنسان المعاصر، الذي فقد الحياء. ويطرح تساؤله المهم عن مدى استطاعة العلم الإسلامي متمثلاً في “الفقه”، والعمل الإسلامي متمثلاً في “التزكية”، تحقيق ما عجزت عنه هذه النظريات الحديثة.
ويؤكد أن دعوة الفقيه الائتماني تتفوق حيث تتعثر دعوة نظيره الائتماري، فلا يقذف هذا الإنسان الميت بوابل من الأوامر لأول وهلة لعلمه بشديد نفوره منها، وإنما يُنشئ فضاءً تواصليًا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي حدثت في مختلف المجالات، وخصوصًا مجال الاتصال والإعلام والتحديات الأخلاقية المترتبة عليها، والتي أضحت تواجه الإنسانية بأسرها في عصرنا الراهن.
دين الحياء – من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني (1) أصول النظر الإيماني
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية

 العربية
العربية  English
English