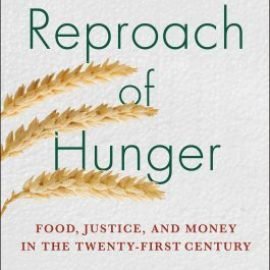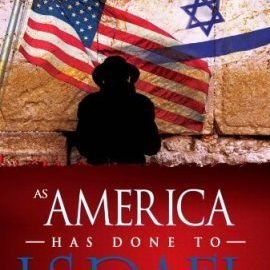الوصف
في كتابه “في أصول الحوار وتجديد علم الكلام”
طه عبد الرحمن يضبط سلوك “المتكلمين”.. ويؤسس لـ”الاختيار الإسلامي”
بغض النظر عن مسلك عامة المسلمين، يضرب الإسلام منذ فجر الدعوة، مثالا حضاريا ناصعا في أصول “الحوار”، باعتباره ركنا أساسيًا من أركان الدين، الذي دعا إلى محاورة المخالفين، بالحجة والمنطق والدليل، فكان للحوار في الإسلام ضوابط وأحكام وآداب. وتتبدى في الصيغة الإسلامية العربية، بشكل جليّ، وظائف التخاطب الإنساني الثلاث، وهي “التبليغ”، و”التدليل”، و”التوجيه”، وتلك هي الصيغة التي عرفت باسم “المناظرة”.
وفيما تتعالى أصوات من داخل الأمة وخارجها تدعو إلى قطع الصلة بالتراث الإسلامي، يقف الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، في مواجهة مثل هذه الدعوات، محاورًا لأصحابها بالحجة والمنطق والبرهان، مبيّنًا كيف أن في التراث الإسلامي العربي من الكنوز ما يدعو إلى الالتفاف حوله، والنهل من قيمه السامية، بما يحقق فائدة عظمى للفضاء الفكري المعاصر برمّته، بعيدًا عن تراث منقول يحمل قيمًا مغايرة.
وفي هذا الكتاب “في أصول الحوار وتجديد علم الكلام” اعتبر عبد الرحمن أن الدعوة إلى قطع الصلة بالتراث اعتقادًا بأن ذلك يكفل للعرب “الالتحاق بالحداثة”، أو الدعوة إلى إبقاء الصلة بالقسم الفلسفي فحسب من هذا التراث، اعتقادا أن هذا القسم هو وحده الذي يستوفي مقتضيات “الاتصال بالحداثة، هما دعوتان تفضيان إلى نتيجة واحدة، وهي إخراج المتلقي العربي من التعلق بالتراث الذي صنعته أمته، إلى التعلق بتراث من صنع أمة سواها.
لم يكتف الفيلسوف المغربي بمواجهة هذه الدعوات من خلال كتاب واحد أو محاضرة، وإنما قرر مواجهة تلك الموجة الفكرية بعشرات الكتب التي تشكل جميعها لبنات مشروعه الفكري الكبير، الذي يهدف من خلاله إلى إثبات بطلان حجج وأسانيد أصحاب تلك الدعوات، وصولاً إلى بنية فكرية تستمد أصولها من تراث أمتنا الإسلامية العربية.
وفي هذا الكتاب حلل عبد الرحمن “الممارسة الحوارية” التي اختص بها التراث الإسلامي العربي، والتي عُرفت باسم “المناظرة”، ليثبت أن الدعوات التي تنادي بانفصالنا عن هذا التراث ما هي إلا من “باب التكليف بما لا يُطاق” – على حد تعبيره- كما أنها تجعل حصر هذه الممارسة في قسم واحد من أقسام التراث من “باب ادعاء ما لا يصح”.
وأوضح المؤلف أنه لا يمكن الانفصال عن “الممارسة الحوارية” الخاصة بتراثنا الإسلامي العربي، لأن للحوار فضائل خاصة أصبحت اليوم عنوانًا على وعيّ الأمة وتقدمها، فهو لا يوجد إلا حيث يوجد الاختلاف في طرق البحث، وتواصل الحوار بين الأطراف المختلفة يفضي مع مرور الزمن إلى تقلص شقة الخلاف بينهم، كما أنه يسهم في توسيع آفاق العقل وتعميق مداركه.
ويرفض الفيلسوف حصر ممارسة “المناظرة”، في قسم واحد من أقسام التراث الإسلامي العربي، لمجموعة من الاعتبارات، أهمها: أن “المناظرة” الإسلامية وإن كانت قد استعانت في تفصيل قواعدها ببعض مقررات الجدل اليوناني، فيبقى أن الأصل فيها، هو الجدل القرآني.
كما أن “المناظرة”، حسب المؤلف، لم تكن قط في يد المسلمين العرب أداة للاشتغال بالمنازعة المقصودة لذاتها، وإنما كانت وسيلة من وسائل تنمية المعرفة الصحيحة، وممارسة العقل السليم. وتتبع “المناظرة” طرقًا في الدلالة والاستدلال تعد أقل قيودًا وأعم حدودًا من غيرها من الطرق التي يُتوصل بها إلى المعارف المطلوبة، بحيث يكون نطاق عملها أوسع من نطاق عمل غيرها.
أصول “المناظرة” الإسلامية
يتجه طه عبد الرحمن إلى وضع نموذج للسلوك التخاطبي للإنسان، جاعلاً لهذا السلوك مراتب ثلاث هي: “الحوار” و”المحاورة” و”التحاور”، وهي مراتب تتناسب مع تصنيفات ثلاث للنظريات المتداولة في مجال التحليل الخطابي والتي أسماها على التوالي: “النظرية العرضية” و”النظرية الاعتراضية” و”النظرية التعارضية”.
وينطلق الكاتب في تحليله هذا من رفضه التحامل على “المناظرة” الإسلامية الذي يقع فيه القائل بالترك الكلي للتراث أو إسقاطها من الاعتبار، فضلا عن رفضه للقول بـ”الأخذ بقسم محدود من التراث فحسب”، مؤكدًا أن الموقفين لا يعبران عن تحقيق علمي.
ويلفت الفيلسوف النظر في مقدمة كتابه إلى أن رفضه للموقفين السابقين من التراث، والدعوة إلى عكسهما تماما، أي إلى التعامل مع التراث كحقيقة تاريخية، لا يمكن الانفصال عنها ولا تقسيمها، جعل البعض يصفه بأنه “يدعو إلى القديم”، بينما يتم وصف أصحاب هذين الموقفين بأنهم من “دعاة التجديد”.
وهنا يشدّد المؤلف على أنه في دعوته هذه توسل بوسائل تضاهي في قوتها المنهجية وسائل هؤلاء، إن لم تتعدها جدة ودقة، لأنه استند فيها ليس فقط على مستنبطات النظر التقليدي، العتيق، وإنما مستجدات البحث المنهجي، الصريح.
وفي سبيل إثبات طرحه قام عبد الرحمن بدراسة مفصلة لأصول المنهج الكلامي في ممارسة الحوار، متعاطياً تقويم هذا المنهج من زاوية نظرية الحجة بالحجة والمنطق الحواري الحديث، كما يبسط القول في الاستدلال القياسي واستخرج بعض عناصره الأساسية نحو “الشاهد” و”المشابهة”.
وينوّه الفيلسوف إلى أن كتابه، “في أصول الحوار وتجديد علم الكلام”، جاء مستوفيًا شرطين: هما “المجانسة”، والتي يقصد بها، أن يكون المنهج، من جنس الموضوع، متى أراد المتوسل به، الظفر بالآليات الداخلية، التي يتحدد بها الموضوع.
والشرط الثاني هو “الحداثة” والتي يقصد بها أن يستوفي المنهج المستعمل شرائط التقدم الحديث، الحاصل في مجال المعرفة العلمية، من أجل ذلك يدعو فيلسوفنا إلى التفريق في هذا العمل بين منهجيتين اثنتين، هما “منهجية تحتية” وهي منهجية المناظرة باعتبارها الممارسة الحوارية التي اختص بها المسلمون ثم “منهجية فوقية” وهي المنهجية التي توسل بها في تحقيق هذا النظر والتحليل والتقويم.
قسم عبد الرحمن كتابه إلى أربعة فصول، خصص الأول منها للحوارية التي جعلها مراتب ثلاث، هي الحوار والمحاورة والتحاور، بحيث تتناسب مع التصنيف الثلاثي للنظريات الحوارية المتداولة في مجال البحث الخطابي هي: النظرية العرضية والنظرية الاعتراضية والنظرية التعارضية.
وخصص المؤلف لكل واحدة من هذه النظريات آلية خطابية معينة، قام بتحديد نموذجها النظري، ومنهجها الاستدلالي، وشاهدها النصي، مع تقويم الجوانب الإيجابية والسلبية فيها، مؤكدًا أن “كل تلك الأدوات تتفاوت في قدرتها على أداء الحوارية، وتأصيلها”.
وفي هذا الفصل، أيضًا، يوضح عبد الرحمن أن “الحوار ينتهي إلى إخلاء آثار المعروض عليه من النص، يتلوه انسلاخ العارض نفسه منه توفية لحق شروط البرهان. أما المحاورة، وإن قامت بما قصر عنه الحوار من إشراك الغير المعترض في إنشاء النص وفي توسيع آفاقه الاستدلالية، بإحلال الحجّاج محل البرهان، إلا أنها تبلغ بهذا الاشتراك درجة التفاعل بين المحاور ونظيره”.
وهذا التفاعل، وفق الكاتب، “لا يتحقق إلا بأن تتساوى عند المتحاور حقوق نفسه مع حقوق غيره في تكوين النص، فيجنح إلى فتح باب الاستدلال على مصراعيه محاجًا لنفسه، كما يحاجه غيره، وهذا هو ما اختص به التحاور الذي كشف عن أسرار الحوارية وارتقى بها إلى أعلى المراتب”.
“الفلسفة التداولية”
يعالج الفيلسوف في الفصل الثاني من كتابه “المنهج الكلامي” في ممارسة المتكلمين للحوار، فيثبت قضيتين، أولاهما أن الخطاب الكلامي، والخطاب الفلسفي التداولي، لا يختلفان من حيث شروطهما الاستدلالية الحجاجية، وثانيهما أن علم الكلام يتصف بخصائص تداولية لا تشاركه فيها الفلسفة البرهانية، كما يدرس هذا الفصل “المناظرة” أصولاً، وقواعد أخلاقية، ومنطقية، وتناول تقويمهما، من زاوية منطق الحوار الحديث.
ويتبين لنا من تحليل الكاتب أن الفلسفة ذات المنزع البرهاني لا تفلح في التخلص من سلطان الخطاب الطبيعي، ولا تستفيد من ثرائه، لذا وجب طلب فلسفة توظف جميع وسائل هذا الخطاب التبليغية، وتحقق الإمكانات الفكرية الكامنة فيه وفق مقتضيات المجال التداولي، وهو ما أسماه “الفلسفة التداولية” التي نجد بعض عناصرها في ممارسة المناظرة، وتفيدنا في إثبات حقيقة تداولية كبرى، وهي أنه “لا كلام إلا بين اثنين”.
أما الفصل الثالث من كتابه فيعالج فيه عبد الرحمن “الاستدلال الكلامي” في صورة القياس من زاوية التحليل الخطابي، فيقوم بتحديد مسلماته، وعملياته، وقواعده الخطابية، واستخراج خصائص العنصرين الأساسيين فيه، وهما الشاهد والمشابهة، كما يحلل مفهوم المماثلة، مستخدما أدوات المنطق في عرض وتنسيق مختلف نظريات المماثلة عند المتكلمين.
ولكن ما الفائدة من وصف المؤلف للخطاب التداولي للقياس التمثيلي وتحليله المنطقي الصوري للمماثلة؟ يجيب عبد الرحمن بأن” ذلك حقق له عددا من النتائج، جاء في مقدمتها أن القياس يوفي خواص الخطابية حقها، فمن الخطاب الطبيعي يستمد مسلماته، وفيه يبني عملياته، وبه يربط قواعده، فيختص بصفات تداولية منطقية متفردة تجعل الآليات القياسية لا ينحصر عملها في قطاع فكري معين وإنما يشمل كل خطاب طبيعي، أياً كانت لغته، وأياً كان مجاله، وأياً كان مستواه”.
النتيجة التالية التي توصل إليها عبد الرحمن هي أن “معالجة المتكلمين للمماثلة في سياق طرحهم لمسألة علاقة الذات بالصفات ليست ضربًا من البحث العقيم كما يذهب البعض، وإنما هي تناول يتسم بميزات منطقية ودقائق معنوية تحتاج إلى قدرة عقلية ومنهجية، لا تتوافر إلا لمن ضبط مناهج التحليل، والترتيب، والتقنين، ضبطًا كافيًا”.
ويستخلص الكاتب من ذلك كله أن أقوى أسباب الإهمال الذي وقع فيه البحث الكلامي، والذي يصفه بـ”الطمس المتعمد” من لدن البعض هو عدم تحصيل المستوى المنطقي والمنهجي، الذي حصّله المتكلمون في امتلاك وضبط المناهج العقلية، والأخذ بالقويم من الأدلة المنطقية.
ضبط سلوك “المتكلمين”
وفي الفصل الرابع والأخير من الكتاب يعمد المؤلف إلى بحث الاشتغال العقلي عند المتكلمين، الذي أسماه “المعاقلة”، فيبدأ بالاعتراض على دعاوى مستحدثة في دراسة الفكر الإسلامي، خاصة دعوى بيانية العقل العربي ودعوى شرعانية العقل الإسلامي، لينتقل بعد ذلك إلى إثبات جملة من المبادئ العامة، الأخلاقية والمنطقية، التي تضبط السلوك الحواري للمتكلمين.
ويستشرف عبد الرحمن في نهاية كتابه آفاق الممارسة الكلامية، مؤكدًا أنه “إذا تبين أن العقلانية الكلامية مبنية على مبدأ الفعل والمفاعلة، فإن علم كلام جديدا يصبح السبيل النافع والجاد لتقويم النزعات الفكرية والاختيارات المنهجية المستجدة وللنظر في التغيرات العميقة التي أحدثها التقدم العلمي والتقني، في مكونات المجتمع المسلم”.
ويوضح أن هذا الكلام الجديد، بمواجهته للإشكالات المستحدثة التي يطرحها الخصم طرحًا يعتمد فيه أقوى وسائل الاعتراض والاستدلال، يصبح عاملاً حاسمًا في تحديث أدوات المقاربة والتنظير ورفع مستواها الإجرائي وقوتها الاقناعية لدى المفكر المسلم.
هذا الانفتاح الكلامي على الخصوم، كما يقول عبد الرحمن، هو مناسبة لتأسيس “الاختيار الإسلامي” تأسيسًا يكون في مستوى ما حدث من تحويل في البنيات الفكرية والمجتمعية للإنسان، أي أن يكون مبنيًا على المعايير والقيم الجديدة التي ابتدعها هذا التحويل الحضاري.
ويجتهد عبد الرحمن في كتابه هذا في الأخذ بأسباب اللغة العربية في التعبير والتبليغ، سعيا منه وراء الاستقلال عن المعايير الأجنبية في الوصف وإنتاج المعرفة، وهو يقاوم بتوظيف أدواته في التنظير لطرحه معتمدًا على المنطق، الذي تدفقت وسائله، وتشعبت أبوابه، وتعددت مستوياته، واتسع مجاله، لتستعين به العلوم المختلفة لاسيما العلوم الإنسانية.
كما يحرص المؤلف في كتابه على نقل مجمل مضمون فقراته المصاغة بلغة رمزية يصعب استيعابها، إلى ألفاظ اللغة العادية، داعيا القارئ إلى “الخروج عن مألوفة والاجتهاد قدر المستطاع، من أجل استيعاب الجديد، حتى يخرج من ركوده العلمي ويحقق الفائدة المبتغاة”.
في كتابه “في أصول الحوار وتجديد علم الكلام”
طه عبد الرحمن يضبط سلوك “المتكلمين”.. ويؤسس لـ”الاختيار الإسلامي”
لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية
 العربية
العربية  English
English